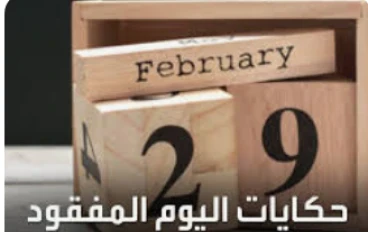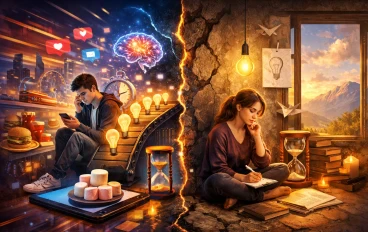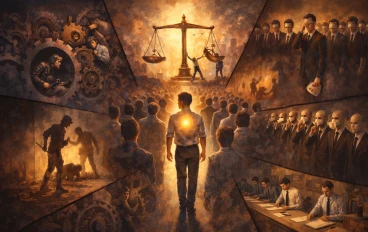العالم الخارجي والعالم الداخلي للكائن الحي: ما الذي يحصل للمواد الغذائية بعد امتصاصها من قبل الأمعاء ؟
العالم الخارجي والعالم الداخلي للكائن الحي: ما الذي يحصل للمواد الغذائية بعد امتصاصها من قبل الأمعاء ؟
مثلما أشار الباحث الفرنسي كلود بيرنار (1813-1878م) فإن هناك عالمان تعيش بهما المخلوقات الحية: العالم الذي يحيطها والذي هوعالم دائم التغير بفعل التغير المستمر للمناخ من رياح وأمطار أو جفاف أو تغير للضغط وما إلى ذلك أما العالم الثاني فهو ذلك المتواجد داخل خلاياها وتحمله معها ويشكل المادة الحية الأساسية للخلايا النباتية والحيوانية على السواء ويسمى بالجِبْلة أو (البروتوبلازما).
هذا العالم الداخلي يختلف كليا عن العالم الخارجي لأنه يتعين عليه أن يكون ثابت التكوين والخصائص إلى أبعد الحدود، طالما ظل الكائن على قيد الحياة.
ضرورة هذا الثبات تشمل جميع الكائنات الحية، من أبسطها، أي الحيوانات والنباتات الوحيدة الخلية إلى الإنسان.
إنما جميع هذه الكائنات الحية بحاجة مستمرة للعالم الخارجي، فهو المصدر الوحيد الذي يمدها بالغذاء مثلاً، فكيف تحافظ إذا على استمرار ثباتها، وهي على هذا الارتباط بماهو خارج عنها دائماً؟!
يمكن فهم هذا الأمر بسهولة كما أتصور عند ملاحظة سلوك أبسط الحيوانات كالأميبا مثلا. هذا الحيوان الذي لا يستطيع أن يعيش إلا في محيط سائل، كمعظم الحيوانات الوحيدة الخلية، يقتات من كل ما يصادفه داخل الماء مثل البكتيريا الصغيرة أو أشلاء نبات أو حيوان. فما أن يشعر بوجود مادة كهذه تكون قريبة منه، ويتأكد عن طريق إيعاز يأتي إليه من المادة ذاتها كإشارة كيميائية بأن هذه المادة صالحة كغذاء، حتى تعمل الأميبيا على تغيير هيئتها بالشكل الذي يمكنها من إحاطة هذه المادة بواسطة امتدادات من جسدها لها وظيفة الأطراف، حتى يتم احتواء المادة الغذائية احتواءً تاماً، إذ تبدأ آنذاك بتكوين فقاعة حول المادة الغذائية تفرز منها العصارات والحوامض الهضمية التي تعمل على إذابة هذه المادة وتفتيتها وإعادتها إلى مكوناتها الأساسية. أنذاك فقط تبدأ الأميبيا بامتصاص المادة الغذائية وإضافتها كجزءٍ من كيانها إلى المادة الحيوية الموجودة داخلها.
وهكذا نجد بأن حتى هذا الحيوان الشديد البساطة، لا يأخذ من المواد الموجودة في العالم الذي يحيطه، أي الماء، والذي هو بدوره محيط أسهل من سواه، إلا ما هو متلائم، بل متطابق مع ما هو موجود داخل كيانه، الأمر الذي يقتضي في الغالب عملية معقدة من الاصطفاء لهذه المواد وهضمها وتغييرها بالطريقة التي ترجعها إلى الأصول البسيطة التي هي الأساس المشترك لجميع الكائنات الحية، أي إلى الحوامض الأمينية، عناصر الزلال الأساسية مثلا.
كما تمتلك الأميبيا، وبالتحديد في الغشاء الذي يحيطها، حساسية لا ترشدها فقط لما هو صالح أو غير صالح من غذاء، وإنما لتحذيرها أيضا عند حدوث أي تغيير أو تهديد يحصل في المحيط الخارجي الذي نعيش فيه، بما يشبه الوظيفة المبدئية للألم لدى المخلوقات المتطورة والإنسان.
ولا تشكل المواد الزلالية المقومات الأساسية للخلايا وأهم محتوياتها فحسب، وإنما هي التي تعطي أيضا الخصائص الثابتة لها وتقرر مدى فعاليتها. فمنها تتركب كيميائياً جميع الخمائر الحيوية (الإنزيمات) ويتحدد عليها المصير الوراثي للخلية، بما في ذلك انتقال أو عدم انتقال ما يحصل من تغييرات بما يكون له علاقة شديدة بنشوء أو عدم نشوء الفوضى والنكوص إلى الأوضاع والخصائص البدائية للخلية، والذي ينتهي عادة باكتساب خصائص وراثية جديدة ليس لها أي علاقة بالتكييف مع الظروف الجديدة التي تحدث في المحيط الخارجي، وتكون آخر عوارضها هي الأورام السرطانية.
وكلمة زلال يمكن اعتبارها ترجمة جيدة بأقصى ما يكون لكلمة بروتينات فهي تعني في اللغة العربية : النقاء والعذوبة أي حسن المذاق بآنٍ واحدٍ، أو كما قال المتنبي:
ومن يكُ ذا فمٍ مُرٍّ مريضٍ *** يجد مُراَّ به الماء الزُّلالا
إن الكائن الحي لا يتقبل إلا ما يجده نقياً، أي متفقاً مع كيانه، تحت الظروف الاعتيادية.
وهذا أمر تحتمه طبيعة الزلال، وما يكون له من سمات حينما يدخل في تركيب كل خلية حية، فلا تستطيع في النهاية إلا أن تنتقي النقاء.
عملية الهضم التي عند الأميبيا لا تختلف رغم بساطتها من الناحية المبدئية عن عملية الهضم التي تقوم بها الكائنات المتعددة الخلايا والمتطورة، إذ إن الغرض هنا وهناك ما هو سوى تفتيت وإذابة المواد الغذائية وإعادتها بواسطة الخمائر الهاضمةإلى ا لأجزاء الأساسية البسيطة والتي تكونت منها لكي تستطيع امتصاصها.
فالمواد الزلالية تتحول في كلا الحالتين مثلا إلى الحوامض الأمينية، وتتحول المواد النشوية إلى المركبات التي بنيت منها، أي إلى السكر البسيط، وهكذا. ووجه الخلاف يقوم على أساس كمي، أي من البسيط إلى المعقد ما بين هضم المخلوقات الوحيدة الخلية والمتطورة لهدف واحد، وهو تحويل المواد الغذائية كيميائيا لكي تكون متشابهة، بل متطابقة مع المواد الداخلة في تركيب الخلية والتي لا تبقى بالمواد الغريبة عليها، وبالتالي لا يمكن رفضها من قبل الجسم.
أما دخول المواد، وفي الأخص المواد الزلالية عنوة ودون تغيير عبر جدار الأميبيا فهو يعني غالبا موتها الأكيد.
إن هذا هو ما نجده لدى الإنسان أيضا من الناحية المبدئية. فالمواد الزلالية التي يستطيع امتصاصها جيداً في الغالب بعد إفراز العصارات الهاضمة عليها، تصبح وبالاً لجسمه لا يختلف عن السموم، حينما يتم دخولها دخولاً مباشرا إلى الدم، عن طريق حقنة وريدية مثلا، وفي الأخص حينما تكون قد سبق دخولها إليه ولو بكميات قليلة من قبل، إذ يعمل الجسم على التخلص من هذه الأجسام الغريبة ويتفاعل بعنف شديد غالبا ما يكون أكثر مما يقتضيه الأمر، مما يؤدي إلى حدوث صدمة طالما ذهب ضحيتها.
ثبات العالم الداخلي للكائن الحي هو في حقيقته من نتائج الفعالية والنشاط الدائم لخلاياه ومن أهم معالم الحياة. ويمكن اعتبار كل خلية بمثابة المختبر أو المعمل الصغير وبدرجات متفاوتة من الفعالية.
فبعد امتصاص المواد الغذائية عن طريق الأمعاء ونقلها بواسطة الأوعية الدموية إلى الكبد ومختلف الأعضاء والأنسجة الأخرى، تبدأ داخل الخلايا عمليات كثيرة ومعقدة لتحويل هذه المواد من جديد إلى الشكل الذي يستطيع به الجسم الاستفادة منها، حيث يمكن باختصار تحديد هدفين أساسيين لكل ما يحصل داخل خلايا الجسم من تغيير للمواد الغذائية: الأول: هو الحصول على الطاقة اللازمة لعمل الجسم وتأديته لوظائفه، والهدف الثاني: هو التعويض بمواد جديدة عن كل ما تَلَفَ واستُهلك من خلايا الجسم وأنسجته بمواد جديدة يكتسبها الجسم عن طريق الغذاء، ويحولها إلى جزء من كيانه، بالإضافة إلى ما يأخذه الجسم من هذه المواد في حالة النمو.
وعلى هذا الأساس يمكن فهم طبيعة العمليات الكيميائية العديدة ا لتي تحصل في هذا المضمار للوصول إلى هذين الهدفين المختلفين وإرجاعها بدورها إلى مجموعتين أساسيتين من التفاعلات: تفاعلات يكون جوهرها هو الاحتراق بما يعني الهدم للمواد لغرض الحصول على الطاقة، وتفاعلات أخرى جوهرها هو التركيب للمواد لغرض البناء وهناك الكل تفاعل كيميائي يحصل داخل الجسم خميرة معينة تساعد على حصوله.
ما يفْضَل نتيجة كل هذه العمليات الكيميائية في الختام هو الماء وثاني أكسيد الكربون والمادة المسماة بالبولية (كاربمايد)، وجميع هذه المواد يعمل الجسم على التخلص منها في الدرجة الأولى عن طريق الرئة أو الكلية.
أما المادة الأساسية التي يصحل منها الجسم على الطاقة فهي النشويات الموجودة بالدرجة الأولى في الخبز والأرز والبطاطا، أما اللجوء إلى الدهون للحصول على الطاقة، فلا يحصل عادة إلا عند عدم توفر المواد النشوية، أو لدى أمراض معينة كمرض السكري مثلا، حينما يكون السكر موجودا بوفرة داخل الجسم، إنما لا يمكن حرقه والاستفادة منه.
أما المواد الغذائية التي يحتاجها الجسم للنمو والبناء، فهي المواد الزلالية المتوفرة في الحليب واللحوم والبيض مثلا.
والجسم يستطيع خزن السكر عن طريق تحويله إلى الغليكوجين، وهي مادة نشوية تخزن في الكبد بالدرجة الأولى، كما تخزن الدهون على شكل الشحوم في معظم الأنسجة عند زيادتها عن اللزوم، ولكنه لا يستطيع خزن المواد الزلالية حينما يزيد وجودها عن حاجته، إذ إنه يعمد في هذه الحالة إلى تحويلها بدورها أما إلى النشويات أو الدهون، حيث يمكن آنذاك خزنها أو حرقها كهذه أيضاً.