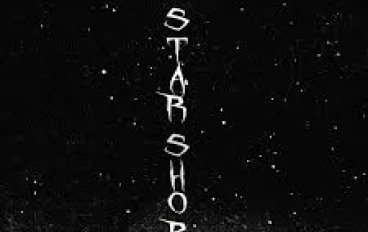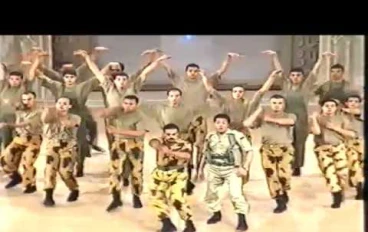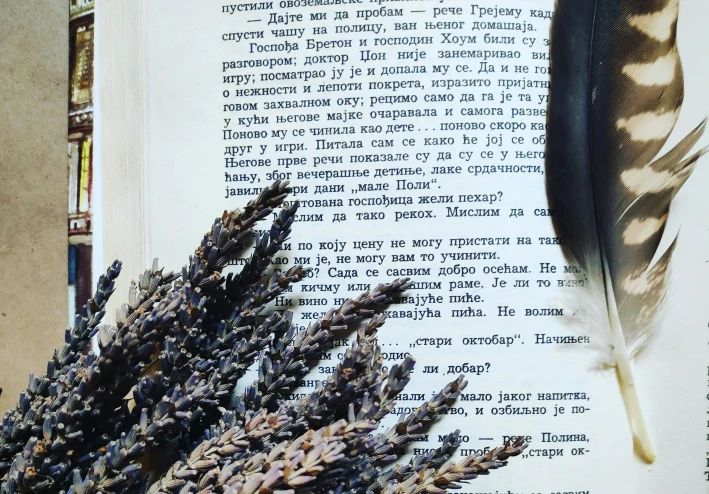
الشعر: الصورة العميقة للواقع ومنزلة "العلم" في منظومة الفن والأدب
الشعر: الصورة العميقة للواقع ومنزلة "العلم" في منظومة الفن والأدب
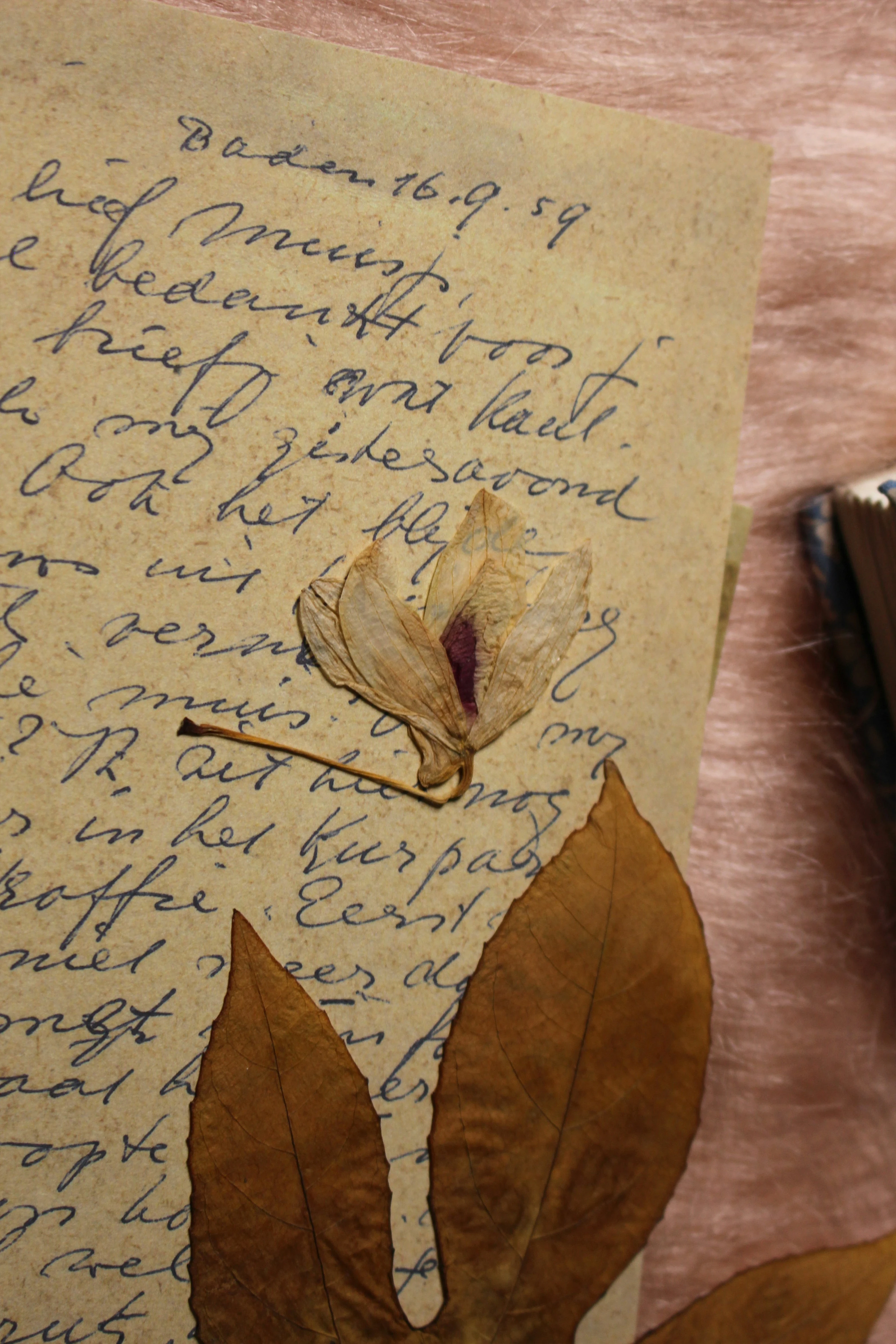
يحتل الشعر الموقع الأمامي من ظاهرة الأدب والفن التي تجسد الوجه الثاني من وجهي التعبير عن الواقع. فإذا كان العلم يعبر عن الواقع بالفكر، فإن الفن يعبر عنه بالصورة. وإذا كان الفكر انعكاساً للواقع بأوسع وأرحب مداه، فإن الصورة هي انعكاس للواقع بأقصى ما يمكن من العمق.
فالشعر إذن، وبما هو يعبر عن الواقع، هو صورة لهذا الواقع، وهو بالتالي علم بهذا الواقع. ولا يعترض على ذلك بالقول: إن الشعر يعبر عن خلجات القلب وعن العاطفة المتأججة، وبذلك يكون بعيداً عن الواقع. إذ أن الإنسان بكليته هو صنيعة الواقع، فالنفس تكتسب عناصر تركيبها من الواقع والقلب يختلج عندما يثار من الخارج.
هذا لجهة مقتضى العلم والمعرفة، وأما لجهة التطبيق العملي والممارسة. فإن التاريخ والواقع يؤكدان هذه الحقيقة العلمية. فالتراث العربي الأدبي مثلاً، يفتقر إلى فن التمثيل والروايات التمثيلية. فإذا كان هذا الافتقار يعود بأسبابه ، فيما خص الحقبة التي تلت ظهور الدعوة الإسلامية، إلى المنع الذي فرضته على كل ما يمت بصلة إلى ظاهرة الأنصاب والأصنام ومنها فن التمثيل، فإن افتقار أدب العصر الجاهلي لهذا الوجه من الفن، يعود بأسبابه إلى فقدان المادة الاجتماعية التي تنعكس على الفكر الأدبي بما يتناسب معها من هذا الوجه من الأدب.
فمن المعروف أن واقع الصحراء يفرض أوضاعاً اجتماعية، تختلف عن الأوضاع الاجتماعية التي يفرضها واقع جغرافية البلاد اليونانية مثلاً، حيث كان هذا الوجه من الفنون الأدبية وافرا في التراث الأدبي اليوناني القديم. ذلك أن الأوضاع الاجتماعية التي فرضتها الطبيعة على المجتمع الجاهلي، لا توفر التلاقي الدائم بين مختلف شرائح المجتمع ومن ثم تفاعل البشر فيما بينهم على جميع الأصعدة الفكرية والعاطفية. بعكس أوضاع المجتمع اليوناني حيث آثار أمكنة الأندية الاجتماعية لا تزال ماثلة في وقتنا الحاضر.
وعلى ذلك، وإذا كانت ظاهرة الفن والأدب تعكس الواقع. فإنها تعكسه بما فيه وعلى جميع وجوهه، وتعكس بالتالي الدرجة العلمية ومراتب الرقى والتقدم التي بلغها واقع المجتمع. وإذا كان المجتمع الجاهلي يفتقر لوجوه متعددة من وجوه الأدب والفن، فليس ذلك دليلا على تخلفه الأدبي والفني. فالتخلف أو التقدم في هذا الحقل يقاس بدرجات جودة وإبداع الوجوه الأدبية التي يوفرها ويحمل عليها الواقع الاجتماعي، وليس بتعدد هذه الوجوه. فمن هذاالمنطلق نعالج الشعر الجاهلي، بما هو الظاهرة الأساسية والوجه الأكثر بروزاً في هذا الحقل، وبما هو يعكس الذوق الأدبي والفني للمجتمع من ناحية، وبما هو يعكس الفكر العلمي من ناحية ثانية.
أولا: الشعر الجاهلي والذوق الأدبي:
من كونها تقتصر على معالجة المعالم العلمية في التراث فإن هذه الدراسة لا تدرس وتقيم الوجوه الأدبية لذاتها. بل بما هي تحمل دلالة على التقدم والرقى الحضاري وبالتالي على توفر الفكر العلمي في المجتمع. ذلك أن الدرجات التي يبلغها الذوق الأدبي والفني هي من الدرجات الحضارية التي يكون عليها المجتمع في مسيرته التاريخية. فلو اخترنا مثلا ظاهرة الرقص ونظرنا فيما هي لدى المجتمعات المتخلفة، وفيما هي عليه لدى المجتمعات المتقدمة، نجد بونا واسعا بين حالتها لدى المجتمعات الأولى وبين حالتها لدى الثانية. فالجودة والإبداع والتنوع والتسامى وجميع عناصر الذوق الفني، هي متوفرة في المجتمعات المتقدمة، بينما هي مفتقدة في المجتمعات المتخلفة، حيث تقبع هذه الظاهرة في بدائيتها وفي رتابة الحركات التي تدخل في أساس تكوينها.
وما يقال عن ظاهرة الرقص يقال عن جميع وجوه الفن والأدب، وفي مقدمتها فن الشعر بما هو الوجه الأبرز والأداة الأبرع للتعبير عن خلجات النفس وسكناتها، وعما تعكسه من الوجود وترتفع وتسمو به إلى مراتب الجمال العليا. وظاهرة الشعر بالنسبة للمجتمع الجاهلي تتجاوز نطاق الخاصية الغالبة على غيرها من الخصائص، لتمثل موقع التلازم. وهذا التلازم يعود بجزء كبير من أسبابه إلى أن الفكر الأدبي والفني لهذا المجتمع، يكاد ينحصر في هذه الظاهرة.
فإذا كان هذا الحصر ناشئاً عن المحيط الذي يفرض أوضاعاً اجتماعية معينة، ولا يتضمن بالتالي دلالة على التخلف، فإن من اللازم أن ننظر في مضامين هذه الظاهرة بهدف معرفة درجة التقدم والرقى الفكري الذي بلغه المجتمع الجاهلي.
من المتفق عليه بين جميع النقاد ومؤرخي الأدب، إن الشعر العربي بجملته وعلى مختلف العصور. وخاصة العصر العباسي التي بلغت فيه الحضارة أقصى درجاتها، لم يتجاوز في جودته وإبداعه الدرجة التي بلغها الشعر الجاهلي. وإن كان الشعر في العصرا لعباسي قد تميز عنه بالسلاسة والليونة والطراوة. فهذه السمات الأخيرة ليست مظهراً من مظاهر الإبداع والجودة بحيث يتفوق الشعر الذي يتصف بها على الشعر الجاهلي . إن قيمتها تنحصر بكونها نتيجة لتحرير الشعر من الصعوبة الناتجة عن قوة الحبك وجزالة التعبير، وذلك بما يتناسب ويتوافق مع طراوة الحضارة في وجوهها المادية.
فهذه الدرجة من الإبداع والجودة هي من درجة التقدم والرقى الفكري التي كان عليها المجتمع الجاهلي. وبالتالي فإن هذه الدرجة العالية التي تبوءها الشعر الجاهلي بشهادة النقاد ومؤرخي الأدب ، تغنينا عن استعراض مختلف وجوه مادة هذا الشعر، وإن كانت لا تفوتنا التفاتة إلى الصورة الشعرية الرائعة في الوقوف على الأطلال وما قيل فيها بقصد التقليل من قيمتها.
فهذه الصورة هي انعكاس لواقع هذا المجتمع الذي كان في وجهه الغالب لا يعرف الاستقرار في مكان معين، ويفتقد لعاطفة التعلق بنقطة معينة من الأرض أو ما يسمى بعاطفة الوطنية. وإذا كان هنالك من تعلق ففي المكان الذي أقام فيه الحبيب فترة قصيرة من الزمن ثم تركه إلى مكان آخر. فيصبح المكان الذي مر فيه الحبيب محلاً لإثارة العاطفة وذلك من منطلق أن هذا المكان قد غادره الحبيب. ولو كان الحبيب مقيما في هذا المكان دون أن يغادره فلا محل لإثارة الذكريات. فمن الطبيعي إزاء هذا الوضع أن يثير هذا المكان عاطفة الشاعر ويدفعه للتعبير عن هذه العاطفة بصورة شعرية بلغت من الروعة والجمال الفائق درجة أصبحت معها تقليداً يلتزم به الشعراء في مطلع قصائدهم، بصرف النظر عن مواضيع هذه القصائد. وقد ارتدت محاولة التقليل من قيمتها بكيدها إلى نحر أصحابها:
قولوا لمن يبكى على رسم درس *** واقفاً ما ضره لو كان جلس
ذلك أنه إذا كانت " مواخير" بغداد التي كان يرتادها قائل هذا الشعر، تختلف بمظاهرها عن مظاهر الصحراء. فإن انعكاس كل من نوعي هذه المظاهر على النفس وبالتالي على الشعر يكون مختلفاً. ومن ثم فإن محاولة الحط من هذه الصورة الشعرية الرائعة تتعارض مع مقتضى العلم والمعرفة فضلا عن أن الذوق يمجها ويرفضها.
ثانيا: الشعر الجاهلي والفكر العلمي:
إن تعبير:" الشعر ديوان العرب" لا يأخذ دلالته من كون هذا الشعر يستوعب المعاني والصور الأدبية والفنية. فهذا الاستيعاب هو حالة طبيعية للشعر ولا تستدعى هذه التسمية. فالسبب الذي استدعى إطلاق هذا التعبير، هو أن هذا الشعر قد استوعب، إلى جانب مضمونه الطبيعي، المعاني والمفاهيم العلمية، كما دون وحفظ الوقائع والأحداث التاريخية.
وهذا الواقع يعود بالجزء الأكبر من أسبابه إلى عدم التناسب بين حالة التقدم على صعيد الفكر وحالة التخلف على صعيد العمران المادي وبالتالي إلى افتقاد المجتمع الجاهلي لوسائل تدوين المادة الفكرية العلمية.
وعملاً بالنهج المتبع في هذه الدراسة، في أن حاجتنا تقتصر، فيما يعني المعالم الفكرية في هذا التاريخ، على إثبات توفر فكري علمي أصيل، ينقض تخرصات من اتهموا الفكر العربي بأن الروحانيات قد استغرقته ومنعته من النظر على مقتضى المنطق العقلي، ويصلح كمنطلق للفكر الخلدوني.
فإن عرضنا لهذه المعالم لا يتناولها بمجملها. فهذه الغاية تتحقق بعرض ما يمكن اعتباره شاهداً ودليلاً على وجود هذا الفكر. وحسبنا لتحقيق ذلك وفيما خص الجانب الأبرز من تراث هذا العصر وهو الشعر، أن نعرض بعضا من أفكار الشاعرين الكبيرين زهير بن أبي سلمى وطرفة بن العبد.
إن الفكر العلمي الذي تنطوى عليه آثار هذين الشاعرين بخاصة، والشعر الجاهلي بل الشعر العربي بعامة، لم يزل مجهولاً ومغيباً عن وعي الأجيال عبر التاريخ. وإن كان ما قيل عن هذا الفكر لا يعدو كونه مقاربة لحقيقة. فالنقاد والمؤرخون، الأقدمون منهم والمحدثون، (حوّموا حول هذه الحقيقة، لكنهم لم يصادفوا الرمية ولا يصيبوا الشاكلة) على حد تعبير ابن خلدون.
فكما أنهم قصروا في معالجتهم للآثار العلمية المحضة، فإنهم قصروا في معالجتهم للآثار الأدبية. وذلك لأن المناهج التي اعتمدوها في النظر في الآثار العلمية، هي نفسها المناهج التي نظروا على ضوئها في الآثار الأدبية. إذ أن المناهج العلمية التي غابت عن وعيهم، والتي يستحيل تقييم المادة العلمية إلا على أساسها، هي ذاتها المناهج التي على أساسها، يجري تقييم المادة الأدبية، لجهة كونها تتضمن إلى جانب الجمال الذي تحمله الصورة، فكرا علميا وبواسطة الصورة نفسها. فكل من المادتين تدخل في خانة الإنتاج الفكري، وإن اختلفت نوعية وطبيعة كل منهما، أو تفاوتت درجة كل منهما في فعاليتها بعملية إنتاج المعرفة.
فالمادة العلمية تعبر عن الواقع بواسطة الأفكار. والمادة الأدبية تعبر عن هذا الواقع بواسطة الصور التي تملك القوة على الإثارة. وبتعبيرها عن الواقع، ولو بشكل يختلف وبدرجات متفاوتة، عن تعبير المادة العلمية.
فإن المادة الأدبية هي منهج من مناهج إنتاج المعرفة، لأنها في حقيقتها تعكس الواقع الذي يحيط بأصحابها. وإذا كان التعبير عن الواقع والأفكار أوسع نطاقاً وأرحب أفقاً فإن التعبير عنه بالصورة هو أعمق أثرا وأشد فعالية.
ولا يعترض على ذلك بالقول: إن إنتاج كل أديب يختلف في معانيه ومقاصده عن إنتاج غيره من الأدباء، وبالتالي تصبح المادة الأدبية تعبيراً عن ذاتية كل أديب بمفرده. فمع الاعتراف بأن كل إنتاج أدبي يختلف عن الآخر. فإن هذا الاختلاف يعود بأسبابه إلى الاختلاف بانعكاس الواقع على وعي كل أديب بمفرده.
فإذا كان للواقع حقائقه المطلقة بذاتها. فإن هذه الحقائق تنعكس بدرجات متفاوتة وبصور مختلفة على وعي كل إنسان بمفرده. فنظرة زيد الواقف على يمين الشيء تعكس غير ما تعكسه نظرة عمرو الذي يقف على يسار هذا الشيء. وهذه هي حقيقة ما يختلف عليه الناس بأن قسما منهم يقول بالحقيقة النسبية، وقسماً آخر يقول بالحقيقة المطلقة، فالحقيقة، والحقيقة المطلقة، إن شئت. هي في أن للواقع وللشيء حقائقهما المطلقة، وإن اختلفت صور انعكاس هذه الحقائق على الوعي بين إنسان وآخر. وإذا كان الإنسان عاجزاً عن استيعاب حقائق الواقع من نظرة واحدة أو من نظرات معدودة، فإنه يسعى ويجتهد لاستيعابها بمجملها.
وعلى ذلك فإن قانون الجاذبية، هو حقيقة مطلقة. وعندما اكتشف " نيوتن" هذا القانون، فإن هذه الحقيقة المطلقة قد ارتكزت في وعيه. ولا يعترض على ذلك بأنه من الممكن أن تكون هناك جوانب من هذا القانون لم تزل غائبة عن وعي البشر. فعلى افتراض صحة ذلك، فإنه يستحيل نقض الجانب الذي يتضمن حقيقة كون الأجسام تنجذب إلى الأرض وتكون معها زاوية قائمة، في غياب المؤثرات الخارجية. وبالتالي فإنه توجد في الكون حقائق مطلقة كما توجد حقائق نسبية. والمطلقة منها هي من الثوابت، بينما النسبية هي من المتغيرات. وكل صاحب حقيقة نسبية، يسعى جاهداً لبلوغ الحقيقة المطلقة. وهذا السعي يؤدي به إلى تغيير صورة الحقيقة النسبية التي انطبعت في ذهنه ابتداءً.
فالمادة الأدبية هي إذن، انعكاس للواقع بالصورة ذات القوة والفعالية على الإثارة. وباعتبارها انعكاساً لهذا الواقع، فإنها تتضمن المعرفة والعلم به. وبالتالي فإن الشعر الجاهلي بذاته، وإن اقتصر في تعبيره عن هذا الواقع بالصورة ذات التأُثير البالغ، فهو يتضمن العلم والمعرفة بهذا الواقع. بالإضافة إلى أن قسماً منه يحمل أفكارا علمية خالصة. أي أنه عبر بهذا القسم عن الواقع بالأفكار وليس بالصورة المؤثرة.
والنقاد ومؤرخو الأدب العربي قد قصروا عن رؤية ما ينطوى عليه الشعر العربي من علم بالواقع بواسطة الصورة. كما قصروا عن اكتشاف طبيعة ودرجة المعرفة التي تنطوى عليها الأفكار التي يحملها هذا الشعر. وما ينطبق على الشعر العربي بعامة ينطبق على الشعر الجاهلي بخاصة.
ويظهر تقصيرهم في الجانب الأول في إغفالهم الإشارة لمضمون هذا الجانب وفي خلو أبحاثهم من تقييم الواقع المتقدم فكرياً وعلمياً، والذي يعبر عنه هذا الشعر، بما هو قد بلغ الدرجة القصوى من الإجادة والإبداع التي لم يتجاوزها الشعر العربي بعامة. ودرجة الإبداع والإجادة في الفنون هي من درجة التقدم الفكري التي يبلغها المجتمع في جميع الوجوه.
وبالتالي فيكفي أن نقف على هذه الدرجة التي بلغها الشعر الجاهلي كي نتأكد من الدرجة العلمية المتقدمة التي بلغها مجتمع الجاهلية. وإذا كان إنتاجهم العلمي لم يصل إلينا برمته، فلأسباب تاريخية. لكن ما وصل إلينا، فإنه ومع ندرته، على درجة متقدمة، وهو بذلك يكفي كدليل على وجود فكر علمي في هذا المجتمع.
وأما تقصيرهم في تقييم القسم الذي يعبر عن الواقع بالأفكار فهو في تصنيفهم هذه الأفكار تصنيفا عاما، وذلك بأن وضعوها في دائرة " الحكمة"، دون أن يعينوا درجة هذه الحكمة ودون أن يحددوا طبيعتها. كما وإنهم أيضا قد حطوا من قدر فكر هذا المجتمع بعامة، بأنه لم يتجاوز دائرة الفكر العملي وفي ذلك جهل لقانون التلازم بين الفكر العملي والفكر النظري كما أثبت ذلك الفيلسوف الكبير ابن سينا، بقوله إن الفكر العملي ينعكس حكماً ومباشرة على الحافظة ليكون الفكر النظري. وبالمقابل فإن الفكر العملي يسترشد بالضرورة بالفكر النظري.
وصنفوا بعض آثار الشاعر زهير بن أبي سلمى التي تحمل أفكاراً علمية عالية المستوى، بأنها تنطوي على " حكمة". وكلمة حكمة في اللغة تعني وضع الشيء في مكانه. ولكن المسألة هي في تحديد الدرجة التي يحتلها هذا المكان، وبالتالي تحديد درجة الحكمة التي تبلغها أفكار هذا الشاعر.
وبتعبير آخر، تعيين درجة هذه الحكمة في سلم العلم والمعرفة. وعجزهم عن تعيين هذه الدرجة هو في جهلهم للأًصول المعرفية الأولى أو للمناهج العلمية العامة.
والأصول المعرفية الأولى هي الأسس التي ترتكز إليها الأبنية المعرفية على اختلاف أنواعها. والجهل بهذه الأسس يؤدي إلى جهل ما يبني عليها، وبالتالي إلى العجز عن تعيين درجة الجودة والإبداع التي يبلغها هذا البناء.
وأفكار هذا الشاعر التي تنطوي عليها بعض أشعاره تدخل بوجه عام، في دائرة السلوك أو في دائرة تدبير أمور الإنسان وتنظيم شؤون حياته بمواجهة أقرانه في المجتمع. وسبل السلوك وتدبير أمور الحياة وتنظيمها تخضع مبدئياً لسنة التحول والتبدل. إنما هناك سبل لا تخضع لهذه السنة وتدخل في دائرة الثوابت والثوابت هي، كما سبق بيانه، من حقائق الوجود الأساسية التي تدخل في موضوع الفلسفة العامة. والتي تحكم الوجود في كل مكان وزمان.
وتوجد علامتان في آثار هذا الشاعر الكبير تشيران إلى إدراكه لهذه الحقائق وهما اللتان يحملهما هذا الشعر:
ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه *** بهدم. ومن لا يظلم الناس يظلم
فالعلامة الأولى ، وهي تعبير هذا الشعر عن الواقع بصورة جمالية رائعة، ثم تجسيد العام بالخاص وبدرجة عالية من الجودة والإبداع الفني.
والعلم هنا هو في أن الحق يضيع ويتبدد إذا لم يتحصن بحواجز من القوة.
والخاص هو في الظاهرة الملتصقة بمجتمع البادية، حيث المياه نادرة بوجودها وحيث أحواضها هي بحماية القوة وإلا أصبحت محلا للسلب والاغتصاب.
وأما لجهة كونها من الثوابت ومن حقائق الوجود الأساسية. فذلك ما يثبته وجوب إقامة السلطة على الدوام وإلزام الناس بإطاعة أوامرها وقوانينها، بهدف القضاء على التنازع بين البشر الذي يشكل العلامة الثانية على كون الحق هو محل للسلب والاغتصاب، ولا تنقذه من هذه الحالة سوى القوة.
والعلامة الثانية في هذا الشعر تشير إلى حقائق سيادة القوة في الاجتماع الإنساني . وبيان ذلك أن التنازع موجودة بالضرورة في المجتمع نتيجة التزاحم على حاجات الدنيا:" ومن ضرورة الاجتماع التنازع لازدحام الأغراض" . والتنازع لا يحسم كما سبق وذكرنا سوى بالقوة والغلب.
والفريق الذي يحسم التنازع بقوته هو الذي يسيطر ويحكم المجتمع. وحكم المجتمع بالقوة هو الظلم بعينه. والظلم ينطوى على وجود ظالم ومظلوم في هذه الدنيا. وبالتالي فإن هذا الشعر يتضمن حقيقة من حقائق الوجود الأساسية ويحمل ذلك بأقصى درجات المعاني العلمية.
وإذا كان إدراك الشاعر قد اقتصر على ملاحظة هذه الحقيقة دون أن يذكر الأسباب التي تؤدي إليها. فذلك يعود إلى أن البحث بالأسباب يحتاج إلى دراسة متواصلة متكاملة تستدعى المناقشة والمحاكمة. وهذا يحتاج إلى أسلوب الكتابة المرسلة ويصعب حصوله بواسطة الكلام المنظوم والمقيد.
وعلى فرض وجود إهمال أو جهل لهذه الأسباب فإن الملاحظة مع الإصرار عليها تكفى بذاتها دليلا على وجود فكر علمي متقدم.
وأما المعاني التي تحملها آثار الشاعر الكبير طرفة بن العبد، فإنها في مجملها لا تخرج عن نطاق الدعوة إلى سلوك سبل معينة في الحياة. إنما هذا السلوك لا يدخل في دائرة العمومية كما هو عند الشاعر زهير. وهذه المعاني لا تعدو كونها، وفي جزء منها، دعوة للتهتك والخروج عما توافق عليه الناس من الالتزام بسلوك سبل السعي والعمل المثمر:
وتقصير يوم الدجن والدجن معجب *** ببهكنة تحت الخباء المعمد
ودعوة لسلوك سبل الشهامة والفروسية في جزء آخر:
وكرى إذا نادى المطاف محنباً *** كسيد الغضا نبهته، المتورد
ولكن العبرة ليست في نوعية هذا السلوك وطبيعته. إنما هي في الدعوة لذاتها، وباعتبارها تهدف إلى الخروج عن القواعد والتقاليد التي تفرضها أنظمة القبيلة، وفي مناقشة هذه القواعد والتقاليد ومحاكمتها بقصد إظهار فسادها وبطلانها:
فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي *** فذرني أبادرها بما ملكت يدى
وهناك لمحة من أثار هذا الشاعر تشير إلى أن مسألة الإيمان وعدمه كانت مطروحة للبحث والمناقشة. وبما يفيد أن الأبحاث العقلية كانت على مستوى الظاهرة الاجتماعية، يعني أن عملية البحث والمناقشة هذه قد أفلتت من قيود الخطر التي كانت تفرضها المجتمعات القديمة المتزمتة:
كريم يروى نفسه في حياته *** ستلعم إن متنا غداً أينا الصدى
والإفلات من هذا الخطر لا يحصل إلا بعد أن يتمكن العقل من تثبت أركانه بمواجهة الإيمان المفروض على الوعي دون مناقشة عقلية.
ذلك أنه وبالرغم من الشوائب التي كانت تعترى الظاهرة الدينية في العصر الجاهلي، بما يستدعى إصلاحها بموجب دعوة دينية جديدة، فإن الإيمان كان ظاهرة ثابتة ومتمكنة من الأفئدة في المجتمع الجاهلي.
المرجع:
ابن خلدون ، للدكتور مصباح العاملي، الطعبة الأولى 1988م، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان ، ليبيا، مصراته. ص ص : 112-122
2-تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية، مصطفى عبدالرزاق، القاهرة، 1944م، ص112.