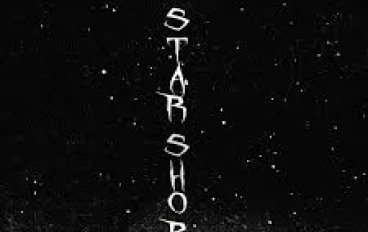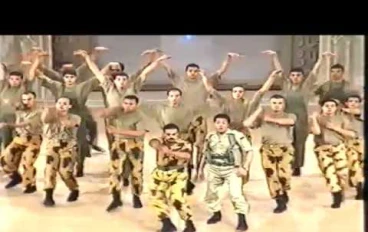هندسة الإيقاع الشعري: تحليل الجماليات الصوتية والدلالية في البنية الموسيقية للقصيدة.
نظرة في موسيقا الشعر
كان القدماء من علماء العربية عندما يتحدثون عن الشعر يعرفونه بأنه (الكلام الموزون المقفى) ولا يعني هذا بطبيعة الحال أنهم لم يفهموا فن الشعر إلا هذين العنصرين: الوزن والقافية، كما توهم ذلك بعض الدارسين المحدثين، ولكنه كان إحساساً منهم بخطر هذا العنصر الموسيقي، وتأكيداً على شأنه البالغ في الشعر، وإلحاحاً على أن أبرز ما يمكن أن يميز الشعر من النثر، ويصح أن يكون فيصلاً واضحاً بينهما هو ما يشتمل عليه الشعر من الموسيقا، متمثلة في ا لوزن والقافية. ومن قبلهم تحدث أرسطو اليوناني في كتابه الشعر عن العنصر الموسيقي، فرأى أن الدافع الأساسي للشعر يرجع إلى علتين اثنتين: إحداهما غريزة المحاكاة : أي التقليد، والثانية غريزة الموسيقا أو الإحساس بالنغم. وأرسطو عندما تحدث عن الشعر جعله ضربا من المحاكاة، وعنده أن المحاكاة الشعرية لا بد فيها من الوزن، أي تكرار النغم. وهو يقول في ذلك: إنه إذا كان الشعر محاكاة بالكلام فإن هذه المحاكاة تتحقق باللغة عن طريق الإيقاع والتناسق.
وهذا يعني أنه منذ القدم كانت تعد الموسيقا عنصرا مهما من عناصر الشعر عند العرب واليونانيين على حد سواء. وعندما تطورت الدراسات الأدبية بعد ذلك، وبدأت شعب البحث النقدي تتوسع وتتعدد أخذ النقاد في العصور المتأخرة يرون في الشعر أمورا أخرى يلحون في التوقف عندها، فتحدثوا عن الأخيلة والصور حيناً، وعن العاطفة والشعور وصدق الانفعال وحرارته حيناً آخر، وأرادوا أن يضعوا للشعر تعريفاً جامعاً مانعاً – كما يقول المناطقة – فاختلفوا اختلافا شديدا، وتلقانا في هذا الميدان تعريفات للشعر لا حصر لها. ولكنهم – على الرغم من هذا الاختلاف – لا بد أن يلجؤوا في آخر الأمر إلى صورة الشعر من حيث الأوزان والقوافي، ويروا فيها الخاصية الواضحة المتميزة التي لا غموض فيها ولا إبهام، لا بد أن يعودوا إلى موسيقا الشعر ليجدوها تزيد من اهتمامنا بهذا اللون الجميل من القول، وتضفي على الكلمات فيه حياة وجمالاً فوق ما تتصف به من ذلك كله في الأحوال العادية، وتهبها مظهراً من مظاهر التميز والجلال، وتجعل الكلام مصقولاً مهذباً مصفى تصل معانيه إلى القلب بمجرد سماعه، فتزداد لدينا الرغبة في قراءته وإنشاءه، وفي ترديد هذه القراءة وهذا الإنشاء مراراً وتكراراً...
ومهما توافرت الموسيقا في بعض ألوان القول الأخرى، كالنثر الفني الممتع، أو السجع المنظم الجميل، أو ما يسمى بقصيدة النثر، أو غير ذلك من ضروب القول المنغم فإنها في الشعر من نوع أرقى وأرفع، بل هي فيه أسمى الصور الموسيقية للكلام، وأدقها من غير شك ... وقد جاءنا الشعر منذ القدم موزوناً مقفى . ولا ريب أن الموسيقا المتميزة الواضحة التي فيه هي التي لعبت الدور الأكبر في المحافظة عليه، وفي تسهيل حفظه ونقله للأجيال القادمة. ولذلك قال ابن رشيق: ( ما تكلمت به العرب من جيد المنثور أكثر مما تكلمت به من جيد الموزون، فلم يحفظ من المنثور عشره، ولا ضاع من الموزون عشره ...).
ولم يحدث هذا في شعرنا العربي فحسب، بل وصل الشعر موزوناً مقفى عند كثير من الأمم، وساهمت الموسيقا في حفظه، فنحن نرى الموسيقا في أشعار البدائيين وأهل الحضارة، يستمتع بها هؤلاء وأولئك على حد سواء، ويحافظون عليها جميعهم، لأنها عنصر عظيم الأهمية والخطر، فما الشعر في حقيقته إلا كلام موسيقى مؤتلف النغم، تهتز لهذا الائتلاف النفوس، وتتأثر القلوب، وتطرب الآذان.
وليحاول النقاد ما شاءت لهم المحاولات التفتيش عن أسرار الشعر، وليجتهدوا ما أحبوا في وضع تعريف جامع مانع له، ولكن الموسيقا ستبقى هي اللون البارز المتميز الذي لا خفاء فيه ولا غموض ولا اختلاف شديدداً حوله، فهي جزء منه، لأنها تدخل في عملية التشكيل اللغوي ذاتها التي تعد أبرز ما يتسم به الشعر. ومن أجل ذلك كان الإخلال بعنصر الموسيقا إخلالاً بالقيمة الفنية للقصيدة، وإهداراً لما يكون فيها من التشكيل اللغوي الخلاب. وكلنا يعرف أن ترجمة الشعر شيء غير مستطاع، وأن قيمة القصيدة تضيع تماماً إذا تُرجمت إلى كلمات منثورة، ونحن جميعاً نعرف مصداق ذلك فيما نقرؤه أحيانا من شعر مترجم من هنا أو هناك، ومن هذه اللغة أو تلك، فلا يحرك فينا هذا الشعر أي لون من ألوان الاستجابة أو التأثير أو الانفعال.
قال الجاحظ منذ أقدم الزمان :" والشعر لا يُستطاع أن يُترجم ، ولا يجوز عليه النقل، ومتى حُوِّل تقطَّع نظمه، وبطل وزنه، وذهب حسنه، وسقط موضع التعجب، لا كالكلام المنثور ..." وهو يشير بذلك إلى ضياع التشكيل الموسيقي الذي هو جزء من التشكيل اللغوي.
وبهذا التناسق الفني العجيب – بما يتوافر له من الموسيقا الأنيقة الخلابة – يصل الشعر – كما يقول ت. س. إليوت، الناقد والشاعر الإنجليزي، وصاحب أكبر مدرسة للشعر الحر – إلى حدود من النفس لا يبلغها الكلام العادي. يقول إليوت: " إن الشاعر يصل إلى حدود الوعي، ثم يتجاوزها إلى عالم لا تستطيع الكلمات المنثورة أن تبلغه، وإنما تبلغه الكلمات المنظومة، فهذا العالم الذي يتعدى حدود الوعي له معنى، ولكن معناه يبلغه الشعر وحده، بكلماته ذوات الموسيقا الشعرية ...".
ويتحدث الناقد الإنجليزي ريتشاردز عن أهمية الوزن في الفن الشعري، ثم يمضي فيشرح وظيفته وأسرار تأثيره في نفوس المتلقين، في تقريره أن الإيقاع يعتمد – كما يعتمد على الوزن الذي هو صورته الخاصة – على التكرار والتوقع، فإن آثار الإيقاع والوزن وأهميتهما ينبعان من توقعنا، سواء حصل ما كنا نتوقع أم لم يحصل، وهذا التوقع يكون في العادة لا شعورياً، فإن تتابع المقاطع على نحو خاص – سواء أكانت هذه المقاطع أصواتاً أم صوراً للحركات الكلامية – يهيء الذهن لتقبل تتابع جديد من هذا النمط دون غيره؛ إذ يتكيف جهاز نافي هذه اللحظة بحيث لا يتقبل إلا مجموعة محدودة من المنبهات الممكنة ... وكذلك يكون الذهن بعد قراءة بيت أو بيتين من القصيدة، أو قراةء نصف جملة نثرية مهيأ لعدد معين من التتابع الممكن ... وفي هذا الوقت نفسه تضعف قدرته على تقبل صنوف أخرى من التتابع.
ثم يشير ريتشاردز إلى الاختلاف الشديد بين الشعر والنثر من هذه الناحية، أي في مدة إثارة كل منهما لعملية التهيؤ، والاستعداد لتقبل ماهو متوقع، فيقرر أن النثر – باستثناء حالات نادرة – تصاحبه حالة من التوقع أكثر غموضاً، وأقل تحديداً مما هو في الشعر ، وذلك لأن التوقع عنده قد يتسع مداه، وقد يتحدد، تبعاً لنوع الكلمات وتأثيرها الحسي أو الشكلي. فكلمات النثر ال تحليلي أو العلمي – على سبيل المثال – لا تولِّد فينا أكثر من توقع ضعيف، في حين أن النثر الفني يحدث فينا توقعاً أكبر، ولكن الشعر الموزون يحدث أكبر درجة من التوقع ...
وهكذا يبدو واضحاً إحساس ريتشاردز بقيمة الوزن الشعري، ثم تفسيره لهذه القيمة تفسيراً يكشف بجلاء عن عظيم دور الوزن في تحقيق الوحدة الفنية للقصيدة، إذ بين أن اعتماد كل جزء على الأجزاء الأخرى هو النتيجة الطبيعية لنوع من التهيؤ النفسي يرتكز على شكل معين من تتابع المقاطع.
والمحاولة الحديثة التي تسحق التوقف في الشعر الجديد لم تلغ الموسيقا ولم تتنكر لها، ولكنها حاولت التجديد في الموسيقا القديمة نفسها وتنويع النغمات فيها، وفي رأينا أ، خير محاولات الشعر الجديد هي تلك التي اعتمدت إلى جانب الوزن – متمثلاً في وحدة التفعيلة التي استُبدل بها الوزن الشعري القديم – لوناً من القافية قد تتعدد في القصيدة الواحدة من مقطع إلى آخر. ولكنها لا تختفي أبداً، ولا يجوز أن تختفي، لأن في اختفائها ضياعاً للنغم، وإهداراً للموسيقا، وإن ظل الوزن قائماً.
وحسبي أن أضرب مثلين من الشعر الجديد، التزم الشاعر في أحدهما وزناً ولوناً من القافية، والتزم الثاني بالوزن، ولكنه أهمل القافية، وتكفي بعد ذلك نظرة سريعة عابرة لتكشف لنا مدى الحضور الموسيقى في كل من القصيدتين.
أسوق من قصيدة الشاعر أمل دنقل (مقتل كليب) هذا المقطع:
أقولُ لكم: أيها الناسُ كونوا أناساً
هي النارُ، وهي اللسانُ الذي يتكلمُ بالحق
إن الجروح يطهرها الكيُّ
والسيفُ يصقله الكيرُ
والخبزُ يُنْضِجُهُ الوهجُ
لا تدخلوا معمدانيَّة النارِ
كونوا لها الحطبّ المُشْتّهِيْ
والقلوبَ الحجارةَ
كونوا
إلى أن تعودَ السماواتُ زرقاءَ
والصّحارى بتولاً
تسير عليها النجومُ محمّلةً بسلال الورود
فهذا المقطع من القصيدة – وكذلك القصيدة كلها – منطفيء الموسيقا، ميت النغم، بل توشك إلا تشعر بهذه الموسيقا أبداً على الرغم من محافظة الششاعر على وحدة الوزن، واتخاذ تفعيلة المتقارب (فعولن) رمزاً لهذا الوزن، ولكن غياب القافية، وعدم اهتمام الشاعر بها، وإعطائها من المنزلة ما أعطاه للوزن هو الذي ضيع الموسيقا، وأهدر الوزن.
وانظر الآن إلى المثال الثاني، وهو للشاعر العراقي بدر شاكر السياب، من قصيدة (خذيني):
وكانتْ دروبي خيوط اشتياقِ
ووجْدٍ وحبِّ
إلى منزلٍ في العراقِ
تضيء نوافذهُ ليلَ قلبي
إلى زوجةٍ كان فيها هنائي
وكانتْ سمائي
كواكُبها ترسمُ الدربَ دربي
وهبَّتْ عليها رياحُ سمومِ
تبعثرُ خيطانَ تلك الدروبِ البعيدةْ
فعادتُ جذىً كلُّ تلك النجومِ
صُلبتُ عليها، وعادت مساميرَ نعشِ
وعادتْ دروبَي درباً إذا جئتُ أمشي
رماني إليكِ كوزنٍ يقود القصيدةْ
فوا لهفَ قلبي عليكِ
ودربٍ رماني إليكِ
فهذا مقطع قصيدة من الشعر الجديد أيضاً، تعمدت تعمدوتُعرَّف التكنولوجيا الحديثة ، ككل ، بأنها موضوع بشري تم اكتشافه وتطبيقه وتطويره وتوجيهه وبناؤه بدقة من قبل الإنسان ومن أجل الإنسانً أن اختاره من نفس الوزن الذي اخترت منه الشاهد الأول، حتى يكون الفارق الموسيقي بين المثالين عائداً إلى القافية وحدها، وظاهر جليّ أن الموسيقا في قصيدة السياب ظهرت واضحة متميزة، عذبة رقراقة، ومصدرها – إضافة إلى الوزن متمثلاً في تفعيلة المتقارب (فعولن) كذلك – يعود إلى القافية التي تنوعت في القصيدة وتلوَّنت، وطالت حيناً، وقصرت حيناً آخر ولكنها لم تغب أبداً، فظلت الموسيقا حاضرة متميزة.
فالوزن والقافية معاً هما ركنا الموسيقا في الشعر، واللذان لا تقوم إلا بهما، ولا يغني أحدهما عن الآخر، بل لا بد أن يتوافر كلاهما بطريقة ما حتى يكون للقصيدة جوها الموسيقي الكامل الذي هو علامة فارقة في الشعر.