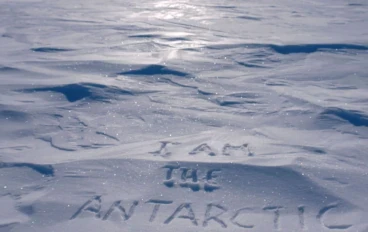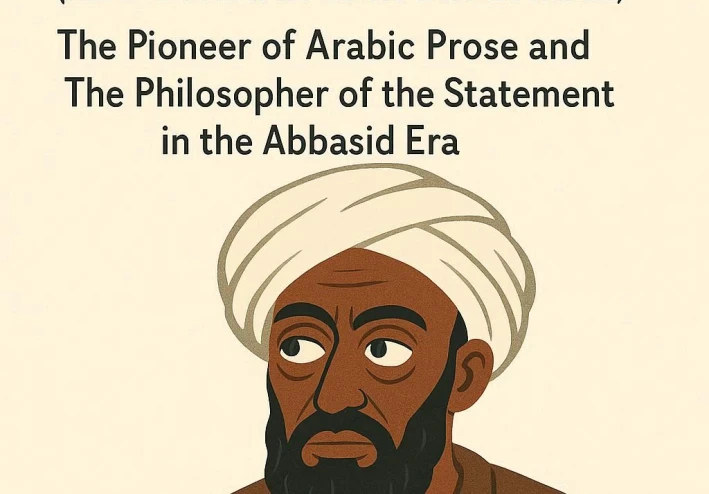
الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر): رائد النثر العربي وفيلسوف البيان في العصر العباسي
الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر): رائد النثر العربي وفيلسوف البيان في العصر العباسي
يُعدّ أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت. 255 هـ / 869 م) منارة شامخة في سماء الثقافة العربية، ليس بصفته أديبًا فحسب، بل فيلسوفًا للبيان ومؤسسًا حقيقيًا للنثر الفني الذي شهد ذروته في العصر العباسي الذهبي. لقد تجاوز الجاحظ مهمة الكتابة التقليدية ليؤسس منهجًا فكريًا ولغويًا فريدًا، جمع فيه بين العمق المعرفي، وسعة الاطلاع الموسوعي، والقدرة الفائقة على التحليل والسخرية اللاذعة.
إن تناول شخصية الجاحظ يتطلب الغوص في نصوصه الخالدة، من "البيان والتبيين" و"الحيوان" إلى "البخلاء"، حيث لم يترك ظاهرة اجتماعية أو قضية لغوية أو فكرة علمية إلا وطرقها بأسلوبه الساحر المعروف بـ**"السهل الممتنع"**. هذه المقدمة تمهد الطريق لدراسة معمقة تستكشف كيف استطاع هذا العملاق البصري أن يُشكّل الوعي الثقافي لجيله والأجيال التي تلته، ليظل اسمه مرادفًا للبراعة في الجدل، والمنطق في العرض، والعبقرية في التعبير.
1-حياته:
ولد أبو عثمان عمرو بن بحر ، الملقب بالجاحظ (لبروز عينيه من حدقتيهما الواسعتين) في البصرة سنة 775م- 159هـ وتوفي والده وهو بعد حديث السن، ولما شب طلب العلم أولاً في الكتاب مع أولاد القصابين، ثم راح يتعيش بعمل يديه يبيع الخبز والسمك بالبصرة، وهو لا يألو جهداًفي طلب العلم ومطالعة الكتب.
وكانت البصرة لذلك العهد أكبر حواضر العلم والأدب بعد بغداد يجتمع في مسجدها طائفة حسنة من العلماء وأرباب النحو واللغة والأدب عرفوا " بالمسجديين" فأقبل إليهم أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ يجالسهم ويأخذ عنهم الكثير بفضل ذكائه المتوقد، وحافظته القوية ، وتلقى الفصاحة وأساليب التعبير شفاها عن خطباء العرب في المربد، وكان إلى ذلك يكترى حوانيت الوراقين ويبيت فيها للمطالعة.
ولما اجتمع له قدر صالح من العلم والأدب قصد بغداد، واتصل فيها بالكبار من علماء الشريعة.
وتردد إلى مجالس الأدباء فوجد عندهم ما لم يجده عند مشايخه الذين أخذ عنهم الشعر والأدب، وبهم عرف ماهية الشعر، وقام بحق الأدب والكتابة.
وظل الجاحظ يزاول فنون (الأدب والأخبار واللغة والحكمة والكلام) ويعمل الفكر ويحلل، ويتوسع في ما حصله، حتى تمت له ثقافة راقية، وتنبه عقله، فتمكن من التعرض لقضايا خطيرة في الدين وكان له مذهب وأتباع، وشرع يؤلف الكتب.
وما أن كان القرن التاسع الميلادي " الثالث الهجري" حتى صارت له شهرة كبيرة بين كتاب عصره، وترامت تلك الشهرة إلى أذن المأمون – وقد قرأ له " كتاب الأمانة" وأعجب به – فاستقدمه، وسأله أن يكتب له رسالته في العباسية والاحتجاج لها.
ولما رأى المأمون ما للجاحظ من مقدرة على الكتابة، ومن سعة في الثقافة أراد أن يسند إليه" ديوان الرسائل"، وهو من أهم ما يدور عليه محور السياسة العامة للدولة – غير أن الجاحظ لم يمكث في ذلك المنصب سوى ثلاثة أيام ، وكأنه لم يستطيع الخضوع لنظم الدواوين، وما يقتضيه سير العمل فيها، ولا تمكن من الإقلاع عن العبث في عمل يتطلب الرصانة والوقار، ولا احتمل منافسة الحساد الذين ثاروا عليه خوفاً على شهرتهم ومنزلتهم في الدولة ومجالس الأدب.
خرج الجاحظ من ديوان الخليفة، وآثر أن يعيش مطلقاً من كل قيد وما هي إلا سنوات حتى اتصل اتصالاً وثيقا بمحمد بن عبدالملك الزيات وزير المعتصم ثم الواثق من بعده، وكان ابن الزيات من أكابر رجال الأدب والسياسة، فكتب له الجاحظ ومدحه، وأهداه " كتاب الحيوان" فأجازه الوزير بخمسة آلاف دينار، وفي تلك الأثناء قام الجاحظ بأسفار إلى دمشق وأنطاكية، وربما يوصل إلى مصر أيضاً فزادته الأسفار اطلاعاً ومعرفة، وبهرت خياله بصور جديدة.
ولما مات الواثق وتولى المتوكل، كان في نفس المتوكل من ابن الزيات شيء فأسقط ابن الزيات وفتك به، فهرب الجاحظ ولكنه قبض عليه.
وتولى القضاء للمتوكل (أحمد بن أبي دؤاد) فقدم الجاحظ له كتاب البيان والتبيين فأعطاه ابن أبي دؤاد خمسة آلاف دينار ولما مات القاضي خلفه في القضاء ابنه أبو الوليد فلزمه الجاحظ إلى أن صرف عن القضاء.
ثم اتصل الجاحظ بالفتح بن خاقان وزير المتوكل، وقدم له بعضاً من كتبه منها كتاب منافب الترك" وكانت بين الرجلين مودة ومراسلة، وطالما أثنى الفتح عليه عند المتوكل وأخذ له الجوائز إلا أن المتوكل لم يقربه لدمامة خَلْقه.
واشتدت وطأة المرض والكبر على الجاحظ، فوهنت قواه وأصيب بفالج نصفي، فعاد إلى البصرة حيث لزم بيته سجين الهرم والمرض وهرع العلماء والأدباء إلى زيارته في علته وتوافدوا عليه من بغداد والبصرة وغيرهما من البلدان، وكان المبرد صاحب كتاب " المبرد" من جملة الزائرين.
وأخذ نوره يتضاءل شيئاً فشيئاً حتى انطفأ، وترك من خلفه نور العلم والثقافة الواسعة ومات في سنة 868 م - 255هـ وقد انهالت عليه الكتب يوماً وهو جالس بينها يقرأ فقضت عليه.
لقد لحدتْهُ ميتاً بعد أن كانت سلوته وشغله الشاغل في حياته إلى ساعة مماته.
2-فنه:
ليس الجاحظ بالأديب الفسيح الخيال، ولا هو برجل العاطفة التي تستبد بجميع كيانه وإنما هو رجل الاعتزال (أي العَقْل والجدل) يتطلب الحقيقة بكل قواه، ويبحث طويلاً ، ثم يسعى جهده للتعبير عنها تعبيرا بينا يظهر جميع دقائقها .
ولذلك نراه يعدل عن أساليب المجاز ما استطاع، وإن عمد إلى شيء من التشبيه والاستعارة فما ذلك للزخرف أو للصنعة ولكنه للوضوح والإبانة – بطريقة واقعية محسوبة فاستعاراته وتشبيهاته بعيدة كل البعد عن التعقيد والإغراب، قريبة كل القرب من ا لأفهام.
ويراعى مقتضى الحال، فهو خبير بنفسه الإنسان، ومفتن ماهر، لا ينسى من يضع لهم كتبه، ولا يغفل عن أحوال المكان أو الزمان، فيتحدث إلى قرائه بأسلوب طبيعي بعيد عن الصنعة.
وعبارته تمتد تارة وتقصر أحياناً، وترسل إرسالاً من غير تمويج أو تقطيع، وتقطع تقطيعاً موسيقياً ماهراً.
ويميل عن جفاف الأسلوب العلمي الخالص، وينزع إلى الحياة الحرة الطليقة التي تروق أبناء عصره.
ويعمد إلى الهزل في مواطن الجد. ويسترسل في الاستطراد والاستشهاد والجدل.
ولا شك أن ذلك الاستطراد، وما يتبعه من مراعاة الأحوال يلحق ضررا بالوحدة التأليفية، والمنطق العلمي ولكنه يروق أبناء العصر، ويروج المصنفات، ويفهم الحقائق ويفسرها.
ولغة الجاحظ هي اللغة التي يقتضيها العقل، ويطلبها التعبير عن الحقيقة،فمذهبه واضح يعتمد على الألفاظ الدقيقة الواضحة الأداء، الواقعية الحسية، البعيدة عن الخشونة والغرابة.
يقدر اللفظة بجرسها وزنتها، وما ينتظر من تأثير توقيعها وتلحينها إذا قرنت إلى أختها، ويجيز الثقيلة والخفيفة والمأنوسة والوحشية، فيختار ما يؤدي معناه حق الأداء.
وكان نحاتاً وبناء في وقت واحد، ينظر إلى شيئين في كتاباته:" الدقة والموسيقى فشاعت العذوبة في كلامه، إلا أن تلك الدقة لا تخلو من غموض، كما نراه في التباس الضمائر فلا يعرف إلى من ترجع لتعاقبها، وأحيانا يعمد إلى ألفاظ أعجمية وعامية لمراعاة مقتضى الحال.
ومهما يكن من أمر فالجاحظ مصور بارع يصور بجمله وألفاظه فيذكر الدقائق والتفاصيل بأوضاعها وتراكيبها لا بسلسلة تصويرات أو تشبيهات أو ما إلى ذلك.
3-كتاب البيان والتبيين:
أ-ماهيته:
هذا السِفر الأدبي يُعدُّ من أواخر إبداعات الجاحظ، وهو بمثابة خزانة أدبية زاخرة بالمختارات النفيسة. يتألف الكتاب من نسيج رائع يضمّ بديع الآي القرآني، وشريف الحديث النبوي، وعمق الشعر الرصين، وجمال الحكمة البالغة، وقوة الخطب المؤثرة. وقد جاءت هذه المختارات ممزوجة بآرائه الثاقبة حول جملة من المسائل الفكرية والأدبية المتنوعة. وقد شهدت مصر طبعته الأولى سنة 1926م، ليخرج إلى النور في ثلاثة أجزاء ضخمة.
ب-أقسامه:
تتخلل هذا السِفر، كما هي الحال في سائر مدوّنات الجاحظ، "فوضى منهجية" أو "عفوية تأليفية" تجعل محاولة حصر موضوعاته ضمن أقسام متسلسلة أمراً عسيراً. غير أن الكتاب ينسج ببراعة فائقة خيوطاً متداخلة بين ثلاثة محاور معرفية رئيسية هي: (علوم البلاغة، والأدب، والتاريخ).
في محراب البلاغة والفصاحة: ينطلق الجاحظ من ماهية البلاغة ذاتها، مستعرضاً نعمة الفصاحة، ثم يُفصّل القول في عيوب اللسان وآفات العي، مثل اللحن واللكنة، والفأفأة، والتمتمة، والتشديق، والتعصب. كما يلحق بهذا الباب الحديث عن فن الخطابة، وما يعتري الخطيب من عيوب كالنحنحة والسعلة، وعلاقة الأسنان بجودة الإلقاء، بالإضافة إلى بحثه في موسيقى الكلام، من تنافر الحروف والألفاظ، إلى فنون السجع وغيره من المحسنات اللفظية.
في رياض الأدب ونفائس الشذرات: يُغني الكتاب بخلاصة وافية من الشذرات المأثورة والخطب البليغة المنتقاة من كلام العرب في العصور الراشدية والأموية والعباسية، ليقدم بذلك بانوراما أدبية متكاملة.
في سجل الأخبار والتاريخ: يحتوي السِفر على كمٍ غزير من الأخبار والقصص التاريخية، فيروي لنا سيرة الخطباء والعلماء والأمراء والكهان والنساء وغيرهم من الشخصيات التي صنعت أحداث التاريخ.
ج- قيمته التاريخية:
يتجلى في هذا السِفر نزوع الجاحظ الجدليّ بوضوح؛ فهو يقف موقف المدافع الصلب، يردّ بحجّة قوية على النزعة الشعوبية، ويُفيض في إيراد شواهد بلاغة العرب وفصاحتهم، واضعاً نفسه في موقع معاكس لتيارات الثورة التجديدية التي كانت سائدة.
ومع هذا الموقف المدافع، فإن كتابه يُعدّ إضافة نوعية تُثري صرح الثقافة العربية الواسعة بدمج عناصر فكرية ثرية من حضارات العالم الأخرى — كاليونانية، والفارسية، والهندية، وغيرها. حتى ليحق لنا القول: إن البيان والتبيين هو مَزْجٌ فريد من ثقافات متغايرة، تصبغها الصبغة العربية الأصيلة بفيض غالب.
إذ يعرض الجاحظ ببراعة آداب العرب والفرس، ويستعرض حكم الهنود، ويورد نصائح مستلهمة من اليهودية والمسيحية. يتناول بالحديث والتحليل مذهب التناسخ، وينقل أقوالاً مأثورة عن داود والمسيح، ويشير إلى عادة الرهبان في اتخاذ العصا. كما لا يغفل عن ذكر كتب الهند في الحكم والأسرار، أو الإشارة إلى منطق اليونان الذي يُستدل به على الخطأ من الصواب، في لوحة معرفية فائقة الاتساع.
د- قيمته الأدبية:
إنّ أسلوب الجاحظ في التأليف يتسم بفيض من العفوية الجارفة، حيث تبدو فصول الكتاب كبحر متلاطم من الأفكار، تتداخل في فوضى بيانية لا تضبطها قاعدة، وتنطلق في استطراد لا يعرف حداً. فكاتبنا لا يرى لوحدة التأليف المعيارية نظماً يُراعى ولا وزناً يُقام له.
ومع ذلك، فإن هذا العمل يمتلك قيمة جوهرية خالدة، منحته منزلة سامية ومكانة خاصة بين أصول فن الأدب وأركانه الثابتة. لدرجة أن العلامة ابن خلدون قد أشار، نقلاً عن شيوخه في مجالس العلم، إلى أن أركان الأدب الأربعة التي يُبنى عليها هذا الفن هي: أدب الكاتب لابن قتيبة، والكامل للمبرد، والبيان والتبيين للجاحظ، والنوادر (أو الشوارد) لأبي علي القالي. وكل ما يأتي بعد هذه الدواوين الأربعة يُعد تابعاً لها وفَرْعاً متأصلاً منها.
هـ - النص الأدبي:
(البيان)
من كتاب" البيان والتبيين"
قال بعض جهابذة الألفاظ، ونقاد المعاني:
المعاني السابحة في الأعماق: جسر البيان واللغة
أصوات الأرواح المعزولة:
إنّ معاني القلوب قائمة في صدور العباد كأسرار، متصوَّرة في لجّة الأذهان كأطياف، ومتجلجلة في خفايا النفوس كصدى بعيد. هي كالكنوز المستورة الخفيّة، تتوارى خلف حجاب المكنون، وتعيش في وجود كالمعدوم، فلا يطّلع عليها بشر. فالإنسان لا يدرك ضمير صاحبه، ولا يتلمس إحساس رفيقه، ولا يستبين غاية شريكه الذي يعاونه على أمور الحياة، إلا بفيض من البيان.
بعث المعاني باللغة:
هذه المعاني السامية، لا تُبعَث حيةً من قبورها إلا عبر ذكر العباد لها، وإخبارهم عنها، واستعمالهم إياها في الحياة. إنما تُحيا تلك الخواطر الكامنة على جسر اللغة.
سحر البيان في الإجلاء:
هذه الخصال اللغوية (الذكر والإخبار والاستعمال) هي التي تُرشد الفهم إلى ضالّته، وتجلو المعاني للعقل كالشمس، فتحوّل الخفي إلى ظاهر مُبين، والغائب إلى شاهد حيّ، والبعيد إلى قريب مألوف. وهي التي تُفصّل الملتبس عن الغموض، وتحلّ العقدة من المنعقد، وتُقيّد المهمل العابر، وتُطلق المقيد من أسره، فتجعل المجهول معروفاً، والوحشي مألوفاً، والعقل يُبصِرُ ما كان مستتراً.
من كتاب الحيوان:
1-الكتاب:
عشق الكتاب ودفاع الجاحظ:
لقد عاش الجاحظ حياته مغموراً في عشق للكتاب لا يُضاهى، فقضى عمره بين المطالعة والتأليف حتى غدت هذه الأسفار جزءاً لا يتجزأ من ذاته، وأصبحت أجلَّ لذّاته وأصفاها. وإنه ليقف الآن مخاطباً من تجاوز النقد الشخصي إلى طعن في قيمة الكتابة ذاتها، مستغرباً تفنّنه في الإنكار: "لم تكتفِ بالطعن على كل كتاب لي بعينه، بل تجاوزت ذلك لتَعيبَ وضع الكتب جملةً، كيفما دارت أحوالها أو تصرفت وجوهها. وقد كنتُ أتعجّب من عيبك البعض بغير علم، حتى عبتَ الكل بغير أساس!"
في وصف الكتاب المعجزة:
ويستطرد الجاحظ مفصلاً في منافع الكتب التي لا تُحصى، واصفاً إياها ببراعة:
"إن الكتاب وعاءٌ قد امتلأ علماً، وظرفٌ حُشِيَ رصانةً، وإناءٌ شُحِنَ بالجدّ والفائدة، فهو يجمع بين المتناقضات بسحر بيانه. إنْ شئتَ، كان أفصح من سحبان وائل (في البلاغة)، وإنْ شئتَ، كان أعيى من باقل (في الصمت). إنْ رغبتَ، أضحكتك نوادره، وإنْ أردتَ، أدهشتك غرائب فرائده. قد يُلهيك بجميل طرائفه، وقد يُشجيك بعميق مواعظه." ثم يختم بتساؤل بلاغي بديع يجمع الأضداد: "ومَن لكَ بـواعظٍ يُلهي، وبـراجزٍ يُعَرّي، وبـناسكٍ فاتك، وبـناطقٍ أخرس، وبـباردٍ حار، سواه؟"
وفي البارد الحار يقول الحسن بن هانئ:
قل لزهير إذا انتحى رشدا *** أقلل أو أكثر فأنت مهذار
سخنت من شدة البرودة حتى *** صرت عندي كأنك النار
ولا يعجب السامعون من صيفَتِي *** كذلك الثلج بارد حار
المرجع:
مراجع عربية في اللغة والأدب والنقد للدكتور علي محمد الفقي (معهد اللغة العربية بمكة المكرمة)، من كتب التراث، مطابع الصفا.