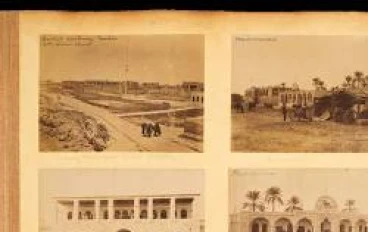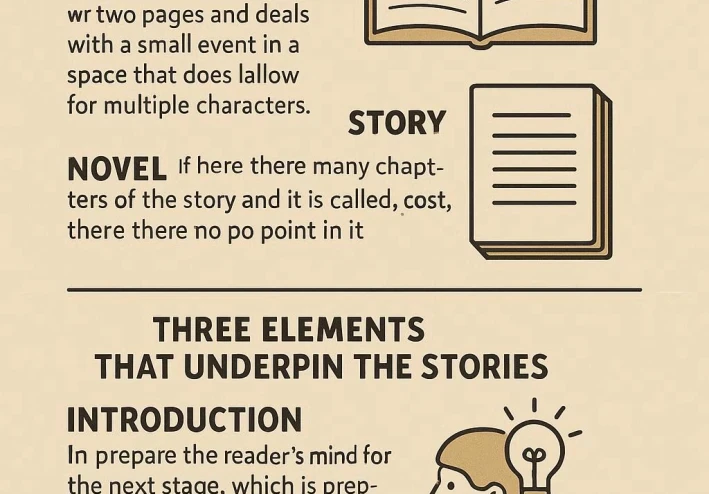
القصة : عبارة عن كتابة فنية يقوم بها شخص واحد، ويقصد فيها إلى تصوير حاله من حالات المجتمع.
أن الفنون الأدبية لا تخضع للتعريفات والضوابط لكونها قابلة للتغير هبوطاً وارتفاعاً ولكونها فنون متجددة.
فالقصة هي عبارة عن كتابة فنية يقوم بها شخص واحد، ويقصد فيها إلى تصوير حاله من حالات المجتمع، ويختلف ميدانها باختلاف ثقافة كاتبها واتجاهه وميله، ولكنها على أي حال تصور موقفاً أو مواقف دينية أو اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو أخلاقية، أو غير ذلك من أحوال الحياة التي لا تحصر.
فالأدب القصصي صورة بالكلام الفني عن أعمال الناس وتصرفاتهم في الحياة، ولكنها صورة ينقل إلينا القصاص خطوطها وأحداثها، ومشاهدها وأبطالها، وما ينفعلون به، ويفعلونه بالسرد والأخبار ينقل إلينا كل ذلك ويحييه ويحبكه فنتمثل الأعمال تمثلاً، نتخيلها من وراء السطور، ونستشف ملامح الوجوه والنفوس من خلال الألفاظ والمقاطع، فلا نراها بأم العين رؤية مباشرة كما هي حالنا مع المسرح.
وأنواع القصة ثلاثة:
1- أقصوصة = قصة قصيرة، وهي ما تكتب في صفحة أو صفحتين وتعالج حدثاً صغيراً في مساحة لا تسمح بتعدد الشخصيات.
2- قصة، وتتكون عادة من فصل واحد.
3- فإذا تعددت فصول القصة وطالت سميت رواية، ويتكلف بعضهم فيحدد هذه الأقسام بعدد الكلمات وعندنا أن هذا تكلف لا جدوى من وراءه.
العناصر التي تقوم عليها القصص ثلاثة:
1- المقدمة: وفيها يهيأ ذهن القارئ للمرحلة الأتية التي يمهد لها بأحداث تكون المرحلة الثانية نتيجة لها.
2- التعقيد: وهي المرحلة التي تشتبك فيها الأحداث وتتأزم المواقف فتنطمس أمام القارئ معالم الحل.
3- الحل: وهو النهاية التي لا تأتي فجأة ودفعة واحد، بل يمهد لها بأمور توميء ولا توضح وتشير ولا تفصح، لكي لا يصل القارئ إلى الحل مباشرة فيبرد شوقه وتفتر عزيمته.
أن أصول القصة قديمة في الأدب العربي حتى في أسلوب الحوار الذي هو من خصائص الفن المسرحي الآن. ومن ذلك حكاية الضب مع الأرنب والثعلب، وكثر ما روى من ذلك في الأدب العربي مما ذخرت به كتب التراث مثل كتاب الأغاني وكتب الجاحظ وما ماثلها.
وترجم إلى العربية من ذلك ما ترجم مثل كليلة ودمنة، وألف ليلة وليلة وابتكر فيها مثل تغريبه بني هلال وما شا كلها.
وأن أصول القصة العربية متمثلة في المقامات، مثل مقامات الحريري ومقامات البديع.
وحين جاء العصر الحديث أتجه عشاق الفن القصصي إلى محاكاة المقامات، فكتبوا في ذلك كثيرا مثل حديث عيسى بن هشام لمحمد المويلحي، ومثل ما كتب البكري ووجدي وأمثالهما، ثم كانت محاولات عبدالله النديم التي كان ينشرها في مجلته الساخرة (التبكيت والتنكيت).
فلقد أخذ في تصوير المشكلات الاجتماعية التي تفشت في المجتمع المصري عقب اتصاله بالغرب تصويراً يدنوا إلى حد ما من الفن القصصي ويهدف إلى الإصلاح والإرشاد والتوجيه، حيث يسوق الحكاية معقباً عليها بعد نهايتها بموعظة تكون بالتنبيه أو لفت الأنظار لما آل إليه حال بطل الحكاية مما يستحق التحذير منه أو الترغيب فيه، وهي قصص طريفة عدها محمد حمزة بوقي بداية للقصة القصيرة، ومن عناوين قصص نديم هذه (خذ من عبدالله واتكل على الله) (زعيط ومعيط) (عربي تفرنج).
وكثرت القصص المترجمة إلى العربية، وأقبل الأدباء عليه إقبالاً منقطع النظير، فاتجه كتاب القصة يستوحون ما فيه من قص وحكاييات فنشط هذا النوع من القصص الذي يروى ما ورد في القرآن الكريم وفي التاريخ الإسلامي من قصص وحكايات مثل قصة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة الفيل وقصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع المرأة الفقيرة وصبيتها، ونحو ذلك من القصص وكان هذا الإتجاه القصصي يساير الإتجاه الإسلامي الذي شاع في مصر في مطلع القرن الرابع عشر الهجري، والذي كان يعلق على الخلافة العثمانية الآمال في إعادة أمجاد الإسلام. ثم دخلت القصة العربية في طور جديد أخذت فيه شكلاً فنياً واضحا محدداً يمكن أن يطلق عليه بداية القصة الحديثة.
وأول عمل من هذا القبيل قصة (في وادي الهموم) التي كتبها محمد لطفي جمعة طبعت عام 1223هـ بمطبعة النيل، ثم تبعتها قصة (زينب) للدكتور محمد هيكل طبعت عام 1331هـ.
وكان الشاميون أول من بدأ كتابة القصة لتأثرهم بالأدب الغربي من طريق مدارسهم ومترجماتهم، غير أنهم حين كتبوا في القصة لم يستطيعوا المواءمة بينها وبين البيئة العربية الإسلامية، بل جعلوا قصصهم تدور في جملتها على الجنس والجريمة، وكان الصراع فيها يدور بين الخير والشر، كما كان الحل فيها شبه معروف وهو انتصار الفضيلة على الرذيلة.
وأقبل كثير من أدباء العربية على ترجمة أعمال الغربيين وأكثروا من ترجمة القصص والروايات ومن هؤلاء المترجمين:
جورجي زيدان ونجيب حداد والدكتور أحمد زكي وأحمد حسن الزيات والدكتور طه حسين..
وكان طابع مترجمات هؤلاء أنها تدعو للفضيلة وأن شابها بعض الشوائب التي أتى العرب – فيما بعد – في قصصهم بأكثر منها تطرفاً.
وأشهر هؤلاء وأقومهم أسلوباً وأكثرهم عناية بالأخلاق المنفلوطي، وكانت تترجم له القصص بلغة واهنة فتناولها كالمادة الخام ليخرج منها – بحذقه ومهارته- قطعة فنية رائعة.
واقرأ إن شئت (الفضيلة) أو (الشاعر) أو (مجدولين) أو (قصصه المترجمة وغير المترجمة ) في كتابي (العبرات) و(النظرات) على أنهم يأخذون على المنفلوطي جنوحه للنهايات المآسموية فكثيراً ما انتهت القصة بموت الأبطال أو بعضهم ويرجعون ذلك إلى نفسية المنفلوطي التي انطبعت بالبؤس والشقاء في أول حياته فآملت عليه هذه النزعة.
وصحب الفن القصصي لدى بعض القاصين كثير من التبذل وعدم الاكتراث بما تجره أعماله القصصية من ترويج للجنس والجريمة فحاول أحمد مختار الحنبلي أحد رجال الأزهر أن يوجه إلى إمكان تخليص الفن القصصي من هذا الداء فأخرج في منتصف القرن الرابع عشر الهجري مجموعته الأولى التي قال عنها هو في مقدمتها (دعانا إلى كتابتها ما رأينا من فوضى الروايات الخليعة والبذيئة التي تغش المجالس والمدارس والمنازل).
ومن المكثرين في ذلك جورجي زيدان في (روايات تاريخ الإسلام وكانت أقرب إلى الحبكة التاريخية منها إلى التصوير القصصي ولعل من أهدافه فيهاتشويه تاريخ الإسلام من طريق جعل الجنس منطلق لبطولات زعماء الإسلام وأبطال الفتوح.
ومن الروائيين المجيدين توفيق الحكيم في مثل رواياته (أهل الكهف).
وعلى أساس من القصة الاجتماعية التي بدأ هيكل خيطها نسج الأدباء المعاصرون فأخرج طه حسين – الأيام ودعاء الكروان وشجرة البؤس وشهر زاد المعروفة في ألف ليلة وليلة ، وذلك حين أحسوا بالنقص ذلك الجانب الاجتماعي والإنساني، وآخرون مثل المازني والعقاد عنوا أكثر ما عنوا بالجانب النفسي وهو القدر الذي نلحظه عند المازني في قصة إبراهيم الكاتب وعود على بدء ونلحظ مثل ذلك عند العقاد في قصة (سارة).
أما كتاب القصة المتأخرون فإنهم لا يزالون يؤثرون الجانب الاجتماعي الذي اتجه إليه هيكل وطه حسين، وفي مقدمة هؤلاء القصاص توفيق الحكيم ومحمود تيمور، ونجيب محفوظ.
ويأتي عمل الكاتب محمد تيمور في قصصه أقرب إلى مفهوم القصة الحديثة وهو يعني عناية جيدة بمعالجة الأمراض الاجتماعية – كالمنفلوطي من قبله – وذلك لظهور تلك الأمراض في المتجمع المصري إذ ذاك على نحو لم يعهده ذلك المجتمع ويعد محمد تيمور أول من أخرج القصة القصيرة المكتملة فنياً ثم تبعه على ذلك الطريق كتاب القصة القصيرة. ومنهم محمود تيمور، ومحمد عبدالحليم عبدالله وأمين يوسف غراب ووداد سكاكيني ومحمد سعيد العريان ومحمد لبيب البوهي وثروت إباظة ورستم كيلاني.
وكان لقصص الأطفال نصيبها من عناية الأدباء وأشهر من نجح في ذلك وأكثر كامل الكيلاني.
ويعد محمود طاهر لاشين أول من جعل للعامية نفوذاً في قصصه، وبذلك يكون فتح الباب لاستعمال العامية في الأعمال القصصية حتى شاع ذلك في زماننا هذا، وصار كتاب القصص لا يتحرجون من استعمالها في أعمالهم بل نادى بذلك كثيرون منهم بدعوى التيسير والتقريب لعامة الناس، وهذا باطل يسهم في حرب اللغة العربية وليس له عائد اجتماعي أو فكري.