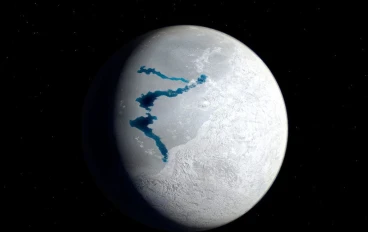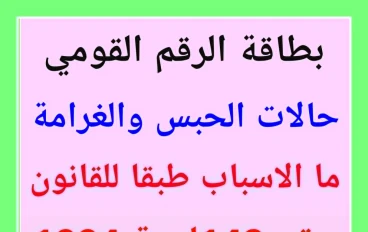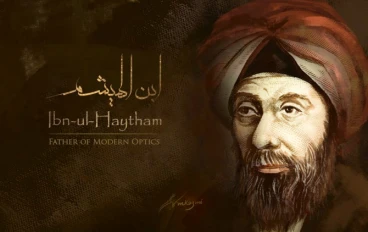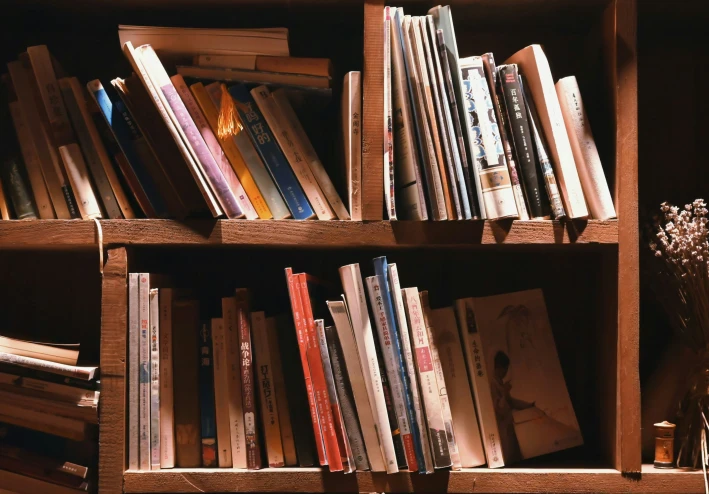
التركيب والبناء في العربية
التركيب والبناء في العربية
ذكر المستشرق الألماني Brockelmann في دراسته المطولة المقارنة في اللغات السامية، وهو: أن ليس في اللغات السامية إدغام للكلمات . ولا يريد با لإدغام في مقالته ما أراده النحويون في هذا المصطلح الذي أفردوا له بحثا طويلاً مسهباً في كتبهم. وإنما يريد به وصل كلمة بأخرى بحيث يتكون منهما كلمة واحدة ذات معنى مؤلف من معنى الكلمتين المستقلتين.
ولعله أصاب لو استعمل " التركيب" مصطلحاً لغوياً لما أسماه بالإدغام. وكأنه أحس أن في العربية شيئا كثيرا من المركبات، وهذا الشيء الكثير يفسد عليه رأيه، فاستدرك أن التركيب غير قديم في اللغات السامية، وأن هذه اللغات كانت خالية مما أسماه " بالإدغام" في عصورها القديمة، وليس من حجة علمية تاريخية تثبت صحة هذه الدعوى.
والذي ثبت في التحقيق العلمي أن في العربية تراكيب كثيرة، وأنها استفادت من التركيب لتكثير المعاني والمباني. وقد اعتمد " البناء" في العربية على التركيب بصوره المختلفة ولعل من المفيد أن ننبه إننا لم نرد " بالبناء" المصطلح النحوي الذي يقابل الإعراب، وإنما أردنا به بنية الكلمة Structure.
ويدخل التركيب في بنية كل من الاسم والفعل والحرف، ولعل التركيب في الحروف يشير إلى قدم هذه الوسيلة في العربية، وسنعرض للأدوات التي أفادت من التركيب على مر العصور وكر الدهور، فلزمت صورتها المعروفة والتي ورثتها العربية واستعملتها وكأنها كلمات مستقلة. ولو نظر الباحث في هذه الكلمات لوجدها مركبات استفادت من التركيب، ولا سيما في صورتها المنحوتة، والنحت لون من ألوان التركيب في العربية خضعت له الحروف والأسماء. وكان مذهب الخليل بن أحمد الفراهيدي : " أن الكلمتين إذا ركبتا، ولكل منهما معنى وحكم، أصبح لهما بالتركيب حكم جديد". وتبع الخليل في مقالته جمهور الكوفيين، ومنهم الكسائي والفراء، وليس كما رأى الأستاذ طه الراوي من: أن الخليل قد شذ عن جمهرة النحاة في رأيه في الأدوات المنحوتة . ولنا أن نعرض للأدوات التي دخلها التركيب على طريقة النحت فلزمت صورتها المعروفة الموروثة:
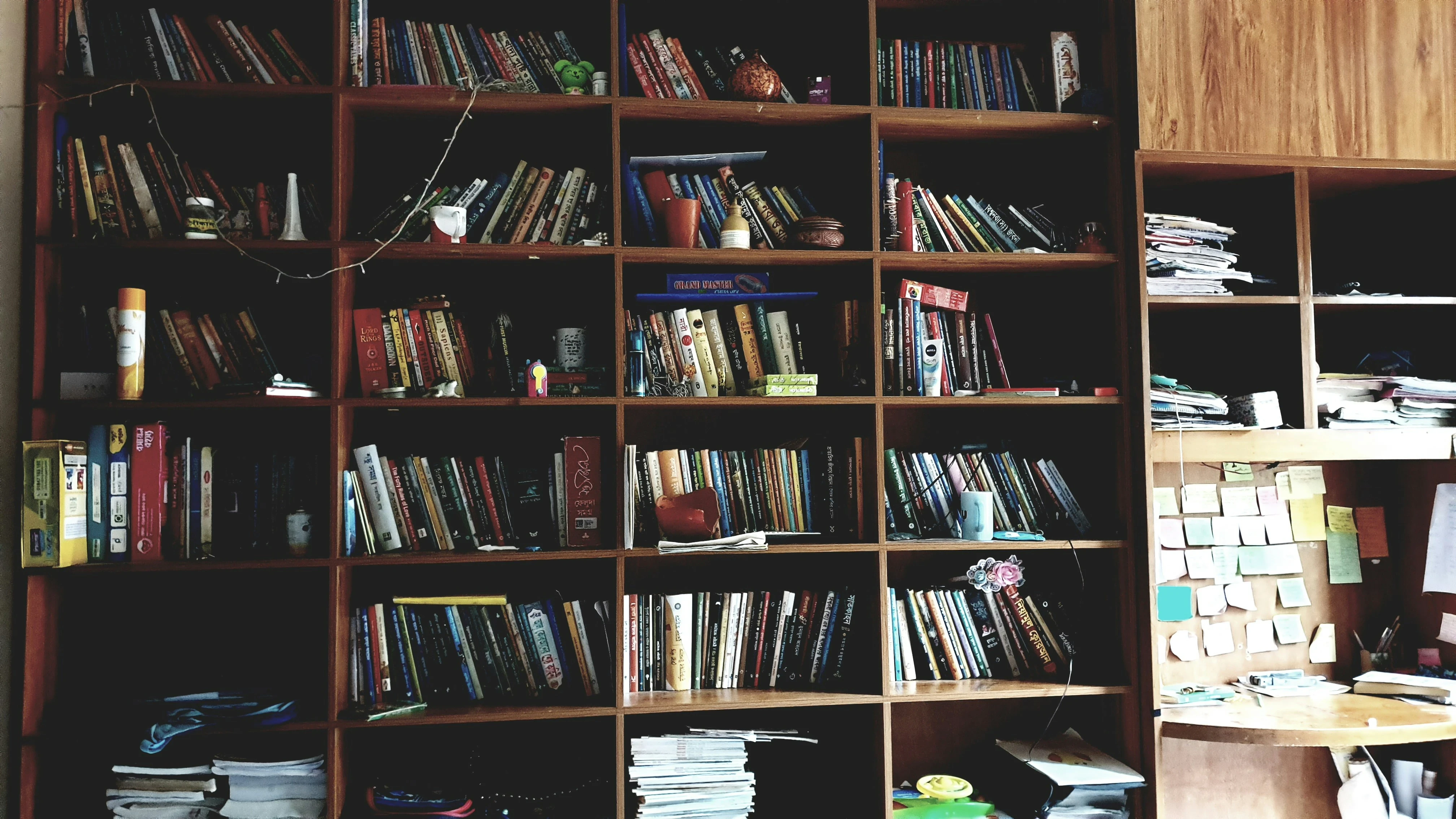
1-لن:
وهي مركبة عند الكسائي من الكوفيين وحده، وعنده أنها مركبة من " لا" و" أن" وحذفت الهمزة تخفيفاً، والألف للساكنين. وقول الكسائي في " لن" هو قول الخليل وهو صاحب الرأي فيه، جاء في كتاب سيبويه:
فأما الخليل فزعم أنها " لا أن" ولكنهم حذفوا لكثرته في كلامهم، كما قالوا: ويلمه، يريدون وي لامه وكما قالوا يومئذٍ، وجعلت بمنزلة حرف واحد.
وعن الأزهري: أنه " حكى هشام عن الكسائي مثل هذا القول الشاذ عن الخليل". على أن جمهور البصريين يرد هذه المقالة ويقول بعدم تركيب " لن" وأنها: حرف بسيط برأسه وهو مذهب سيبويه لأن الأصل في الحروف عدم التصرف. وليس أصله" لا" فأبدلت الألف نوناً كما ذهب جماعة من اللغويين.
فذهب الفراء مثلا إلى أن أصل " لن" و" لم" لا فأبدلت الألف نوناً في أحدهما وميماً في الآخر.
وما دام القدامى قد قربوا بين " لن" و" لم" فلا بد لنا من النظر فيها والقول بتركيبها وإن لم ينص عليه متقدم من اللغويين والنحويين وقد قال بهذا المستشرق الألماني " برجشتراسر" فزعم: أن أصل النفي في العربية أن يكون بلا وما، وإن العربية قد اشتقت من " لا" أدوات منها: ليس، ولن، ولم، وقال:" لن مركبة من " لا" و" أن" ولم " ربما كانت مركبة من " لا" و" ما" الزائدة".
وقال في مكان آخر حينن عرض لحروف العطف: " ثم" خاصة بالعربية ويظهر أنها مشتقة من " ثم" المقابلة لـ Sam العبرية، وtamman الآرامية، و" أو" سامية الأصل، و" أم" حديثة عربية، وأصلها: أما، كما أن" لم" أصلها " Lama" و" كم" أصلها " ka-ma" . والذي رأيته أن النحويين المتقدمين لم يقولوا بالتركيب وردوا هذا الرأي إلى الخليل والكسائي، أما المتـأخرون فقد قالوا بالتركيب ولا سيما اللغويين منهم، ومن هؤلاء ابن جني في سر صناعة الإعراب.
2-كأن:
وهي مركبة من الكاف و(أن) فأصل قولهم كأن زيداً عمرو، إنما هو: أن زيداً كعمرو، فالكاف هنا تشبيه صريح وهي متعلقة بمحذوف . ثم إنهم أرادوا الاهتمام بالتشبيه الذي عليه عقدوا الجملة، فأزالوا الكاف من وسطها وقدموها إلى أولها لإفراط عنايتهم بالتشبيه ولأجل تقديم الكاف ففتحوا همزة " أن".
ويلتزم ابن جني قاعدة التركيب ويرفض ما عداها، فهو يذكر رأي الخليل في " لن" وتركيبها ويقول به ويعقب عليه بقوله:" فهذا يدلك أن الشيئين إذا خلطا حدث لهما حكم ومعنى لم يكن لهما قبل أن يمتزجا . إلا نرى أن لولا مركبة من " لو" و" لا" ومعنى " لو" امتناع الشيء لامتناع غيره، ومعنى "لا" النفي أو النهي. فلما ركبا معا حدث معنى آخر وهو امتناع الشيء لوقوع غيره.
فهذا في " لن" بمنزلة قولنا كأن ومصحح له ومؤنس به وراد على سيبويه ما ألزمه الخليل".
3-لكنَّ:
اختلف فيها النحويون فهي بسيطة عند البصريين. وهي مركبة عند الفراء من الكوفيين مِنْ " لكنْ" و" أنْ" فطرحت الهمزة للتخفيف، ونون لكن للساكنين كقوله:
" ولاك اسقني إن كان ماؤك ذا فضل". وهذا علة نصبها الاسم عنده .
ويرى غير الفراء من أهل الكوفففة إنها مركبة من " لا" و" أن" و" الكاف الزائدة لا التشبيهية وحذفت الهمزة تخفيفاً".
ولعل السبب في اختلاف رأيهم في هذه المواد يرجع إلى أنهم لم يستكملوا أدوات البحث اللغوي في اللغة العربية وذلك يقتضيهم النظر في اللغات السامية الأخرى ليستطيعوا أن يقطعوا برأي علمي أصيل. ذلك أن النظر في العبرية يهدي الباحث إلى القول بتركيب هذه المادة من " لا" و" كن" التي تعني في العبرية " هكذا". وبهذا قال" برجشتراسر" في محاضراته الموسومة بالتطور النحوي للغة العربية.
وقول بعض الكوفيين بتركيبها من " لا" والأحرف الزائدة الأخرى أقرب إلى الصواب وأهدى إلى الطريق الصحيح الذي توصل إليه بالفطنة والنظر السديد.
4-ليس:
يرى الخليل أنها مركبة من لا ايس فطرحت الهمزة والزمت اللام بالياء.
وهو قول الفراء أيضاً والدليل على ذلك قول العرب:" اثنتي به من حيث ايس وليس أي من حيث هو ولا هو".
أما غير الخليل من البصريين فقالوا بخلاففه. فهي عند ابن السراج حرف بمنزلة " ما" وإلى ذلك ذهب أبو علي الفارسي وابن شقير وغيرهم. والقول بفعليتها واسميتها كثير، قال ابن سيدة:" ليس كلمة نفي وهي فعل ماض وأصلها لِيس بكسر الياء".
وذهب ابن هشام إلى أنها فعل لا يتصرف، وزنه فعل بالكسر، ثم التزم تخفيفه ولم نقدره فعل بالفتح لأنه لا يخفف ولا فعل بالضم، لأنه لم يوجد في يائي العين".
وقول العرب " اثنتي به من حيث ايس وليس" مفيد في هذا الباب، ذلك أن " ايس" يعني الوجود و" ليس" يعني عدم الوجود.
والنظر في اللغات السامية يدل على هذا، فالمادة " يش" في العبرية تفيد الوجود والمادة" ايث" في الآرامية تفيد الوجود وقد ركبت " لا" مع هذه المادة التي تفيد الوجود. وإلى هذا ذهب برجشتراسر في بحثه.
ولو رجعنا إلى العبرية وقصرنا عليها البحث دون النظر في اللغات السامية لوجدنا فيها ما يؤيد القول بتركيب " ليس" من" لا" و" ايس" فقولهم" ايس" للدلالة على الوجود يقابله في العربية مادة " شيء" وهي مقلوب لكلمة" ايش" السامية، والتي وجدت في العبرية مؤيدة هذا المعنى، والتي تحجرت في العربية في جمل معدودة مقيدة في معجمات اللغة في قولهم" ايس". فكأن " ليس" " لا ايس" أي أنها من" لا ايش" ومعناها " لا شيء" ثم قوي التركيب على طريقة النحت فصارت ليس.
5-لات:
ولا بد للباحث في " ليس" أن يعرض لـ " لات" وهي أداة من أدوات النفي ألحقت بليس وعملت عملها وقيدت بشروط.
وقد علل النحويون التاء في هذه الأداة فقال جماعة أنها للتأنيث، وقال آخرون أنها للمبالغة، وفاتهم أنها مركبة ولم يفطنوا إلى تركيبها. وهي لا تختلف عن ليس. وربما كانت " لا ايث" فصارت في العربية " لا ايت" ثم استفادت من النحت فصارت " لات".
6-لهنك:
ذهب الفراء إلى أنها منحوتة وأن أصلها :" والله أنك كما روى عن أبي أدهم الكلابي: له ربي لأقول ذلك. بقصر اللام ثم حذف حرف الجر كما يقال: الله لافعلن، وحذفت لام التعريف أيضا كما يقال: لاه أبوك أي لله أبوك. ثم حذف ألف " فعال" كما يحذف من الممدود إذا قصر كما يقال: الحصاد والحصد، قال:
إلا لا بارك الله في سهيل *** إذا ما الله بارك في الرجالِ
ثم حذفت همزة انك".
ولم يقل سيبويه بتركيبها. وقد ذهب إلى أنها ككلمة تكلم بها العرب في حال اليمين، وليس كل العرب تتكلم بها.
وعن سيبويه تقول العرب: لهنك لرجل صدق. يريدون."ان" ولكنهم أبدلوا الهاء مكان الألف، وروى ابن فارس قول الشاعر:
لهنك من عبيسة لوسيمة *** على هنوات كاذب من يقولها
وقد قال الفراء بتركيب كثير من الأدوات " فمنذ" مركبة عنده من " من" و" ذو" وحذفوا الواو تخفيفاً، و" هلم" عنده مركبة من " هل ام" أي أقصد فخففت الهمزة بأن ألقيت حركتها على اللام وحذفت فصارت: هلم.
7-مهما:
هي مركبة عند الكوفيين من " مَه اسم فعل بمعنى اكفف زيد عليها "ما" الشرطية زيد عليها"ما" فثَقُل اجتماعهما فأبدلت الأولى هاءً.
8-مهمن:
هي أداة كوفية أضافها الكوفيون إلى أدوات الجزم واحتجوا بقول الشاعر:
أماويّ مهمن يستمع في صديقه *** أقاويل هذا الناس ماويّ يندمُ
وهي مؤلفة من (مه) و(من) وتركيبها كتركيب " مهما" ولم يقل بها البصريون. ودخل التركيب في الأسماء، والمركبات من الأسماء معروفة في كل زمان، وقد أفادت منها العربية في تكثير المعاني. وفي العربية قدرة على الاستفادة من هذا النوع، وهي دائمة الاستفادة منه. وربما وجدنا في اللهجات الدارجة الشيء الكثير من هذه المركبات. وللمجاورة والاتباع في العربية أثر في ذلك.
والمركبات على ضربين: ضرب يقتضي تركيبه أن يبنى الاسمان معاً، وضرب لا يقتضي تركيبه إلا بناء الأول. فمن الضرب الأول نحو العشرة وما نيّف عليها، إلا اثني عشر، ونحو قولهم في وقع في " حيصَ بيصَ" ولقيته " كفةَ كفةَ "، و" صحرةَ بحرةَ" ، وهو جاري ( بيتَ بيتَ) ، ووقع (بينَ بينَ) وآتيك (صباحَ مساءَ) و(يومَ يومَ)، وتفرقوا (شغر بَغَرَ) و(شذرَ مذرً) و(خِذع مِذع) وتركوا البلاد ( حيث بيث) و(حاث باث) ومنه (الخازِ بازِ).
والضرب الثاني نحو قولهم افعل هذا بادي بدي وذهبوا أيدي سبا، ونحو معدي يكرب وبعلبك وقالي قلا.
والذي يلاحظ في هذا الباب أن العربية حين بنت جزئي المركب اختارت الفتح التماساً للخفة، والخفة متطلبة في هذا الباب ذلك أن المركب كلمة طويلة ثقيلة. ومع هذا فقد جوز الفراء إعراب العدد المركب.
ولقد جد في العربية مركبات منحوتة اقتضاها الدين الإسلامي الحنيف، وهذه المنحوتات أبنية نُحِتَ كل منها من كلمتين أو أكثر، كالبسملة، والحمدلة، والحولقة، أو الحوقلة، والهبيللة، والحسبلة، والحيعلة، والسمعلة، فإنها منحوتة من: :بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، ولا إله إلا الله، وحسبي الله، وحي على الصلاة، وسمع الله لمن حمده. وقد اشتق من هذه المنحوتات أفعال رباعية فقيل: بسمل وحمدل وحيعَل ...
وذهب ابن فارس إلى أن أكثر الأبنية التي تزيد أصولها عن ثلاثة منحوتة عن كلمتين مثل قول العرب للرجل الشديد: ضبطر، من ضبط وضبر، وفي قولهم صهصلق، من صهل وصلق، وفي الصلدم أنه من الصلد والصدم.
وربما كان في الصلدم قول غير هذا فهو صلد ذُيّل بالميم خدمة للتمييم مقابلة للتنوين. ومن المركبات المنحوتة قولهم" ايش" يريدون به أي شيء، فقد نص عليه ابن السيد في شرح أدب الكاتب وصرحوا بأنه سمع من العرب. وقد وقع في شعر قديم: من آل قحطان وآل ايش. وقد استخدمت النون في بناء الرباعي من الأسماء فقيل ضيفن، وهرشن، وشدقن، ورعشن، كما استفيد من الميم فقيل خضرم وصلدم.
وقد دخل النحت في الأفعال غير الثلاثية فالرباعي دحرج مؤلف من " دَحَرَ" و" دَرَجَ" . وقد ذهب هذا المذهب ابن فارس.
وقد ذهب الزمخشري في الكشاف إلى أن قرضب آتٍ من " قرض" و" قضب".
وبناء الرباعي في العربية جاء بطرق عدة منها:
1- إضافة ميم ذيلاً أو كسعاً Suffite كقولنا حرجم.
2- الاستفادة من التنوين كما في ضامن وتضامن والأصل هو تضام.
3- الاستفادة من فك الإدغام في المضعف والتعويض من الحرف الأول المضعف حرفاً آخر هو النون مثلاً كقولهم: جندل وهو من جدّل، قنطر وهو من قطرّ، وفك الإدغام والتعويض بالنون شهير في العربية، فضمير المخاطب المنفصل أنت وأخواته هو " ات" في سائر اللغات السامية. وقد ورد الإدغام وفك الإدغام في ألفاظ كثيرة مثل قبّرة قنبرة.
وكقولهم حنجرة وسنبلة ودمّلة، ولعل فك الإدغام هو الذي جاء بالفعل " انطى" وهو من أتىّ بمعنى أعطى. جاء في الآية الكريمة :" وأتى المال على حبه" ثم حدث إبدال بين التاء والطاء. ولهذا فقول القدامى" باستنطاء بكرك" لا أساس له، فهو من هذا الباب وليس الاستنطاء مقيداً ببكر دون غيرهم، والدليل وجود الكلمة حية في سائر أقطار العربية.
وقد يعوض بالهاء:" فجمر" تصبح" جمهرَ" وهو من" جمّ".
4-الاستفادة من الميم صدراً في الفعل Prefixe كقولهم مَسخر ومَشدَق.
5-الاستفادة من الشين كسعا في الفعل كقولهم في اللسان الدارج " حركش" وهو لم يصبح فصيحاً بعد. والشين التي تذيل الأفعال مقتطعة من " شيء" فقول العامي" دكَشن" يريد به دق شيئاً. وكقولهم" لا شي" و" يلاشي" وهو مركب منحوت من " لا" شيء".
6-وربما خرج العامي من الشين إلى الجيم لفائدة معنوية، فقوله" صخرج" إثبات لما فيه قوة الصخر وطبيعته، ومنه " صفرج" إثبات لما فيه شيء من الصفرة.