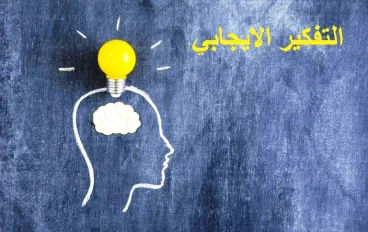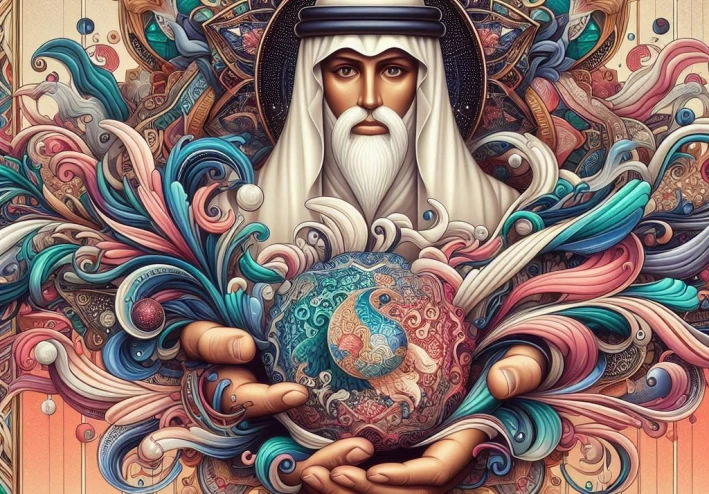
البلاغة العربية تتمثل أولاً وأخيراً في النصوص المكتوبة، أو الملفوظة وحدها.
هذا البيان الساحر الذي نتلوه قرآنا، وذاك القول الزائع الذي نعجب له ونطرب، وتلك الوردة الأنيقة التي تلفنا بهالة من العطر والشَّذا ... ما الذي جعلها تمتاز عن سواها؟ أليس فيها شيء فضلها على غيرها، بل أليس في تركيبنا النفسي والعقلي والجسدي ما شدنا إلى الإعجاب بها، والانجذاب إليها؟
أولسنا في مرةٍ نرى أنفسنا متحمسين لقصيدة شعرية معينة، أو قطعة موسيقية، أو أنشودة غنائية، أو لون من الألوان، فنفضلها على سواها، ثم نرى في الوقت ذاته إنساناً آخر، لم يذهب مذهبنا، فلم يتحمس لما تحمسنا، ولم يطرب لما طربنا، ولم يعجب بما أعجبنا؛ وإنما حماسته، وطربه، وإعجابه سارت في غير طريق، وتوجهت إلى غير سبيل؟
ذلك سر هذا الكون، وعبقرية هذا الخلق .. اختلاف في المشارب والطبائع والنفوس والأهواءن وتباين في الأذواق والمواهب والمذاهب، لتستمر حركة الحياة، ولتعمر بناية الكون، ولتأخذ الحياة مجراها؛ ويكون للعقول والقلوب أثرها وقيمتها ورجحانها.
وكيف نقول عن ميولنا التي اختلفت بين صبانا وشبابنا؟ وماذا نحكم على آرائنا التي تبدلت من زمن إلى زمن؟ وبم نحتج على أذواقنا التي تباينت من سن إلى سن؟ ثم ألا يمكن الآخرين أن يحكموا لأنفسهم بمثل ما حكمنا لأنفسنا، وأن يدعوا أن حكمهم هو الأقوم والأرجح والأصوب؟
إذن ! ما السبيل إلى تبين الحق، وتمييز الرشاد، والحكم بالعدل والقسطاس المستقيم؟
يقول بعض العلماء: إنا في مثل هذه الأحوال نحتكم إلى الذوق، وبه نهتدي إلى سواء السبيل؛ وبالذوق نتمكن من تمييز الحق وغير الحق، والصواب وغير الصواب، والملائم وغير الملائم، على أن يكون هذا الذوق المرجح سليماً.
هذا العلم الذي نسعى إلى تعرفه هو " البلاغة" أو فن القول البديع.
والبلاغة، أو التعبير الفني الجميل، ليست قاصرة على الأمة العربية دون سواها من الأمم، وإنما هي قاسم مشترك بين سائر الأمم وشعوب الدنيا .. كل منها له بلاغته، وله تعبيره الفني الجميل، وقد تختلف مقاييس هذه البلاغة بين أمة وأخرى، وعصر وعصر، ولكن تبقى عناصر مشتركة بينها جميعاً، منها الجمال، والذوق، والفن، والصدق، والأناقة، وصحة التعبير.
في تعريف البلاغة:
البلاغة العربية تتمثل أولاً وأخيراً في النصوص المكتوبة، أو الملفوظة وحدها.
ونختلف رأياً وما رُوِيَ على لسان ابن المقفع حين سُئل عن البلاغة، فأجاب: " البلاغة اسم يجري في وجوه كثيرة، منها ما يكون في السكوت، ومنها ما يكون في الاستماع، ومنها ما يكون شعراً، ومنها ما يكون سجعاً، ومنها ما يكون خطباً، وربما كانت رسائل، فعامة ما يكون من هذه الأبواب فالوحي فيها، والإشارة إلى المعنى أبلغ، والإيجاز هو البلاغة".
كذلك نختلف وما جاء به ابن المعتز من أن " البلاغة هي البلوغ إلى المعنى، ولما يطُلْ سفرُ الكلام".
ونخالف الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي عرف البلاغة بأنها :" ما قرُب طرفاه، وبَعُد منتهاه".
السكوت بلاغة، والاستماع بلاغة، والإيجاز بلاغة ... إنا إذا أخذنا بهذه الأحكام جاز لنا أن نقول قياساً: المشيءُ بلاغة، والأكلُ بلاغة، والشرب بلاغة، والضحك بلاغة، والصفير بلاغة، في بعض الحالات .. أبداً ليس هذا بصحيح، إنا نستطيع أن ندعو تلك التصرفات " تكيُّفاً" مع الموقف، أو " تلاؤماً" مع الظرف، ونستطيع أن نطلق عليها أيّ اسم، أو أي صفة، ولكن لا يمكننا أن نسميها " بلاغة".
والإيجاز كذلك.. إنه ما دام ينسرب في الكلام المحكيّ، أو المكتوب، فقد يكون من البلاغة حيناً، ومن غير البلاغة حيناً آخر.. وقد يكون الموجزُ مصيباً في موقف، وغير مصيب في موقف آخر.
عبثاً إذا أن نقول: السكوت بلاغة، والاستماع بلاغة، والإيجاز بلاغة، وأمثال هذه الأقوال، لأن للظروف أحكامها، وللمواقف متطلباتها. والبلاغة الحق، إضافة إلى كونها الكلام المكتوب، أو المسموع، هي التي تقدر الظروف، والمواقف، وتعطي كل ذي حق حقه، سواء أكانت شعراً أم نثراً، مقالاً أم قصة، مسرحية أم حكاية، مديحاً أم هجاء، غزلاً أم استعطافاً.
البلاغة بين اللفظ والمعنى:
وما دامت البلاغة مقصورة على الحديث المكتوب أو المسموع، فأين تكون من هذا الحديث، أتقع في ألفاظه أم في معانيه ؟
لقد اختلف العلماء قديما وحديثاً في موقعها، وانقسموا شيعاً وأحزاباً، فمنهم من انحاز إلى جانب اللفظ، ومنه من انحاز إلى جانب المعنى، ومنهم من رأى بينهما صلة لا يمكن فصلها.
مدرسة اللفظ:
ويبدو أن مطلع العصر العباسي، وما رافقه من أفكار واتجاهات أول من مال إلى جانب ترجيح جانب الألفاظ، والعناية بالشكل والمظهر. ومدرسة مُسلم بن الوليد خير شاهد.
ثم جاء الجاحظ، وقال كلمته المشهورة:" المعاني مطروحة في الطريق ، يعرفها العجمي والعربي، والبدوي والقروي، وإنما الشأن في إقامة الوزن، وتخير اللفظ، وسهولة المخرج، وكثرة الماء، وفي صحة الطبع، وجودة السبك".
وتتابع العلماء بعد الجاحظ، يكررون قوله، ويؤكدون رأيه، ويرجحون جانب اللفظ، ويعدونه العنصر الأهم في التعبير الجميل. قال أبو هلال العسكري في كتاب" الصناعتين": " وليس الشأن في إيراد المعاني، لأن المعاني يعرفها العربي والعجمي، والقروي والبدوي، وإنما هو في جودة اللفظ وصفائه، وكثرة طلاوته ومائه، مع صحة السبك والتركيب، والخلو من أود النظم والتأليف، وليس يُطلب من المعنى إلا أن يكون صواباً".
وسار ابن خلدون في هذا الاتجاه، فقد كان يرى أن الأصل في صناعة النظم والنثر إنما هو للفظ، والمعاني تابعة للفظ " لأن المعاني موجودة عند كل واحد، وفي طوق كل فكر منها ما يشاء ويرضى، فلا تحتاج إلى صناعة". ويورد تشبيهاً على ذلك ماء البحر، فقد يغترف بآنية الذهب والفضة والصدف والزجاج والخزف، بينما الماء واحد في نفسه، وإنما الاختلاف قائم بين الأواني.
وكان أحمد حسن الزيات من المعاصرين ميالاً إلى ترجيح جانب اللفظ. ومن أقواله:" والحق أن أظهر الدلالات في مفهوم البلاغة هي أناقة الديباجة، ووثاقة السرد، ونصاعة الإيجاز، وبراعة الصنعة؛ فإذا كان مع كل ذلك المعنى البكرُ، والشعور الصادق، كان الإعجاز. وليس أدل على أن الشأن الأول في البلاغة إنما هو لرونق اللفظ، وبراعة التركيب، من أن المعنى المبذول أو المرذول أو التافه قد يتسم بالجمال، ويظفر بالخلود، إذا جاد سبكه، وحسن معرضه..
وتأمل قول ابن سناء الملك في ممدوحه:
مُكمَّلٌ، وسواهُ ناقصٌ أبداً *** كأنه " كان" قد جاءت بلا خبر
غزا، وطالت مغازيه، وقد غُزِيت *** صلاتهُ حين طال الغزوُ بالقصرِ
الشاعر يحشو في جو المديح ألفاظ العلوم، ولا يرى أمامه إلا " كان" حين تنتقل من النقصان في رفع المبتدأ ونصب الخبر إلى التمام حين تكتفي بفاعل، وكأن هذا العمل في نظره شبيه لممدوحه الموصوف بالتمام والكمال. وكذلك فإنه أراد أن يقول شيئاً ما عن حروبه الطويلة، فلم يجد أمامه إلا مقارنتها بصلاته التي صارت مقصورة لانشغاله بحروبه وغزواته.. أفليس في هذا التعبير والتشبيه تفاهة ما بعدها تفاهة، وانحطاط في وادٍ سحيق من سفساف الكلام الرخيض؟
مدرسة المعنى:
أما الفرق الثاني الذي انحاز إلى جانب المعنى فنجده ممثلاً في رأي ابن جني في كتابه" الخصائص"، وفي بعض عبارات الشريف الرضي في كتابه" تلخيص البيان في مجازات القرآن".
ولعل ما جاء به ابن جني أوضح تعبير عن هذه النظرية، فلقد أفرد باباً مستقلاً لهذا الموضوع جعل عنوانه " باب في الرد من ادعى على العرب عنايتها بالألفاظ وإغفالها المعاني" قال فيه: " اعلم أن هذا الباب من أشرف فصول العربية، وأكرمها، وأعلاها، وأنزهها، وإذا تأملته عرفت منه وبه ما يُؤْنِفُك، ويذهب في الاستحسان له كل مذهب بك. وذلك أن العرب كما تُعنى بألفاظها فتصلحها وتهذبها وتراعيها، وتلاحظ أحكامها، بالشعر تارة، وبالخطب أخرى، وبالأسجاع التي تلتزمها وتتكلف استمرارها، فإن المعاني أقوى عندها، وأكرم عليها، وأفحم قدراً في نفوسها".
... ويقول: " فإذا رأيت العرب قد أصلحوا ألفاظها وحسنوها، وحموا حواشيها وهذبوها، وصقلوا غروبها وأرهفوها، فلا ترين أن العناية إذ ذاك إنما هي بالألفاظ، بل هي عندنا خدمة منهم للمعاني، وتنويه بها وتشريف منها .. ونظير ذلك إصلاح الوعاء وتحصينه وتزكيته، وإنما المبغي بذلك منه الاحتياط للموعى عليه، وجواره بما يعطر نشره، ولا يَعُرُّ جوهره، كما قد نجد من المعاني الفاخرة السامية ما يهجنه، ويغضّ منه كدْرة لفظه وسوء العبارة عنه".
إذاً، فرأي ابن جني أن العرب إذا اعتنت بألفاظها، فإنما هي تخدم المعاني التي تحملها تلك الألفاظ، والمعاني عندها أكرم قَدْراً، وأرفع شأناً وأعلى مكاناً من الألفاظ. والشأن – كل الشأن- للمعاني.
مدرسة النظم:
أما الفريق الثالث، وهو الأعم الأغلب في تاريخ رجال البلاغة العربية، فقد وحّد النظرة إلى وجهي الكلمة: لفظها ومعناها، ورأى فيها جسداً وروحاً متكاملين، إذا أصاب الحيْفُ أحدهما اشتكى له الثاني وتداعى.
وكان من زعماء هذا الفريق أكبر رجل عرفته البلاغة العربية على مدى تاريخها الطويل، ذواقة للنصوص، وعقلية راجحة، ومنصفاً كبيراً، هو الشيخ عبدالقاهر الجرجاني، ولا سيما في كتابه " دلائل الإعجاز".
لقد أزعج الجرجاني ذلك التقدير للألفاظ وتقديمها على المعاني عند من سبقه من النقاد، حتى إنهم جعلوا للفظة المفردة مميزات وصفات لم يستطع أن يتقبلها ذهنه المتمرس بتفاوت الدلالات، وقيمة التعبير عن ذلك التفاوت، وكان يحس بوعي نقدي فذ أن ثنائية اللفظ والمعنى التي تبلورت عند ابن قتيبة قد أصبحت خطراً على النقد والبلاغة معاً. أما على المستوى النقدي فإن الانحياز إلى اللفظ قتل" الفكر" الذي يعتقد الجرجاني أنه وراء عملية أدق من الوقوف عند ميزة لفظة دون أخرى، وأما على المستوى البلاغي فإن الجرجاني لم يستطع أن يتصور الفصاحة في اللفظة، وإنما هي في تلك العملية الفكرية التي تصنع تركيباً من عدة ألفاظ؛ وقد يجد الجرجاني عذرا للقدماء الذين أقاموا تلك الثنائية، ففخموا شأن اللفظ وعظموه، وتبعهم في ذلك من بعدهم حتى قالوا: " المعاني لا تتزايد، وإنما تتزايد الألفاظ، وعذرهم في ذلك أن المعاني تتبيَّنُ بالألفاظ، ولا سبيل لمن يرتبها إلى أن يدلنا على ما صنع في ترتيبها إلا بترتيب الألفاظ، لهذا تجوز القدماء فكنوا عن ترتيب المعاني بترتيب الألفاظ نفسها، ثم تحدثوا عن الألفاظ، وحذفوا كلمة " ترتيب" ثم أسبغوا على الألفاظ صفات فارقة فقالوا: لفظ متمكن ولفظ قَلِق ... الخ وإنما مقصودهم المعنى.
من جهة ثانية خطأ الجرجاني المنحازين إلى جانب المعنى بشدة لا تقل عن شدته في تخطئته من ذهبوا إلى إبراز مميزات اللفظة المفردة فقال:" واعلم أن الداء الدوي والذي أعيا أمره في هذا الباب غلطُ من قدم ا لشعر بمعناه، وأقل الاحتفال باللفظ، وجعل لا يعطيه من المزية إن هو أعطى إلا ما فضل عن المعنى. يقول: " ما في اللفظ لولا المعنى؟ وهل الكلام إلا بمعناه ؟"؟ فأنت تراه لا يقدم شعراً حتى يكون قد أودع حكمة وأدباً واشتمل على تشبيه غريب ومعنى نادر".
وينفذ الجرجاني بفهم دقيق إلى مشكلة " المعاني مطروحة في الطريق" فيوجه رأي الجاحظ توجيهاً ملائماً، إذ يرى الجرجاني: أن مصطلح " معنى" كما استعمله الجاحظ ذو دلالة دقيقة، فهو يعبر به عن " الأدوات الأولية".
أن البلاغة لا تكون إلا في الحديث الملفوظ أو المكتوب، وأنها لا تفصل بين العلم والذوق، ولا بين المعنى والمبنى، فالكلام كائن حي، روحه المعنى وجسمه اللفظ، فإذا انفصلا أصبح الروح نفساً لا يتمثل، والجسم جماداً لا يحس.
البلاغة ثنائية التكوين، تقوم على عنصري المعنى والمبنى، أو الجوهر والشكل، ومن تآلفهما تتفاضل الأحكام، وتختلف أساليب الأدباء، ويتمايز الشعراء ... فمن عرف سر التعبير الفني الرفيع حاز قصب السبق، ومن أخطأه التوفيق هوى وأسفَّ، وأهمله الناس.