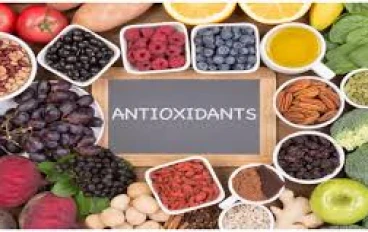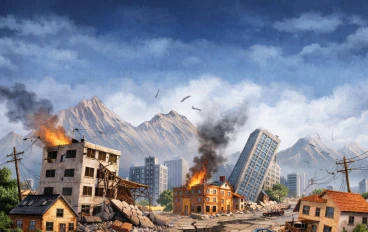الأمير عبدالرحمن الداخل (الأول) (138-172هـ/ 756- 788م)
يكنى أبا المطرف، وقيل أبا يزيد، وقيل أبا سليمان ويلقب صقر قريش أو بصقر بني أمية. أسس هذا الأمير في الأندلس أمارة أموية وراثية مستقلة سياسيا عن الخلافة العباسية في المشرق. أما من الناحية الروحية فمن المعروف أن عبدالرحمن قطع الخطبة للعباسيين بعد فترة قصيرة من بداية عهده. ويفهم من كلام بعض المؤرخين أمثال ابن الكردبوس وابن أبي دينار ، أن عبدالرحمن الداخل وجميع أمراء بني أمية الذين حكموا بعده حتى عهد عبدالرحمن الناصر، قد دعوا في خطبهم الدينية لخلفاء بني العباس ببغداد رغم العداء السياسي الذي كان قائما بين هاتين الدولتين.
غير ان هذه الرواية لم يقم عليها دليل أو إجماع تاريخي خصوصا وأن ابن أبي دينار عاد ثانية وناقض عبارته الأولى بقوله:" ودانت لعبدالرحمن (الداخل) البلاد، وبقي ملكا ثلاثا وثلاثين سنة، وتداولها بنوه من بعده، ولم يخطب أحد منهم لبني العباس، ولم يدخل تحت طاعتهم، إلى أيام عبدالرحمن الثالث الذي تلقب بالناصر لدين الله وتسمى بأمير المؤمنين".
أما ثقاة مؤرخي الأندلس أمثال ابن حزم وابن الأبار والمقبري، فقد حددوا مدة الدعاء لبني العباس في الأندلس بفترة قصيرة فقط في بداية عهد عبدالرحمن الأولى ثم قطع الدعاء لهم بعد ذلك. فابن حزم في كتابه نقط العروس يقول إن الدعوة للعباسيين استمرت عدة سنوات ثم قطعها عبدالرحمن الأول . كذلك يقول ابن الأبار في كتابه الحلة السيراء:" وأقام عبدالرحمن أشهرا دون السنة يدعو لأبي جعفر المنصور ... متقيلاً في ذلك يوسف الفهري في الدعوة للعباسيين".
ولا شك أن هذا الأمير الأموي الكبير عبدالملك بن عمر كان يعني ما يقول عندما هدد بالانتحار إذا لم تقطع الخطبة للعباسيين. وقد يؤيد ذلك أنه سبق أن قتل ابنه المدعو امية عندما انهزم في معركة حربية أمام العدو، إذ قال له:" ما حملك على أن استخففت بي وجرأت الناس علي والعدو؟ إن كنت قد فررت من الموت فقد جئت إليه"، ثم أمر بضرب عنقه. وأعتقد أن مثل هذا الشخص الذي يقدر على قتل فلذة كبده في سبيل مبدأ معين، قادر كذلك على قتل نفسه في سبيل هذا المبدأ. ولعل هذا كان من الأسباب القوية التي حملت عبدالرحمن الداخل على تنفيذ طلبه.
حكم عبدالرحمن مدة 33 عاماً قضاها في كفاح مستمر مع العناصر والأحزاب المعارضة لإمارته. وقد حرص عبدالرحمن على أن يلقى خصومه منفردين في الميدان، فاستطاع بذلك أن يقضي عليهم واحداً بعد الآخر قبل أن يكتلوا ضده. وهذه السياسة هي التي سار عليها حديثا نابليون بونابرت فكانت سر عظمته.
وكان أول المعارضين لإمارة عبدالرحمن هم أًصحاب السلطان القديم في الأندلس أمثال يوسف الفهري والصميل بن هاتم وأتباعهما الذين حاولوا استعادة نفوذهم القديم في البلاد بالرغم من سياسة التسامح التي سلكها معهم الأمير عبدالرحمن.
حضارة الأندلس على عهد عبدالرحمن:
لم يكن الفتح العربي لإسبانيا مجرد احتلال عسكري صعدت فيه الجيوش الإسلامية إلى أقصى الشمال ثم هبطت إلى الجنوب مثل الترمومتر أو ميزان الحرارة، بل كان حدثاً حضاريا هاما امتزجت فيه حضارة سابقة كالرومانية والقوطية مع حضارة جديدة لاحقة وهي الحضارة الإسلامية . ونتج عن هذا المزيج حضارة أندلسية مزدهرة وصلت إلى الفكر الأوروبي المجاور وأثرت فيه. فالفتح العربي لإسبانيا كان ختاما لدور سابق وبداية لدور إسلامي لاحق تغلغل في الحياة الإسبانية وترك فيها آثارا عميقة ما زالت تتراءى مظاهرها بوضوح حتى اليوم.
وكانت إسبانيا بعد الفتح العربي مزدحمة بالأجناس المختلفة، وكان من الطبيعي أن تتصل هذه العناصر بعضها ببعض سواء بالمصاهرة أو الجوار أو الحرب، وأن يأخذ كل منها عن الآخر ويعطيه مما كان له أثره في مزج هذه العقليات المختلفة والعناصر المتباينة.
وما يقال عن تنوع هذه العناصر البشرية التي سكنت الأندلس، يقال أيضا عن التيارات الثقافية المتنوعة التي تكونت منها حضارتها. فمن المعروف أن الحضارة الأندلسية لم تنشأ فجأة، بل مرت في أدوار مختلفة، وخضعت لمؤثرات حضارية مشرقية تربطها بالوطن الإسلامي الأم باعتبارها جزءا منه، كما خضعت لمؤثرات حضارية محلفية بحكم البيئة التي نشأت فيها.
أن الفترة الأولى من تاريخ الأندلس الإسلامي حتى عهد الأمير عبدالرحمن الداخل، كانت الأندلس فيها خاضعة للسيادة الأموية سواء في دمشق أو في قرطبة، ولهذا كان من الطبيعي أن تتأثر بالحضارة الشامية في جميع مظاهرها وهو ما يسمى في المصطلح الأندلسي بالتقليد الشامي.
فالحياة الأدبية كانت صدى لحياة ال شام الأدبية، فالشعر الأندلسي في هذه الفترة الأولى كان شعرا كلاسيكياً يحاكمي شعر الفرزدق والأخطل وجرير بالمشرق.
ومن أهم شعراء الأندلس في ذلك الوقت، الولاة والأمراء الذين حكموا الأندلس مثل أبي الخطار بن ضرار الكلبي، والصميل بن حاتم ثم الأميرعبدالرحمن الداخل وأبنائه.
ومن شعر الأمير عبدالرحمن، نذكر تلك الأبيات التي يصف فيها نخلة أثارت شجونه:
تبدت لنا وسط الرُّصافة نخلةٌ *** تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل
فقلت شبيهي في التغرب والنوى **** وطول الثنائي عن بنيّ وعن أهلي
نشأت بأرض أنت فيها غريبةٌ *** فمثلُكِ في الإقصاء والمنتأى مثلي
ومن قوله في الحنين إلى المشرق:
أيها الراكب الميمُ أرضي *** أقر من بعضي السلام لبعضي
إن جسمي كما علمت بأرض *** وفؤادي ومالكيه بأرض
قدر البين بيننا فافترقنا *** وطوى البين عن جفوني غمض
قد قضى الله بالفراق علينا *** فعسى باجتماعنا سوف يقضي
هذه الشاعرية ليست غريبة على عبدالرحمن لأنها موهبة متوارثة في بني أمية، وقد ورثها أبناؤه من بعده.
ولقد اتخذ عبدالرحمن من مدينة قرطبة عاصمة دائمة للدولة. قبل ذلك الوقت
كانت قاعدة الحكم في الأندلس غير ثابتة تارة في إشبيلية، وتارة أخرى في قرطبة.
وقد حرص عبدالرحمن على جعل قرطبة صورة من دمشق في منازلها البيضاء ذات الأحواش الداخلية Patios، المزينة بالأزهار والوروود ونافورات المياه. كذلك عرف عن عبدالرحمن أنه كان يرسل عملاءه إلى المشرق لجلب أشجار الفاكهة من الشام. فنسمع عن عميل له له أردني اسمه سفر بن عبيد الكلاعي الذي ينسب إليه أسماء بعض الفواكه التي غرسها وأثمرت مثل التين السفري والرمان السفري.
ولا يزال هذا النوع من الرمان معروفا في إسبانيا بحلاوته وصغر حجمه ويسمى بنفس الاسم أيضا.
كذلك بنى عبدالرحمن في شمال غرب قرطبة منية أو قصرا صيفيا على سفح جبل قرطبة سماه قصر الرصافة محاكيا في ذلك قصر جده هشام بن عبدالملك الذي بناه خارج دمشق في بادية الشام سنة 110هـ وسماه بهذا الاسم .
ولا زالت توجد في هذا المكان بقرطبة قرية تحمل هذا الاسم La Ruzafa وقد عرف عن الأمويين بصفة عامةن أنهم كانوا يحنون إلى حياة البادية، وأنهم كثيرا ما اتجهوا إلى هذه المنيات أو القصور الخلوية كي يعيشوا فيها عيشة بسيطة بعيدا عن حياة العاصمة الصاخبة. ولم يلبث أمراء بني أمية في الأندلس أن أخذوا يقلدون أميرهم عبدالرحمن في اتخاذ القصور الخلوية. ومثال ذلك القصر الذي بناه ابنه عبدالله في مدينة بلنسيه. وأطلق عليه نفس الاسم والرصافة. ولا يزال هذا القصر موجودا إلى اليوم في مدينة بلنسية ويسمى La Ruzafa .
ولعل كلمة الرصافة جاءت من الرصف أي ضم الشيء إلى الشيء كما يفعل في رصف الشوارع. والمعنى هنا المدينةالجانبية مثل رصافة بغداد وهي بغداد الشرقية التي بناها الخليفة المنصور العباسي على الضفة الشرقية لنهر دجلة مقابل بغداد الغربية ومثل رصافة دمشق ورصافة قرطبة وهكذا.
أما من الناحية المعمارية فهناك جامع قرطبة الذي أعاد الأمير عبدالرحمن بناءه سنة 169هـ (785م) وفيه يلاحظ بوضوح المؤثرات الشامية المقتبسة من المسجد الأموي بدمشق. مثال ذلك العقود المزدوجة التي تزيد من ارتفاع السقف وتجعله ارتفاعا مناسبا مع اتساع مساحة المسجد، وإن كانت عقود مسجد قرطبة تبدو أكثر إجادة وروعة. ونلاحظ هذا التأثير في وضع المئذنة وفي الممر الذي يصل المسجد بقصر الإمارة وهو المعروف بالساباط.
والواقع أن موقع قرطبة يشبه موقع دمشق. فدمشق تقع على الضفة اليسرى لنهر بردي، وقرطبة تقع على الضفة اليسرى لنهر الوادي الكبير، ويطل على دمشق جبل قاسيون كما يطل على قرطبة جبل العروس هذا إلى جانب التشابه بين البلدين في بيوتهما وأسلوب الحياة فيهما. ومن هنا كاتن قول الجغرافيين العرب بأن الأندلس : " شامية في هوائها"، قول يتضمن معاني أوسع من المعنى الجغرافي المحدود لهذه العبارة.
أن عبدالرحمن الداخل جاء من المشرق شابا شريداً طريداً، ولم يكن معه جيش ولا مال ولا عصبية، بل كان كل شيء معاكساً ومضادا له، ولكنه استطاع بذكائه وشجاعته وحسن سياسته أن يصل إلى الحكم ويقضي على أعدائه ويجعل من الأندلس دولة مستقلة بعد أن كانت ولاية تابعة لخلافة المشرق تبعية مطلقة.
وتوفي عبدالرحمن سنة 172هـ (788م) وهو في سن الستين ودفن بالروضة من قصر الإمارة بقرطبة. وقد وصفه المؤرخون بأنه كان صبوح الوجه، طويل القد ، أشقر الشعر، خفيف العارضين، له ضفيرتان، ولا يعيبه سوى فقدان إحدى عينيه. ومن صفاته أنه ككان شديد الحذر قليل الطمأنينة شجاعا شاعرا، يحب البياض ويؤثره على غيره من الألوان في أعلامه وملابسه وقصوره.