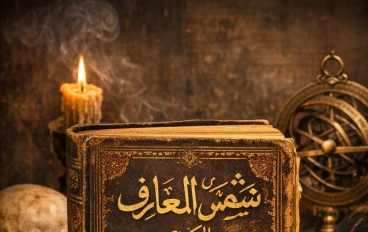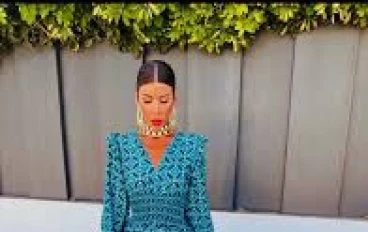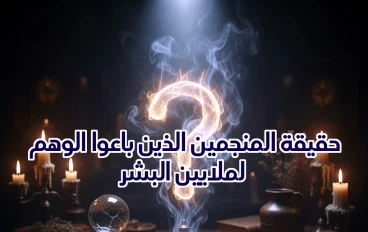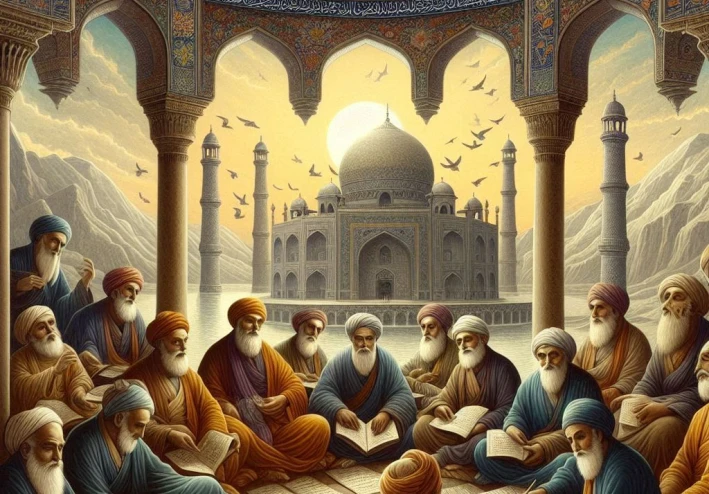
العوامل المؤثرة في نشأة شعر الغزل في العصر الأموي
إن الواقع الاجتماعي للعصر الأموي ينقسم إلى أربع طبقات :
أ-طبقة الصحابة والتابعين: وهؤلاء استمدوا قوتهم من العلاقة التي كانت تربطهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، والمكانة التي اختصهم بها؛ إذ على أكتاف هؤلاء قام الإسلام، وشيد بناؤه، وبجهادهم عم وانتشر في أنحاء الجزيرة العربية على أنقاض الشرك والوثنية، فكان لا بد أن ينظر إلى هؤلاء نظرة خاصة من قبل الحكام، تليق بما بذلوه وضحوا من أجله.
ب-طبقة الأشراف ورؤساء القبائل: ممن كان لهم مجدهم قبل الإسلام وبعده، فكان لهم الشرف التليد الموروث والشرف الطارئ المكتسب.
ج-طبقة الموالي: وقد تكونت هذه الطبقة من أولئك الأعاجم الذين اعتنقوا الإسلام، واستقرت بهم حياتهم في الكوفة في ظل ساداتهم العرب الذين أسلموا على أيديهم، فأصبحوا موالي لهم، وهؤلاء جاءوا في أول أمرهم إلى المجتمع الأموي كأسرى حرب، وحتى يتحرروا من الرق والعبودية، كان عليهم أن يتخذوا من الإسلام دينا لهم، وبإسلامهم أعتقوا، ولكن ظلوا مرتبطين مع ساداتهم برابط الولاء.
ومن اهم الأماكن التي استخدمت لتجميع هؤلاء الأسرى الكوفة، ذلك أنها كانت معسكرا مهما للجيش الإسلامي أثناء قيامه بالفتوحات في بلاد فارس، ومركزا لتلقي السيل الذي لا ينقطع من الأسرى الفرس.
فقد ذكر بعض المؤرخين: أن عدد الموالي في الكوفة كان يزيد على نصف سكانها، وكان معاوية يخشى من وثبة هؤلاء على العرب، وانتزاع السلطان منهم، ولهذا فكر في أن يقتل منهم شطرا، ويدع شطراً لإقامة السوق، وعمارة الطرق، ولكنه عاد فعدل عن ذلك.
لقد حصل ما كان يخشاه معاوية من تأثير هؤلاء الموالي في العامل السياسي للدولة الأموية، فقد قضى على هذه الدولة من قبل العباسيين بمؤازرة ومساعدة هؤلاء.
كما أنهم شاركوا في أغلب الحركات الثورية التي قامت ضد بني أمية، كثورة المختار الثقفي، وثورة ابن الأشعث.
والسؤال الذي يراود الذهن هو: هل قام هؤلاء بهذه الحركات الثورية رغبة منهم، أم أملتها عليهم ظروفهم المعيشية التي كانوا يعيشونها.
لقد كان مفروضا، أن يكون هؤلاء الموالي في منزلة اجتماعية تتساوى، من الناحية الإنسانية على الأقل – مع منزلة العرب وذلك وفقا للمبادئ العادلة التي نادى بها الإسلام، وأعلنها الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع المشهورة، وهي تلك المبادئ التي تجعل التمايز بين الناس على أساس التقوى، لا على أساس اللون أو الجنس. و قد حاول الصحابة أن يحافظوا على هذا التقليد حتى آخر خليفة للمسلمين وهو علي بن أبي طالب الذي كان لا يفضل شريفا على سوقة، ولا عربيا على أعجمي، حتى جاء بنو أمية إلى الحكم، وراحوا ينظرو ن للموالي نظرة السيد للعبد، ويعاملونهم لا بتلك المعاملة الإسلامية السامية التي أمرهم الله ورسوله بها، وإنما معاملة أقل ما توصف به أنها بعيدة عن روح الإسلام السمح. ومجافية لمبادئه الإنسانية ا لسامية، فقد كانوا ينظرون إليهم كجنس دون جنسهم.
وقد اتخذ نوع الاضطهاد الممارس ضد الموالي اتجاهين:
- اضطهاد ديني. فقد حرم على هؤلاء أن يمارسوا صلاتهم إلا في مساجد خاصة بهم، وحرم عليهم دخول مساجد العرب.
- واضطهاد اجتماعي. إذ حرم على العبد الزواج من حرة، كما فرض على الرجل العربي الذي يريد الزواج من أمة، أن يطلب يدها من سيدها العربي، لا من أبيها أو أخيها . فإن رضي سيدها تم الزواج وإلا رد، وإن زوج الأب أو الأخ بغير رأي سيده فسخ النكاح.
وقد استأثر العرب بالمناصب الهامة في الدولة الأموية وبخاصة السياسية والدينية، ولم يسمحوا للموالي بحق العمل فيها، وإنما سمحوا لهم بالأعمال التي كانوا يأنفون من القيام بها، كالزراعة والصناعة والحرف اليدوية.
د- طبقة أهل الذمة: وهم الأجانب من الفرس والنبط، والسريان الذين لم يقبلوا اعتناق الإسلام، وظلوا متمسكين بأديانهم القديمة. ووفقا للتشريع الإسلامي السمح، فقد تركت لهم حرية العبادة، على أن يدفعوا للمسلمين الجزية مقابل حماية المسلمين لهم، ومحافظتهم لهم على أرزاقهم. ولكن هذه الحرية كانت مفروضة فقط على القادرين على حمل السلاح مع المسلمين ولكنهم رفضوا ذلك، دون سائر الناس من أهل الذمة كالطاعنين في السن، أو النساء. كما أن بعض أهل الذمة معفيون من الجزية لمكانتهم الروحية، كالرهبان، والقسيسين، والزهاد المنقطعين للعبادة.
هذه هي الطبقات الاجتماعية التي عرفها المجتمع الأموي، وكانت هذه الطبقات بطبعية الحال – تعيش كل منها أنماطا خاصة في الحياة، ولكن هذه الأنماط المختلفة – على ما بينها – من تباعد أو تقارب تؤلف الصورة العامة للحياة الاجتماعية في العصر الأموي.
العامل الديني:
عرف العصر الأموي بنقلة نوعية من الالتزام الإسلامي الذي لا هوادة فيه من قبل الصحابة، إلى تحرر من ذلك الالتزام، أو بصورة أخرى نقلة من الدين إلى الدنيا ، فبعد أن كان الحكم شورى بين المسلمين، صار حكما ملكيا عند الأمويين ولما رأى هؤلاء أن حكمهم غير شرعي، لأنه لم يؤخذ بحكم الجماعة راحوا يقللون من قيمة ما قال به الصحابة والتابعون، ويقررون هم الأحكام حسب ما تمليه ظروفهم السياسية، من هنا نرى الضعف الديني قد برز عند بعض الخلفاء الأمويين، بل نجد انحرافاً عند البعض الآخر، ومن الذين مهدوا لهذا الانحراف الخليفة الوليد بن يزيد، الذي كان يشرب الخمر، ويتغنى بها، ويستمع إلى المغنيات، ويبعث في طلبهن من أقصى الأقاليم الإسلامية، بل يزيد على ذلك استهانة بالدين، واستهتاراً به وتحللاً من القيم الأخلاقية، وإفراطاً في المجونة والتهتك والخلاعة، وقد وصفه المسعودي في مروج الذهب بقوله:" وكان صاحب شراب. ولهووطرب، وسماع للغناء، اتخذ القيان، وكان متهتكاً ماجناً خليعاً".
ومعنى هذا أننا في أيام الأمويين أمام ظاهرة اجتماعية شديدة الخطورة لم يسبق للمجتمع الإسلامي أن شهد مثلها، فلأول مرة في المجتمع الإسلامي تظهر شخصية أمثال الوليد بن يزيد وتدعي أنها خليفة للمسلمين. ثم هي تتهتك في الدين، وتستهتر به.
ولما كان الناس على دين ملوكهم، فقد راح كثيرون منهم يقلدون خليفتهم دون أن يجدوا في ذلك حرجاً، أو خشية من تنفيذ حدود الشرع فيهم، " فغلبت شهوة الغناء على الخاص والعام".
والملاحظ أن حركة اللهو والمجون تدفع بصاحبها إلى التحلل من الدين. لأن الدين هو الذي يقف حائلا بين الإنسان وبين هذه المحرمات ، لهذا نجد المجان يسخرون من الدني، كما سخروا من رجاله وخاصة المتشددين منهم، المحرمين للخمرة وشربها، وينتهي الأمر بهؤلاء المجان إلى الشك بالدين مما قادهم هذا إلى الإلحاد.
ألم نسمع الوليد بن يزيد يقول وهو يضع القرآن الكريم أمامه ليرميه بالنشاب:
أتوعد كل جبار عنيد *** فها أنا ذاك جبار عنيدُ
إذا ما جئت ربك يوم حشر *** فقل يا رب مزقني الوليد
وظاهرة المجون والتهتك هذه نمتها وساعدت على انتشارها تلك الصراعات التي قامت بين الفرق الإسلامية، وكيف راح بعضها يكفر الآخر، أو يتهمه بقلة الدين والخروج عنه. فهناك الخوارج والمرجئة والشيعة والأمويون، كل يدعي أن الحق معه، وأن ما عداه هو ليس بمسلم حقيقي.
فالمرجئة تريد أن تكون خارج لعبة الصراع السياسي المغلف بصراع ديني في العصر الأموي، حتى لا تغمس يديها في الفتن. ولا تريق دماء حزب، ولا تحكم بتخطئة فريق، وتصديق آخر . ولهذا فهي تقول: إن الإيمان مصدره القلب . ولا عبرة في المظهر، فيكفي أن يكون الإنسان مؤمناً في قلبه بأن الله واحد، وأن محمداً رسول الله، وأن ما جاء به هو الحق ليكون مؤمنا كامل الإيمان وصحيح العقيدة، وليس الإقرار باللسان، ولا الأعمال من صلاة وصوم ونحوهما جزء من الإيمان.
وأما الخوارج فقالوا: إن مرتكب الكبيرة كافر، وقالت المعتزلة إنه ليس كافراً ولا مؤمناً، وإنما هو في منزلة من المنزلتين.
ومن الواضح أن هذا الاختلاف بين الفرق إنما كان نتيجة لاختلافهم في تحديد معنى الإيمان ، والكفر.
هذا الاختلاف هو الذي شجع ضعاف الإيمان والمشككين على التوسع في تشكيكهم واستهتارهم، وبالتالي على الانحراف نحو الملذات على اختلاف أنواعها دون خوف أو وجل.
العامل الاقتصادي:
الفيء يسيل إلى الجزيرة العربية.
إن الفيء العظيم الذي حصل عليه المسلمون، كان عظيم التأثير على الجزيرة العربية، فقد استبدلها الله تعالى من شظف عيشها وقلة زادها، وانعدام مواردها، بسعة في العيش وأموال طائلة أتت إليها من سوريا ومصر والعراق والبحرين.
فقد ذكر البلاذري: أن عمر بن الخطاب بعث إلى عمرو بن العاص بعد فتح مصر، يعلمه بما فيه أهل المدينة من الجهد، ويأمره أن يحمل ما يفيض من الطعام في الخراج إلى المدينة، عن طريق البحر، فكان ذلك يحمل، ويحمل معه الزيت ويقسم بين الناس بمكيال، ويكذر البلاذري أن هذا انقطع في الفتنة الأولى، ثم حمل في أيام معاوية ويزيد، ثم انقطع إلى زمن عبدالملك بن مروان، ثم لم يزل يحمل حتى خلافة المنصور".
ويقول السيوطي إن عمر بعث يستغيث عمراً، ويقول: " سلام عليك. أما بعد، فلعمري يا عمرو ما نبالي إن شبعت أنت ومن معك ، أن أهلك أنا ومن معي، فيا غوثاه ! هوذا قد بعثت لك بعير، أولها عندك وآخرها عندي والسلام".
ويذكر الطبري، وأبو الفداء، أنه لما كتب عمر إلى أمراء الأمصار، يستغيثهم لأهل المدينة ومن حولها، ويستمدهم. كان أول من قدم عليه أبو عبيدة بن الجراح في أربعة آلاف راحلة من الزاد، وقسم عمر ذلك على المسلمين ، حتى رخص الطعام بالمدينة، واستغنى فقراء الفيء.
وذكر البلاذري أن عبدالله بن أبي سرح، صالح بطريق إفريقيا بعد فتحها، على ثلاثمائة قنطار من الذهب وذكر البلاذري أيضا أن خراج السواد بلغ على زمن عمر بن الخطاب مئة مليون درهم.
ولعل هذا كله، لم يكن كثيراً، إذ قيس بالمال الذي روى الرواة أنه صار في حوزة الأفراد، نتيجة للغنائم التي غنموها من مدائن كسرى، وبلاد فارس، وغيرها. فقد روى ابن خلدون: أن تجارة الرق زخرت لديهم، حتى كان يقسم للفارس الواحد، في بعض الغزوات ثلاثون ألفاً من الذهب أو نحوها ناهيك بالرقيق والسبايا، والمواشي على أنواعها التي كانوا يغنموها ويبيعونها إذا شاءوا.
وقد فاز الحجاز بالقسط الأعظم من الفيء زمن بني أمية، فقد روي عن الوليد بن عبدالملك، أنه حج في خلافته، وقسم بالمدينة رقيقا كثيرا فيما بين الناس، وآنية من ذهب وفضة وأموالاً.
إن الفيء الذي وزع على الحجاز جعل منه بلدا عامراً، أجرى فيه أنهاراً، وحفر آباراً. وأصبح للأشراف جنائن وبساتين لم يعرفوها من قبل. وأخذ بعضهم يلتفت إلى الزراعة لينميها، فيمتلك ا لمزارع. فقد روى ابن قتيبة أن سعيد بن عثمان لما عاد من خراسان معزولاً. أقبل معه برهن كانوا في يديه من أولاد الصغد إلى المدينة، وألقاهم في أرض يعملون له بالمساحي. وسأل معاوية صعصعة بن صوحان عن أحسن المال فقال:" أفضل المال برة سمراء في تربة غبراء، ونعجة صفراء في نبعة خضراء، أو عين خرارة في أرض خوارة، قال معاوية: لله أنت فأين الذهب والحنطة؟ قال: حجران يصطكان إن أقبلت عليهما نفذا، وإن تركتهما لم يزيدا".
كذلك كان للفيء دور هام في عمارة القصور، والأبنية الحديثة. فقد ذكر المسعودي أن عثمان ابتنى داره بالمدينة، واستبدلها بالحجر والكلس، وجعل أبوابها من الساج والعرعر، وابتنى سعد بن أبي وقاص داره بالعقيق فرفع سمكها، ووسع فضاءها وجعل على أعلاها شرفات، وشيسد طلحة دارا بالمدينة، وبناها بالجص والآجر والساجن وكذلك عبدالرحمن بن عوف الزهري فإنه ابتنى دارا له ووسعها".
وقلت قيمة المال عند الأشراف، حتى صارت أعطيات الأمراء بالمئات، والألوف من الدنانير، وحتى صار مهر النساء الكريمات أضعاف أضعاف ما كان. فقد روي أن عمرو بن عبيدالله مثلا أمهر عائشة بنت طلحة مليون درهم وتزوج مصعب بن الزبير سكينة بنت الحسين، فأمهرها ألف ألف درهم، وأن الحجاج أمهر بنت عبدالله بن جعفر تسعين ألف دينار.
هذه الحالة من الانتعاش الاقتصادي لم تكن محصورة بالقادة أو الحاكمين، بل إ ننا نجد أن بني أمية وهم أصحاب الملك، وبيت المال راحوا يفرقون الأموال على أشراف الحجاز. وشبابه. ولعلهم في هذا الإكرام المميز إنما أرادوا حرف شباب الحجاز وخاصة أبناء الصحابة عن التفكير بإقامة الفتن، أو السعي نحو الوظائف في الدولة، أو الانشغال بالسياسة، وسرعان ما كان هؤلاء ينفقون هذه الأموال والأعطيات في سبيل اللهو والطرب، أو العبث والمجون. أو الضيافات والكرم.