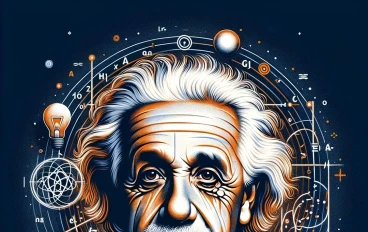الشيخ الداعية عبدالواحد مخدوم
الشيخ عبد الواحد مخدوم: سيرة داعية تركستاني في زمن الانهيار والصعود
مقدمة
تتكوّن صورة الشيخ عبد الواحد مخدوم في الذاكرة التركستانية بصفتها صورة عالمٍ ربّاني ظهر في مرحلة كان فيها الإسلام في تركستان الشرقية يواجه أشدّ أزماته. لم يكن الشيخ مجرد واعظ، بل كان امتدادًا لسلسلة من العلماء الذين حملوا العلم الشرعي في قلب آسيا الوسطى منذ قرون، وظلّوا يربّون جيلاً بعد جيل رغم قسوة الظروف، وضعف الإمكانات، وتهديدات السلطة. وقد اكتسب عبد الواحد مخدوم مكانته الرفيعة لأنه عاش في زمن صعب، وبرز في بيئة مضطربة، وحافظ من خلالها على هوية الأمة وعقيدتها، بينما كانت القوى الكبرى تتزاحم حول تركستان، وتتنازعها طموحات الساسة والعسكر.
لقد عاش الشيخ في مجتمع لم يكن يملك من مقومات البقاء سوى تمسّكه بالدين، ولذلك صار العلماء محور الحياة الاجتماعية، ومراكز التوجيه، وحصون الاستقرار، وحماة الوعي. ومن هنا تشكّلت شخصية عبد الواحد مخدوم، ليس بوصفه معلّمًا للعلم فقط، بل كقائدٍ روحيّ، ورمز من رموز الهوية الثقافية والدينية، وصوت من أصوات الصمود أمام محاولات الاجتثاث الثقافي.
البيئة الثقافية والدينية التي نشأ فيها
ولادة الشيخ عبد الواحد مخدوم جاءت في سياق تاريخي ممتد، حيث كانت تركستان الشرقية جزءاً من فضاء واسع يضم مدن العلم الكبرى مثل بخارى وسمرقند وكاشغر. وقد اشتهرت هذه المناطق منذ العصور الوسطى بمدارسها الدينية، ومراكزها التعليمية التي خرجت علماء كبارًا استقرّت أسماؤهم في التاريخ الإسلامي.
كانت الأسر العلمية في تركستان تُعرف بأسماء مثل “المخدوم”، “الخواجة”، “الإمام”، وهي ألقاب ترمز إلى العلم والتقوى والسلوك الصوفي المعتدل. وعُرفت عائلة الشيخ بأنها إحدى الأسر التعليمية العريقة، التي حافظت عبر أجيال على تدريس العلوم الشرعية، ونقل المعرفة، وقيادة المجتمعات المحلية. في هذا السياق نما عبد الواحد، وفتح عينيه على عالمٍ يختلط فيه التعليم الديني بالتقاليد الروحية، حيث كانت حلقات الذكر، والمدارس الريفية، والربط الصوفية أركانًا أساسية للحياة.
ورغم بساطة البنية الاقتصادية في تلك المناطق، إلا أن الحياة العلمية كانت ناشطة؛ فالمكتبات الخاصة كانت موجودة، والمدارس كانت تستضيف طلابًا من مناطق بعيدة، والعلماء كانوا يحظون باحترام كبير باعتبارهم صمام أمان المجتمع. هذه البيئة زرعت في نفس الشيخ روح الانتماء للعلم، والميول المبكرة للدعوة، والرغبة في إصلاح المجتمع.
تكوينه العلمي
بدأ الشيخ رحلته مع العلم في سن مبكرة، حيث تلقّى العلوم الأساسية مثل التجويد والفقه الحنفي، وهو المذهب المنتشر في آسيا الوسطى. ثم انتقل إلى دراسة علوم الحديث، والسيرة، والنحو، والمنطق، والبلاغة، وهي العلوم التقليدية التي يقوم عليها تكوين العلماء في تلك المنطقة. وكانت المدارس التي درس فيها تعتمد على النظام القديم، حيث يلازم الطالب شيخه لسنوات طويلة، ويحفظ المتون، ويستوعب الشروح، ويتدرج من طالب مبتدئ إلى عالم قادر على التدريس.
تميز الشيخ عبد الواحد بذكاء واضح، وقدرة على فهم القضايا الفقهية، مما أهّله ليصبح مدرسًا في سن مبكرة مقارنة بغيره. وكان يركّز على تعليم الطلاب من الفقراء والرحّل، لأنهم كانوا الأكثر عرضة للجهل والحرمان من فرص التعلم. وقد عرف عنه أنه لا يأخذ أجرًا من المحتاجين، بل كان يعتبر نشر العلم واجبًا يقوم به لله.

طبيعة الدعوة التي انتهجها
الدعوة في تركستان لم تكن مجرد خطب في المساجد، بل كانت نظامًا اجتماعيًا قائمًا بذاته. فقد كان الشيخ يقوم بزيارة القرى البعيدة، ويعطي الدروس في البيوت، ويحضر المجالس الشعبية، ويصلح بين الناس، ويكتب الرسائل الفقهية لطلاب العلم، مما جعله ركيزة في نشر الوعي الديني واللغوي. وقد تميزت دعوته بالاعتدال، فهي لا تتطرّف في الأحكام، ولا تتصادم مع العادات المحلية التي لا تخالف الشرع، وكان يؤكد دائمًا على الأخلاق، والصبر، والتمسّك بالهوية.
وقد واجهت دعوته تحديات عديدة، أبرزها محاولات السلطات الصينية—في مراحل مختلفة—الحدّ من نفوذ العلماء، والتضييق على المدارس الدينية، وتشجيع نماذج تعليمية بديلة تهدف إلى إضعاف الارتباط بالإسلام. لكن الشيخ ظلّ ثابتًا على منهجه، يدرّس في السر حين يُمنع التدريس العلني، ويقيم حلقات العلم في البيوت حين تُغلق المدارس، ويواصل التربية الروحية رغم الرقابة الشديدة.
مركزه بين العلماء
كان الشيخ عبد الواحد مخدوم يُعرف بأنه “شيخ العلماء” في منطقته، ليس لعلوّ سنّه فقط، بل لقدرته على جمع القلوب، وحكمته في المواقف الصعبة. وقد تمتع بسمعة طيبة بين الطبقات المختلفة: التجار، الفلاحون، الرحّل، وحتى بعض الوجهاء الذين كانوا يلجؤون إليه لحلّ النزاعات. هذا المكانة جعلته أحد الأصوات المرجعية التي يُعتمد عليها في الظروف المعقدة.
كما كان الشيخ داعماً قوياً للغة الأويغورية، مؤمنًا بأنها جزء من الهوية، وأن فقدان اللغة يمثل أحد أبواب ضياع الدين. ولهذا كان يحرص على شرح العلوم بالأويغورية إلى جانب العربية، مما جعل علمه قريبًا من عامة الناس.
تأثيره على المجتمع التركستاني
لم يكن تأثيره محصورًا في طلاب العلم، بل امتد إلى العائلات ومجالس الشيوخ والقبائل الريفية. فقد ساهم في نشر ثقافة التحابّ والتآخي، والتكافل بين الأسر، وكان دائم التشجيع على تعليم الفتيات، وهي خطوة متقدمة بالنسبة للبيئة آنذاك. كما كان يحثّ على الصدقة، ويجمع التبرعات للفقراء، ويقود حملات لتعليم الأطفال في الموسم الشتوي حين تتوقف معظم الأعمال.
علاقته بالحركات الوطنية
لم يكن الشيخ عبد الواحد مخدوم منخرطًا في السياسة بمعناها الحزبي أو العسكري، لكنه كان مؤمنًا بأن الهوية الإسلامية هي أساس التحرر الوطني. لذلك كان يُعتبر قريبًا روحيًا من الحركات التي تدعو لاستقلال تركستان الشرقية أو لنيل حكم ذاتي. وتذكر روايات محلية أنه كان يشجّع الناس على الثبات، والصبر، والتمسك بالدين، وعدم الذوبان في الثقافة المفروضة عليهم.
وقد كانت كلماته تُلقي أثرًا كبيرًا لدى الناس، لأنهم كانوا يعتبرون العلماء صمّام الأمان الحقيقي، خاصة عندما كانت الهجمات الثقافية تشتد.
أسلوبه في التربية الروحية
كان الشيخ يميل إلى التصوف السني، القائم على السلوك والأخلاق لا على الغلوّ والشطحات. وقد ورث هذا السلوك من البيئة العلمية في آسيا الوسطى، التي مزجت بين الفقه الحنفي والتزكية الروحية على منهج خواجه أحمد يسوي وكبار علماء المنطقة. وكان يحثّ طلابه على تهذيب النفس، وترك الغيبة، وكثرة الدعاء، والعمل الدؤوب، وتحمّل البلاء.
مكانته بعد وفاته
بعد وفاته بقي اسمه حيًا بين الناس، لأن دوره لم يكن مجرد دور عابر؛ بل كان يمثل رمزًا من رموز الصمود الثقافي، وشاهدًا على قدرة العلماء على الحفاظ على روح الأمة رغم كل الضغوط. وقد أصبحت قصصه تُتناقل في المجالس، وتُروى لأجيال جديدة تعرف مقدار ما عاناه العلماء، وما قدّموه من تضحية.
خاتمة
إن سيرة الشيخ عبد الواحد مخدوم ليست مجرد رحلة عالمٍ عاش في منطقة بعيدة، بل هي نموذج لطبيعة العالم المسلم الذي يحمل همّ الأمة، ويقف في وجه الطمس الثقافي، ويحمي الهوية الدينية واللغوية. ولعل دراسة سيرته تفتح بابًا لفهم أعمق للواقع الذي عاش فيه المسلمون في تركستان الشرقية، ولتقدير الدور العظيم الذي لعبه العلماء في حماية الإسلام في تلك البقاع.