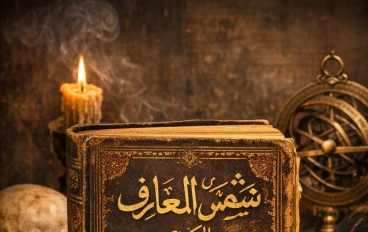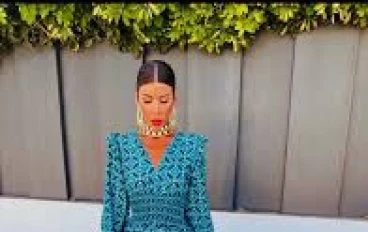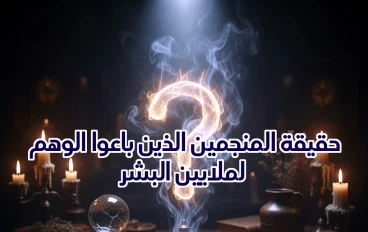الحرب التجارية بين واشنطن وبكين: من الرسوم الجمركية إلى معركة السيطرة التكنولوجية
الحرب التجارية بين واشنطن وبكين: من الرسوم الجمركية إلى معركة السيطرة التكنولوجية
لم تكن الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2018 مجرد نزاع حول العجز التجاري أو ممارسات السوق غير العادلة. لقد كشفت هذه الحرب عن تحول جيوسياسي عميق: انتقال الصراع بين القوتين العظميين من دائرة التجارة التقليدية إلى ساحة معركة أكثر حسمًا، وهي ساحة الهيمنة التكنولوجية العالمية. ما بدأ كرسوم جمركية على الصلب والألمنيوم تحول بسرعة إلى حرب باردة تكنولوجية جديدة، حيث أصبحت رقائق السيليكون والبيانات والشبكات هي الأسلحة الاستراتيجية، والسيطرة على المستقبل هي الهدف النهائي.
المرحلة الأولى: الغلاف السطحي - الحرب على الرسوم الجمركية
في مارس 2018، فرض ترامب رسومًا جمركية على واردات الصلب والألمنيوم بموجب "المادة 232" التي تُعنى بالأمن القومي. كانت هذه الضربة الأولى التي استهدفت الصين بشكل غير مباشر قبل أن تتحول إلى حرب شاملة. سرعان ما توسعت القائمة لتشمل سلعًا صينية بقيمة 250 مليار دولار، فردت الصين بردود مماثلة.
الادعاءات الأمريكية المركزية في هذه المرحلة كانت:
العجز التجاري الهائل: حيث كانت الولايات المتحدة تعاني من عجز تجاري مع الصين يتجاوز 375 مليار دولار سنويًا.
نقل التكنولوجيا القسري: اتهام الشركات الأمريكية بالاضطرار إلى نقل تكنولوجياتها إلى شركات صينية كشرط للدخول إلى السوق الصينية.
الدعم الحكومي غير العادل: دعم الدولة الصيني للشركات المحلية مما يمنحها ميزة غير تنافسية في الأسواق العالمية.
سرقة الملكية الفكرية: من خلال القرصنة الإلكترونية والوسائل الأخرى.
كانت هذه المرحلة علنية وصاخبة، حيث هيمنت عليها التغريدات والتهديدات وردود الفعل الفورية. إلا أن المحللين أدركوا أن هذه الرسوم الجمركية كانت مجرد "أعراض" لمرض أعمق. لقد كانت محاولة لكسر نموذج الصين الاقتصادي الذي مكنها من الصعود كمنافس استراتيجي لا كشريك اقتصادي تكميلي.
التحول الجوهري: من تجارة السلع إلى صراع التكنولوجيا
مع تصاعد التوترات، أصبح من الواضح أن الهدف الحقيقي لواشنطن لم يكن تقليل العجز التجاري بقدر ما كان إبطاء، أو حتى وقف، صعود الصين التكنولوجي. لقد أدركت الإدارات الأمريكية المتعاقبة (ترامب ثم بايدن) أن القوة في القرن الحادي والعشرين لم تعد تُقاس بالكتلة الصناعية فقط، بل بالقدرة على الابتكار والهيمنة على التقنيات الأساسية التي ستحكم المستقبل.
هنا، تحولت الحرب إلى بعدين حاسمين:
1. حرب أشباه الموصلات (الرقائق الإلكترونية):
تمثل الرقائق الإلكترونية "النفط الجديد" للاقتصاد الحديث. فهي عماد كل شيء من الهواتف الذكية إلى السيارات وأنظمة الأسلحة المتطورة والذكاء الاصطناعي. أدركت الولايات المتحدة أن هيمنة الصين على هذه السلسلة Supply Chain تشكل تهديدًا وجوديًا لأمنها القومي وتفوقها العسكري.
ضربات أمريكية استباقية: شنّت الولايات المتحدة هجومًا متعدد الجوانب:
إدراج شركة هواوي في "القائمة السوداء" (قائمة الكيانات): منع الشركة من الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية، بما في ذلك رقائق وتطبيقات Google، بهدف شل قدراتها في بناء شبكات الجيل الخامس 5G التنافسية.
حصار تصنيع الرقائق: فرض قيود صارمة على بيع معدات وتقنيات تصنيع أشباه الموصلات المتطورة للصين، مستهدفة شركات مثل SMIC (أكبر صانع رقائق صيني) و YMTC (صانع رقائق الذاكرة). بلغت هذه الحملة ذروتها بقرارات أكتوبر 2022 التي قطعت بشكل شبه كامل طريق تطور صناعة الرقائق الصينية المتطورة.
تشكيل تحالفات تكنولوجية: مثل تحالف "Chip 4" الذي يضم الولايات المتحدة وتايوان واليابان وكوريا الجنوبية لعزل الصين عن سلسلة التوريد العالمية للرقائق.
ردود الفعل الصينية - إستراتيجية "التدريب الشاق":
تعزيز الاكتفاء الذاتي: ضخت الصين استثمارات ضخمة في صناعة الرقائق المحلية عبر صندوق وطني ضخم، في محاولة يائسة لبناء سلسلة توريد محلية خالصة.
التركيز على التصنيع المتقدم: إدراكًا للفجوة التكنولوجية، ركزت الصين على التصنيع في العقد nodes الأقل تقدمًا (مثل 28 نانومتر) التي لا تزال حيوية للعديد من الصناعات.
تطوير بدائل محلية: تسريع تطوير أنظمة تشغيل وبرمجيات بديلة عن تلك الأمريكية (مثل نظام HarmonyOS بديلاً عن Android).
2. معركة المعايير التقنية والمنصات العالمية:
تتجاوز الحرب السيطرة على التكنولوجيا إلى السيطرة على القواعد والمعايير التي تحكمها. من سيسيطر على معايير شبكات الجيل الخامس والسادس؟ من سيحدد قواعد الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات المرتبطة به؟ من سيهيمن على المنصات المالية والتقنية العالمية؟
استراتيجية الولايات المتحدة: استخدام القوة التنظيمية والمالية الأمريكية ("سلاح الدولار") لعزل الشركات الصينية من الأسواق الغربية وإجبار الحلفاء على اختيار الجانب الأمريكي.
استراتيجية الصين: تعزيز نموذجها الرقمي المحلي (الخاضع لرقابة صارمة) وتصديره عبر مبادرة "الحزام والطريق الرقمي" ، وعرض بديل عن النموذج الغربي، خاصة في الدول النامية.
المرحلة الحالية: "فصل اقتصادي انتقائي" وسيناريوهات المستقبل
مع إدارة بايدن، لم تتراجع الحرب بل أصبحت أكثر استراتيجية وتركيزًا. تم التخلي عن الخطاب العدائي العلني جزئيًا لصالح بناء تحالفات متينة ووضع سياسات طويلة الأمد. مفهوم "de-risking" (تقليل المخاطر) حل محل مفهوم "decoupling" (فصل الاقتصادين)، لكن الجوهر بقي قائمًا على فصل السلاسل التكنولوجية الحيوية عن الصين.
السيناريوهات المستقبلية المحتملة:
استمرار الوضع الراهن (أكثر احتمالاً): استمرار حالة "المنافسة الإدارية"، حيث يتعايش الاقتصادان في بعض القطاعات (السلع الاستهلاكية) وينفصلان في أخرى (التكنولوجيا المتطورة). ستشهد هذه الحالة استمرار الضغوط الأمريكية وحملات الاكتفاء الذاتي الصينية، مع تأرجح العلاقات بين فترات من التوتر والهدوء النسبي.
التصعيد: في حال حدوث أزمة جيوسياسية (مثل تايوان)، قد يتحول "الفصل الانتقائي" إلى فصل شبه كامل، مع عواقب اقتصادية عالمية كارثية.
التفاوض والانفراج (أقل احتمالاً في الأمد القريب): قد تؤدي التكاليف الاقتصادية المتراكمة على الطرفين (التضخم، اضطرابات سلاسل التوريد) إلى إحياء حوار ينتج عنه "هدنة تكنولوجية"، لكن الثقة المفقودة والصراع الاستراتيجي يجعلان هذا السيناريو ضعيفًا.
الخاتمة: صراع على شكل النظام العالمي القادم
لم تعد الحرب بين واشنطن وبكين مجرد نزاع تجاري يمكن حله بمفاوضات حول حصص الصلب أو فتح أسواق للسلع الزراعية. لقد كشفت هذه الحرب عن حقيقة أكثر جوهرية: إنها معركة أيديولوجية وجيوسياسية حول من سيسيطر على مفاتيح المستقبل التكنولوجي ويشكل نظام الحوكمة العالمي للقرن الحادي والعشرين.
الولايات المتحدة، من خلال هذه الحرب، تسعى إلى الحفاظ على نظام عالمي قائم على قيمها وقادتها. الصين، من جهتها، تدفع نحو نظام متعدد الأقطاب تعتبر فيه شريكًا رئيسيًا، إن لم يكن القائد، بمفاهيمها الخاصة للحوكمة والتكنولوجيا. في هذه المعركة، لم تعد الرسوم الجمركية سوى الضجيج السطحي لصراع أعمق بكثير: صراع السيطرة على العقل التكنولوجي للعالم، حيث أصبحت معامل الرقائق ومراكز البيانات هي ساحات القتال الجديدة.