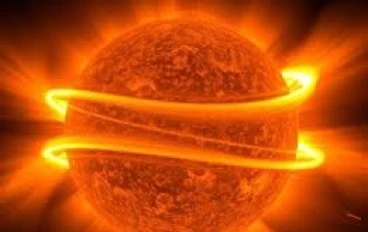شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد المقري (صاحب كتاب نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب)
الظاهرة التي تسترعى الكثير من التأمل أن الأسبان وجيرانهم الفرنسيين، طيلة الثمانية قرون التي حكم فيها العرب الأندلس أو(إسبانيا) لم يعنوا بكتابة تاريخ صراعهم مع العرب، بحيث أصبح الذين كتبوا تاريخ العرب في إسبانيا من المحدثين في الغرب أمثال بروكلمان ودوزي وآسين بلاثيوس لا يجدون المراجع التي يعتمدون عليها في كتابة تاريخ الأندلس. إلا فيما كتبه العرب أنفسهم سواء منهم من كان أندلسياً وعاصر فترة أو مرحلة من هذا التاريخ أو من كان من أهل المغرب كابن خلدون، ومن نتحدث عنه وهو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد المقري، صاحب كتاب نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب.
وليس من شك في أن السبب في ذلك، هو أن أوروبا لم تكن لتنهض، من خمودها وتستمر في تطورها وتقدمها لول دخول العرب إسبانيا واستمرارهم في حكمها منذ عهد الولاة، مرورا بعهد الخلفاء الأمويين وانتهاء عند عهد الطوائف..
ومع أن الفكر العربي في الأندلس، قد استطاع أن يتميز بقليل من الخصائص التي تعطيه طابعا خاصا به إلى حد ما، فإن هذا الفكر ظل منذ بداية عهد الخلفاء بدخول عبدالرحمن الداخل صقر قريش، وعلى الأخص في عهد عبدالرحمن الناصر الذي استمر حكمه خمسين عاما على التوالي، يعتمد على الفكر العربي في المشرق العربي الذي كان الخلفاء لا يترددون في استيراده كتبا من بغداد ودمشق، أو في استقدامه علماء لم يروا بأسا في الانتقال إلى الأندلس بعد أن تسرب إلى الحكم العباسي ما هو معروف من أسباب التدهور والضعف والانحلال.
ومن هذه الحقيقة يمكن القول دون افتئات أو تجن أو تزيد أن نهضة أوروبا مدينة للفكر العربي في المشرق أصلا وأن حكم العرب للأندلس، الذي استمر هذه القرون الطويلة، كان أداة الصلة التي أتاحت لأوروبا أن تنهض، وأن تلتمس سبيل استقلالها الفكري عن العرب بالالتفات إلى الأدب والفكر الإغريقي أو الروماني وأن تغريها الهرطقة وعدائها للإسلام بإنكار أثر العرب المباشر في نهضتها والإصرار على أنها مدينة لليونان والرومان، وقد ظلت تمعن في هذا الموقف بل ازداد تمسكها به عندما أصبحت الدولة العثمانية تهدد أوروبا كلها بعد استيلائها على النمسا، ولم تعترف أوروبا، أو بعض المستشرقين فيها بأثر العرب في النهضة، إلا في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي..
إن الإسبان لم يعنوان بتاريخ العرب في الأندلس وبمسيرة الفكر العربي وأثرها في حياة إسبانيا خاصة إلا في أواخر القرن الثامن عشر كبداية، وفي القرن التاسع عشر بشيء من التوسع والإفاضة، ثم في القرن العشرين، بعناية أكبر واهتمام لم يخل من روح الاعتدال والتوسط في الأحكام التي يصدرونها سواء بالنسبة للأحداث، أو بالنسبة للتلاقح الفكري بين أوروبا والعرب، عبر إسبانيا، خلال الحكم العربي.
وشهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد المقري صاحب كتاب نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب يعتبر أصدق مؤرخ للحكم العربي في الأندلس، وكتابه هذا يعتبر المرجع الأول وأوفى من المراجع العربية بما فيها تاريخ ابن خلدون ولذلك لا يكاد لا يخلو كتاب عن الأندلس في العصر الحديث، من الإسناد إليه فيما رواه عن الأحداث في الأندلس منذ عهد الولاة، إلى نهاية عهد الطوائف.
والعجيب أن المقري، الذي ألف أعظم وأوفى مرجع لتاريخ الأندلس لم يولد في الأندلس، ويرجح من كتبوا عنه أنه لم ير الأندلس رأي العين والسبب كما يقول الأستاذ على أدهم الذي كتب عنه نبذة في مجلة (تراث الإنسانية) هو أن المسلمين في عهد المقري، كانوا قد غلبوا على أمرهم في الأندلس وأخرجوا منها وطردت البقية الباقية منهم أو ذابت وفنيت في الكثرة الأندلسية ( يعني الإسبانية الغالبة).
ولد المقري، في قرية من قرى الجزائر بالقرب من تلمسان اسمها (مقرة) فهو ينتسب إلى القرية التي ولد فيها .. وكان موطن أسرته القديم، وعلى جارى العادة في اختلاف المؤرخين حول تاريخ مولد من يترجم لهم من الإعلام فإن هناك خلافا، حول تاريخ مولده، إذ بينما يقول بعضهم أنه ولد عام ألف الهجري، نجد من يقول: إنه ولد قبل الألف بثمانية أعوام.
ومع أن المقري، قد أرخ لكل رحلة من رحلاته وتنقله بين المغرب ومصر وبيت المقدس ومكة المكرمة ثم دمشق التي أتم فيها تأليف كتابه، فإنه لم يذكر شيئاً عن تاريخ ميلاده.. كما لم يذكر الأسباب التي جعلته يغادر تلمسان، إلى فاس وإقامته فيها، على عهد السلطان ( أبي المعالي زيدان السعدي) ولكنه يذكر لنا أن إقامته بفاس قد يسرت له الاستزادة من دراسة الفقه المالكي وهو المذهب الذي انتشر في الأندلس بفضل عبدالملك بن حبيب من الطبقة الثانية من العلماء الذين انتقلوا إلى الأندلس، وكانت الطبقة الأولى أو الرعيل الأول، بعض الصحابة والتابعين الذين كانوا جنودا في الجيش الذي فتح الأندلس.
ومع أننا نجده، يتولى الإمامة والخطابة لجامع القرويين، ثم يتولى الإفتاء ويبدو متمتعاً بحظوة لدى السلطان السعدي، فقد تظاهر بأنه يعتزم الحج ليتاح له السفر من المغرب، بعد أن نشب الخلاف إلى حد القتال بين زيدان السعدي الذي تولى الملك، وبين أخويه المأمون وأبي فارس، وساد العهد والبلاد من الاضطراب والفتن والدسائس ما جعل المقري يؤثر الابتعاد عن المغرب، وكأنه لم ينس، ما أصاب الكثيرين من أمثاله من العلماء والأدباء في الأندلس نتيجةلهذا الاضطراب والفتن والدسائس، ولعله قال: (ما أشبه الليلة بالبارحة !) فأثر العافية، فذهب لأداء فريضة الحج، ومنها اتجه إلى مصر حيث أقام فيها وتزوج من عائلة معروفة باسم ( البلدة الوفائية) .. وليس من شك في أنه كان قد عقد العزم على الاستقرار فيها، ولكن لم يجد فيها ما كان ينتظره من تقدير ولعله قد أهمل ولم يلتفت إليه أحد من علمائها وأكابر رجالها، فأحس بالغربة والوحشة وأنشد لنفسه (في كتابه نفح الطيب) ماعبر به عن مشاعره في مصر أبياته يقول فيها:
تركت رسوم عزى في بلادي *** وصرت بمصر منسى الرسوم
ونفسي عفتها بالذل فيها *** وقلت لها عن العلياء صومي
ولي عزوم كحد السيف ماض *** ولكن الليالي من خصومي
فغادر مصر إلى بيت المقدس، ولكنه عاد إلى القاهرة، والأرجح أن سبب عودته إليها هو ارتباطه بزوجته .. وأخذ يتردد على مكة والمدينة سبع مرات، وفي كل مرة يعود إلى مصر، رغم ما لقيته فيها من الهوان وعدم الاحتفال وخمود الذكر.
وعلى ما أصبح عادة له في الارتحال عن مصر كلما ضاق بخمول ذكره فيها غادر مصر في عام 1039إلى بيت المقدس، حيث أقام فيها خمسة وعشرين يوماً ولسنا ندري كيف بدا له أن يسافر إلى دمشق، فإذا به يجد من أهلها من الحفاوة والتكريم ما فاق حتى ما كان يلقاه في المغرب، وفي رعاية السلطان السعدي ولم يكن تكريم دمشق له، مناصب في القضاء أو الإفتاء أو التفاتة من الحكم، وإنما من عامة الناس، وفي مقدمتهم كبار علمائها، والأعلام من أدبائها وفقهائها..
وهو يروي أو يتحدث عن دمشق مايجعلك تشعر بحنينه إلى موطنه في المغرب، إذ يبدع في وصف رياضها وأنهارها وأزهارها وعطورها، حتى ليقول ( كنت قبل الحلول بالبقاع الشامية مولعاً بالوطن لا سواه فصار القلب بعد ذلك مقسماً بهواه .. ومحاسن الشام طويلة عريضة، وهو مقر الأولياء والأنبياء، ولا يجهل فضله إلا الإغمار الأغبياء).
ويقول من شهدوا أيام إقامته في دمشق أنه قد أملى بها صحيح البخاري في الجامع الأموي تحت قبة النسر بعد صلاة الصبح، ولما كثر الناس بعد أيام خرج إلى صحن الجامع حيث حضره غالب الأعيان من علماء دمشق، وكان يوم ختمه إملاء صحيح البخاري، كان يوماً مشهوداً، اجتمع لسماعه ألوف الناس وجاؤوه بكرسي الوعظ، فصعد عليه، وتكلم بكلام في العقائد والحديث بكلام لم يسمع نظيره قط.. وكان ذلك في اليوم السابع عشر من شهر رمضان عام ألف وسبع وثلاثين.. ومع ذلك لم تطل إقامته في دمشق أكثر من بضعة أسابيع، انعقدت له خلالها صداقات برجالها وأعيانها وفي مقدمتهم السيد أحمد بن شاهين الذي احتفى به منذ عام بمقدمه، إذ حرص على إكرامه وتفقده، وأشاد بذكره وعلو منزلته، مما جعل الناس يلتفون حوله، ويحرصون على الاستفادة من علمه طيلة الأسابيع التي أقامها في دمشق.
وفي دمشق، تبلورت فكرته عن تأليف كتابه، وذلك لما كان يدور بينه وبين السيد أحمد بن شاهين وغيره من أعيان الأدباء والعلماء فيها من أحاديث عن الأندلس، وعلى الأخص عن وزيرها ( لسان الدين بن الخطيب) الذي أفتى الفقهاء بقتله فخنق في سجنه بعد اتهامه بالزندقة وإثبات التهمة عليه، والذي لقب لقبا غريبا وهو (ذو العمرين) لأنه كان مصابا بالأرق، لا ينام من الليل إلا شيئا قليلا وكان هذا الأرق سببا في توفره على الكتابة والتأليف، فبلغ عدد ما ألفه من الكتب سبعة وثلاثين كتابا، فقد الكثير منها، ومن أهمها وهو موجود ( كتاب الإحاطة بتاريخ غرناطة) وقد كان يعيش ويلاحق طموحه إلى المجد في عهد ملوكها في بني الأحمر وهو آخر عهد الحكم العربي في الأندلس، وقد حقق من طموحه منازل عند ملوك بني الأحمر، تشبه كثيرا منزلة جعفر البرمكي في الخلافة العباسية وكان يمكن أن يتجنب النهاية الرهيبة التي انتهت بها حياته، لولا هذا الطموح الذي لا يقف عند حد.. وهو صاحب القصيدة المشهورة :
جادك الغيث إذا الغيث همي *** يا زمان الوصل بالأندلس
لم يكن وصلك إلا حلماً *** في الكرى أو خلسة المختلس
ونحن نرى في البيتين ما يشعرنا بأن صاحبهما بعيد عن الأندلس يشوقه الحنين إلى زمان قضاه فيه وحرم منه.. مع أن الرجل أندلسي ومن وزراء بني الأحمر في مملكة غرناطة .. وقد بلغ عندهم ما بلغه جعفر البرمكي من الجاه والنفوذ وتصريف شؤون الحكم، فكيف يتفق أن يغيب عن الأندلس وأن يتشوق إليها بهذا الشعر الذي ينبض حنيناً، ويشتعل لوعه على فراق يتمنى لو انتهى..
وهنا يتضح لنا سبب عناية المقري بابن الخطيب، وإفاضته في الحديث عنه في كتابه (نفح الطيب) عن هذا الوزير.. وذلك أن لسان الدين الخطيب اضطر في قصة طويلة إلى أن يغادر الأندلس وأن يقيم في تلمسان التي سبق أن قلنا أن المقري قد ولد في قرية من قراها اسمها (المقرة). ومن المغرب أخذ يحرض حكامها على غزو غرناطة مما أدى إلى مراحل أخرى من القصة الطويلةعاد خلالها ابن الخطيب إلى الأندلس وتمتع بالمزيد من الجاه والسلطان، ثم عاد فغادر الأندلس إلى فاس.. وهناك، لاحقه التآمر والدس عليه من جهة، وما سبق أن تورط فيه من التآمر على غزو غرناطة فألقى القبض عليه، وسجن في فاس حيث خنق في سجنه ثم دفن، ثم أخرج من القبر الذي دفن فيه في اليوم الثاني، وجمع على جثته ما يكفي لحرقها من أعواد الخشب، وأشعلت النار إلى أن احترق شعره، واسودت بشرته على مشهد من الناس، وعندئذ أعيد إلى الحفرة التي دفن فيها.
والمقري، مفتون بابن الخطيب، وبالفصول الطويلة من قصة حياته، وقد كان الحديث بينه وبين أعيان دمشق من الأدباء يدور حول هذا الوزير الشاعر المؤلف فاقترح عليه صديقه أحمد بن شاهين أن يؤلف كتاباعن ابن الخطيب.. ووافق المقري وشرع في التأليف بعد عودته إلى مصر، ويقول أنه تباطأ ، وساورته نفسه ألا يستمر، ولكن صديقه الدمشقي ظل يستحثه ويكتب إليه من دمشق يستنجزه وعده.. فعكف على التأليف إلى أن أتم هذا الكتاب الفريد وعلى الأخص فيما يختص بتاريخ الأندلس في آخر أيام العرب فيه.. والكتاب قسمان أحدهما عن الأندلس وفيه ثمانية أبواب والآخر عن لسان الدين الخطيب وفيه ثمانية أبواب أيضا.. والاسم الكامل للكتاب هو (نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين الخطيب).
ولكنا نجد في سيرته أنه اعتزم العودة إلى دمشق للاستقرار بها، وقبل أن ينفذ ما اعتزمه أصيب بمرض مفاجئ وتوفي وهو فيه في جمادي الآخرة عام ألف وواحد وأربعين ودفن بمقبرة المهاجرين في القاهرة.
وقد طبع كتاب المقري في مصر عام ألف ومئتين وتسعة وسبعين، واهتم به الذين كانوايعنون بأخبار الأندلس من المستشرقين وفي مقدمتهم دوزي .. ثم أعيد طبع الكتاب عدة مرات، وأحسن الطبعات هي تلك التي أشرف على تحقيقها الأستاذ محمد محيي الدين عبدالحميد، في عشرة أجزاء، وهو الذي حقق ونشر كتاب العمدة لابن رشيق مما يجعله يبدو متخصصا في تحقيق كتب مؤلفي المغرب العربي وهو جهد يستحق الكثير من التقدير.
المرجع:
كتاب جسور إلى القمة ، الطبعة الأولى 1981م، لعزيز ضياء