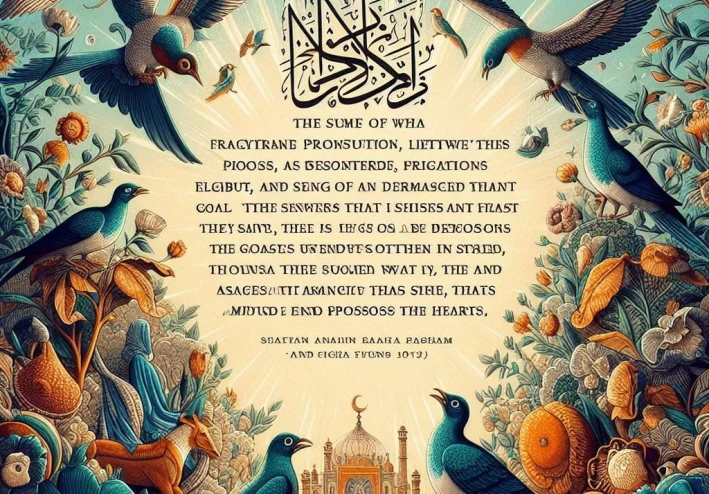
دورة المقامة : الهيكلة والبنى الوظيفية
المقامة شكل سردي ساخر اختلفت دلالته بين القدماء والمحدثين، فقد تلقاها الأولون بهالة من الإعجاب، ومجمل ما قالوه أنها تتضمن كل ما تشتهي الأنفس من لفظ أنيق قريب المأخذ بعيد المرام، وسجع رشيق المطلع والمقطع، كسجع الحمام، وجد يروق فيملك القلوب، وهزل يشرق فيسحر العقول أحسن تأليفاً وأعجب تصنيفاً، وأغرب ترصيفاً، وأشمل للعجائب العربية، وأجمع للغرائب الأدبية، وأكثر تضمناً لأمثال العرب، ونكت الأدب، وتذوب ظرفاً، وتقطر حسناً".
أما المحدثون فقد انعكست لديهم دلالة المدح إلى القدح، فالمقامة عند الكثيرين " كتاب في الظاهر، تافه في العمق، يتجاوز كل ما يمكن تصوره في مجال سوء الذوق، قطع مسجوعة، تحفظها الناشئة لتعليمهم اللغة بطريقة سطحية، تعتمد على صيغ لغوية طنانة فارغة من المعنى والمضمون ومجمل القول أنها ليست إلا مظهراً للقصور والانحطاط الخلقي والفني على السواء، وكان أصحابها قد ألجموا عقولهم، وأطلقوا ألسنتهم.
بهذا ظلت المقامة تنزلق من أفق دلالي إلى أفق دلالي آخر، وباتت تحلم شأ، مروثاتنا الحكائية بقارئ يرشحه النص ذاته لفك أغلاله، والوقوف على هيكله وبنيته وعناصره الموروفولوجية.
وسوف نركز على البنية الحكائية لمقامات الهمذاني التي لم تخلف شروحاً تذكر، بإزاء مقامات الحريري التي أفرخت ثمانية وعشرين شرحاً في حين أغفلت مقامات الهمذاني رغم ريادته الإبداعية، واعتراف الحريري وتابعيه بتلك الريادة.
لكننا سنبحث في هذه البنية عن الفعل ذاته لا عمن فعله أو كيف فعله، وسوف نبدأ بتحديد البنى الوظيفية في ترتيب مقاماته الإحدى والخمسين، ثم نثنى بدراسة بنيتها الكلية، لنكشف عن ترابطها لفظاً ومعنى، على عكس ما قرره الحصري القيرواني من أنه " لا مناسبة بين المقامتين لفظاً ولا معنى".
أن هيكلة المقامة تخضع لمنطق بنائي ينظم عناصرها " السردية" ويكشف تراتب التطورات في أفعال البطل، وأن المتن ينتظم في سلسلة من البنى الوظائفية المتعاقبة، تمثل دورة أفعال البطل ومعه الرواية.
والوقوف على هذه الدورة يجلى أمرين مترابطين أحدهما بنية الشخصية والآخر التطور الدلالي للمتن باعتباره نتاجاً لهذه الدورة، وسوف نرى أن كل مرحلة يمر بها البطل، تعبر دلالياً عن طبيعة مهمته وتتضافر لتمنح شخصيته سماتها الفارقة.
وحين نتتبع مراحل هذه الدورة تطوراً ودلالة، سوف نرى أن ثمة تواتراً في عدد من الثوابت، وأنها تنطوي على ثماني بنى وظيفية، تخضع لمنطق بنائي، يسير على مدرج تراتبي منذ البدء إلى النهاية، أي أن الوقائع تتعاقب زمنياً، دون تقطع أو إلحاق أو استباق بل دون أن يسمح لها بالارتداد أو التشتت، بحيث يمكن القول إن النمط البنائي الذي تخضع له هو " البناء المتتابع" نعني أن ثمة نسقاً من الوحدات الدلالية تتواتر وتتطابق بنية ودلالة مع نسق الوحدات الحكائية وأن شخصية البطل بقدر ما تتسم بسمات خاصة فإنها تغذى المتن بسماته الدلالية، وبهذا تتماثل أفعاله وصفاته مع مكونات المتن وخصائصه، الأمر الذي يجعل تلك الأفعال أجزاء مترابطة، تمنح المتن سماته، وتجعله إطاراً يوجه النظام العام الذي يحكم تلك الأفعال.
البنى الوظيفية:
يرتبط الراوي بالبطل بعلاقة دائرية تمثل كلما قلنا دورة المقامة، وهذه العلاقة تقوم على ثمانية أفعال وظيفية تمثل الهيكل الداخلي للمقامة، وهذه البنى هي "وصول" البطل، و" لقاؤه" بالراوي، و" تحايله" على الجمهور، وقيام الراوي بمكافأته، وتعرفه عليه" وتوبيخه"، ثم قيام البطل " بتبرير" حيلته، وأخيراً " افتراقهما" فلا يلتقيان إلا في مقامة أخرى.
وهذه العناصر الثمانية منها ما هو ثانوي، لا يظهر إلا في المسار السردي كالثلاثة الأخيرة ومنها ما هو ثابت كالوصول والتعرف، وهما جوهر الحركة المقاماتية، من حيث أن المقامة سلسلة من الأفعال تبدأ بوصول البطل متنكراً وتنتهي بتعرف الراوي عليه.
1-وصول البطل:
البطل دائماً في رحلة فهو سندباد " جوال" يظل يجوب المملكة الإسلامية، ثم ما يلبث أن يصل إلى إحدى المدن، وهذا الوصول بنية وظيفية تطرد في سائر المقامات ما عدا اثنتين هما الحادية والأربعون، والحادية والخمسون.
وثبات هذه البنية واطرادها من حيث أن الراوي مهما يتجول في فضاء الدولة الإسلامية، فلا بد أن يحل مدينة قد يصرح باسمها مثل " طرحتني النوى مطارحها، حتى وطئت جرجان الأقصى".
وهذا الوصول قد يكون داخلياً أي من موضع معين كالسوق مثلاً إلى موضع آخر في المدينة ذاتها، وقد اطرد ذلك إحصائياً في ثلاثُ مقامات، هي الرابعة والعشرون، والتاسعة والعشرون، والرابعة والثلاثون، كما أنه قد يكون خارجياً أي من موضع خارج المدينة، إلى موضع داخلها، وقد انحصر ذلك في اثنتين فقط هما الخامسة والعشرون، السادسة والعشرون. وقد يصل من موضع داخل مدينة إلى موضع داخل أخرى وقد انحصر ذلك في ثماني مقامات فقط هي الثانية، والسابعة، والحادية عشرة، والسابعة والثلاثون، والتاسعة والثلاثون، والثامنة والأربعون، والتاسعة والأربعون، والخمسون.
وقد يصل من مدينة إلى مدينة، ثم إلى موضع داخل هذه الأخيرة، وقد انحصر ذلك في ثلاث مقامات هي السابعة والعشرون، والثلاثون، والثالثة والثلاثون وقد يترحل عن مدينة إلى أخرى دون أن يدخلها، وقد اطرد ذلك في سائر المقامات ما عدا اثنتين هما الحادية والأربعون والحادية والخمسون.
2-اللقاء:
لقاء البطل بالراوي عنصر ثابت يطرد في سائر المقامات ما عدا اثنتين هما الحادية والأربعون والحادية والخمسون، وثبات هذا الفصل واطراده من حيث أن الراوي ما أن يصل موضعاً حتى يلتقى بالبطل متنكراً.
وهذا اللقاء تختلف مواقعه، قد يتم في مكان واحد قبل الحكى، وقد انحصر ذلك في ست مقامات هي الأولى، والسابعة، والعاشرة، والخامسة عشر، والرابعة والعشرون، والخمسون.
وقد يقع في موضع يكون الراوي فيه ثم يقدم عليه البطل، وقد انحصر ذلك في خمس عشرة مقامة هي الثالثة، والخامسة، والتاسعة، والثالثة عشرة، والسابعة عشرة، والثامنة عشرة، والتاسعة عشرة، والثامنة والعشرون، والتاسعة والعشرون، والحادية والثلاثون، والثالثة والثلاثون، والتاسعة والثلاثون، والسادسة والأربعون، والسابعة والأربعون، والثامنة والأربعون.
وأحياناً ينعكس الوضع فيكون البطل في مكان معين، ثم يقدم عليه الراوي، وقد انحصر ذلك في أربع عشرة مقامة هي الثانية، والرابعة، والسادسة، والثانية عشرة، والسادسة عشرة، والعشرون، والثلاثون والسابعة والثلاثون، والثالثة والأربعون، والتاسعة والأربعون.
وقد يتم هذا اللقاء بعد الحكي ولم يطرد ذلك إلا في اثنتي عشرة مقامة هي الثامنة، والحادية عشرة، والرابعة عشرة، والحاديثة والعشرون، الثانية والعشرون ، والثانية والثلاثون، والرابعة والثلاثون، والخماسة والثلاثون، والسادسة والثلاثون، والثامنة والثلاثون، والأربعون، والخامسة والأربعون.
3-الحيلة:
قيام البطل بحيلة تخدع الجمهور عنصر يطرد في جميع المقامات ما عدا واحدة فقط، هي الحادية والخمسون، وهذا الاحتيال قد يكون لفظها، وقد يكون فعلياً، فالأول خطبة مثلاً، وقد اطرد ذلك في ثمان وثلاثين مقامة أي في المقامات جميعها ما عدا أربع عشرة، هي الرابعة ، والعاشرة، والثانية عشرة والسادسة عشرة، والعشرون والحادية والعشرون، والثالثة والعشرون، والسادسة والثلاثون، والتاسعة والثلاثون، والثانية والأربعون، والتاسعة والأربعون، والخمسون والواحدة والخمسون، والثانية والخمسون.
أما الاحتيال السلوكي فينحصر فقط في عشر مقامات ، هي الرابعة، والعاشرة، والثانية عشرة، والعشرون، والحادية والعشرون، والثالثة والعشرون، والسابعة والثلاثون، والثانية والأربعون، والتاسعة والأربعون ، والخمسون.
وقد يجمع الاحتيال بين المظهرين اللفظي والسلوكي، كما في المقامتين السادسة عشرة، والتاسعة والثلاثون.
4-المكافأة:
مكافأة البطل من قبل الجمهور أو الراوي عنصر يستغرق جميع المقامات ما عدا المقامة الأربعين، وليس ببعيد أن تكون المكافأة قد وردت في المقامتين الثلاثين، والثانية والثلاثين التي حذف الشراح أجزاءها الأخيرة لاعتبارات خلقية، وضرورة هذا العنصر من حيث أنه مرتب على نجاح البطل في حيلته، فهذا النجاح مشفوع غالبا بالمكافأة.
أما نوع هذه المكافأة وطريقة تقديمها فيختلف وفقا للطلبة العارضة، فقد تكون نقدية يقدمها له الراوي نفسه إذا لم يتعرف عليه، وقد انحصر ذلك في ثلاث عشرة مقامة، هي الخامسة، والسادسة، والثامنة، والتاسعة، والعاشرة، والسادسة عشرة، والأربعين، والخامسة والأربعين، والسادسة والأربعين.
وقد يوم الحاضرون أنفسهم بمكافأته، إذا ما اكتشفه الراوي، وقد انحصر ذلك في ثلاث مقامات فقط هي الأولى، والثالثة، والرابعة.
وهذه المكافأة قد تكون مادية محددة ومصرحا بها طعاماً أو ثياباً – رداء مثلا أو جلباب نوم – وقد انحصر ذلك في تسع مقامات هي الثانية، والثانية عشرة، والخامسة عشرة والسابعة عشرة، والتاسعة والعشرون، والحادية والثلاثون، والرابعة والثلاثون، والخامسة والثلاثون، والسادسة والثلاثون. كما أنها قد تكون معنوية كأن يتمنى عليه فيلبي طلبه، كما في المقامتين الحادية عشرة، والثامنة والثلاثون وقد يكافأ بالمال والثياب، وقد ورد ذلك في أربع مقامات هي الثالثة عشرة والحادية والعشرون، والسابعة والثلاثون، والثانية والأربعون.
وقد تكون المكافأة غير محددة، وإنما تشير إليها عبارة احتمالية مثل" وانهالت عليه العطايا" وقد ورد ذلك في ست مقامات، هي الخامسة عشرة، والعشرون، والسابعة والعشرون، والثامنة والعشرون، والثانية والأربعون، والثامنة والأربعون.
وقد تكون المكافأة معنوية كأن يحقق طلبته بالرحيل مثلا عن التاجر البغدادي كما في المقامة الثانية والعشرين وهي " المضيرية"، حيث الإسكندري بديل الراوي، وحيث صاحب المضيرة، بديل أبي الفتح.
وكما تكون المكافأة مصرحا بها، فقد تكون ضمنية، وقد ورد ذلك في سبع مقامات هي الرابعة والعشرون، والخامسة والعشرون والسادسة والعشرون، والثالثة والثلاثون والتاسعة والثلاثون والسابعة والأربعون والتاسعة والأربعون.
5-التعرف:
تعرف الراوي على البطل عنصر ضروري يستغرق جميع المقامات، ما عدا ثلاثة فقط هي الحادية والثلاثون، والحادية والأربعون، والحادية والخمسون، وضرورة هذه البنية من حيث أنها مرتبة على البنية السابقة إذ أن البطل ما أن يكافأ حتى يكتشفه الراوي.
التعرف قد يتم دون طلب من الراوي ولكن بعد تفحصه في الظلمة أو الزحام، وقد ورد ذلك في ست وعشرين مقامة هي 1، 4، 5، 6، 8، 9، 10، 12، 16، 17، 18، 19، 20، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 30، 32، 35، 37، 38، 45، 49.
كما أنه قد يتم بطلب من الراوي أو الحضور، وقد اطرد ذلك في ثماني مقامات هي 2، 3، 15، 33، 39، 40، 47، 50 وقد يبادر البطل دون طلب ، للتعريف بنفسه كما في المقامة (14)، وفي كل ما ذكر من مقامات يقع التعرف بصيغة لغوية صريحة، أما ما دون ذلك فقد وقع دون تصريح وذلك فقط في أربع هي 11، 13، 44، 46.
6-التوبيخ:
قيام الراوي بتوبيخ البطل عنصر يستغرق جميع المقامات ما عدا إحدى عشرة هي 7، 12، 21، 22، 30، 31، 34، 36، 38، 48، 51، وضرورة هذا العنصر وثباته في دورة المقامة من حيث أن الراوي ما أن يكتشف أبا الفتح المتنكر والمعروف لديه حتى يلج في توبيخه، وهذا التوبيخ قد يقع إشاريا أي في صيغة ضمنية غير مصرح بها وقد ورد ذلك في أربع عشرة مقامة هي 6، 9، 11، 13، 15، 24، 28، 40، 41، 42، 43، 44، 46، 50.
وقد يقع في صيغة لفظية صريحة مثل" ويح" المسبوقة باستفهام إنكاري مثل:" " ما هذه الحيلة ويحك" وقد اطرد ذلك في ست عشرة مقامة 1، 2، 3، 4، 8، 10، 16، 18، 19، 20، 25، 27، 29، 35، 39، 45، ومرة يقع في صيغة تعجب مثل " شد ما بلغت منك الخصاصة وهذا الزي خاصة" وقد اطرد ذلك في أربع مقامات هي ، 35، 33، 47، 49، وقد يجمع بين الصيغتين كما في المقامتين 14، 17 أو في صيغة استفسار وقد ورد ذلك في أربع مقامات ، 23، 26، 32، 37 .
7-التبرير:
تبرير البطل فعلته التنكرية عنصر يستغرق جميع المقامات ما عدا عشرة فقط وضرورة هذه البنية واطرادها في دورة المقامة من حيث أن البطل ما أن يوبخه الراوي على سلوكه الشائن حتى يسارع بتبريره فإذا به يدفع اللوم عن نفسه ويلقي التبعة على الزمان وقد اطرد هذا العنصر في تسع مقامات 1، 2، 10، 18، 19، 20، 21، 27، 29 وكما أنه قد يقر احتياله بدعوى أنه جوهر التخفي، وقد ورد ذلك في ثلاثة عشرة مقامة ، 3، 4، 5، 8، 15، 16، 24، 25، 35، 40، 46، 49، 50، وربما قام الراوي نفسه بمهمة التبرير كما في المقامتين 6، 7.
وفي هذه المقامات جميعا جاء التوبيخ صريحا بينما جاء ضمنيا في عشر مقامات هي 9، 11، 13، 14، 26، 33، 37، 43، 44، 45، وكما ييقع التبرير من البطل بصيغة لفظية مسموعة فقد
يقتصر على سكوته إما برفضه الإجابة على سؤال الراوي، كما في المقامتين 17، 28 أو بصمته كلية وعدم الرد عليه وقد ورد ذلك في أربع مقامات هي 23، 32، 39، 48.
8-الافتراق:
ما أن يبرر البطل احتياله حتى يفارق الراوي، ولم يرد هذا العنصر في المقامة 41، كما أنه لم يصرح به إلا في إحدى وعشرين مقامة ، 4، 7، 13، 17، 21، 22، 27، 28، 30، 31، 33، 34، 39، 41، 42، 43، 44، 47، 48، 49، 51.
المقامة القردية أنموذجاً:
من الواضح أن دورة المقامة تطرد في نظام تراتبي ثابت تمثله هذه العناصر الثمانية، ولكي نكشف إجرائياً عن اطراد وثبات هذه الدورة نأخذ الآن في تفكيك المقامة القردية للهمذاني:
" حدثنا عيسى بن هشام قال: بينا أنا بمدينة السلام، قافلاً من البلد الحرم، أميس ميس الرجلة على شاطئ الدجلة، أتأمل تلك الطرائف، وأتقصى تلك الزخارف".
المتحدث إليه هنا وهو " نا المفعولين" يشير إلى عنصرين، الأول" مروى له" مجهول، والثاني" الراوي" وهو عيسى بن هشام "، وقد تحدث بضميرر المتكلم ومن خلال جمل قصيرة مكثفة، وهذا الضمير بقدر ما يجنب الراوي أية إشارة تنبؤية لما يحدث، فإن له مهمة إخبارية، وهي " النقل عن، وليس" المعاينة" أو التماهي أو الاشتراك في الحدث، فهو إذن راو مفارق ضرورة أنه محدث بصيغة اسم المفعول أي سامع حديثاً".
وفضلاً عن أن الراوي مفارق، فهو " جوال" إذ يبدو هنا وقد ألقى عصا التسيار، ووصل إلى مدينة محددة هي" بغداد"، وموضع محدد منها هو شاطئ دجلة.
ولغاية محددة هي التأمل والوصف، ثم إنه نضو أسفار، ضرورة أنه رحال، فها هو ذا عائد لتوه من مدينة أخرى هي مكة المكرمة وبعد مهمة محددة هي الحج.
فإذا جئنا إلى " آليات السرد" ألفينا أنها تقوم على التكثيف والإيجاز، فضلاً عن الحبكة والتشويق، فهو أولاً يصف هذه المشاهد بصيغة الجمع، إذ هي " طرائف" وليست طرفة، وبهذه الصيغة يخلق لدى " المروى له" أفق توقع أو ترقب لمتوالية من المشاهد، ثم إنه ثانياً يعتمد اختزال المشهد، فيقتصر منه على لقطة عامة، كما يوحى بذلك تنكيره لفظة " رجال"، دون أن يعرفها أو يفصل حواشي القصة وإنما اكتفى بهذه اللفطة :" إذ انتهيت إلى حلقة رجال مزاحمين يلوى الطرب أعناقهم، ويشق الضحك أشداقهم، فساقني الحرص إلى ما ساقهم"، وبهذا الاقتضاب يمعن في الحبكة كيما يهيء لصفة أخرى توسع أفق التوقع.
ولكي يشد " المروى له" ويزيده تعلقاً يعمد إلى تخصيص المشهد، وتضبيبه ، إذ ينقل إلى الأذن لا إلى العين وما راء كمن سمعا:" حتى وقفت بمسمع صوت رجل دون مرأى وجهه، لشدة البهجة، وفرط الزحمة".
بدهي والراوي جزء من الواقعة أن يصف المشهد بعينه لا بأذنه، وأن ينقله على هذا النسق التتابعي، فهو لم يسمع الوقائع فقط حتى يحكيها، ولكنه ينقلها كما ارتسمت في باصرته، وسجلتها مسلسلة ومتنامية، حتى لحظة التعرف حيث النهاية ثم الافتراق.
ومن الواضح أن الراوي يمثل عنصراً أساسياً في نسيج الحكاية، وبدونه تختل، وتبدو أخباراً مجردة، دون بنية سردية تنتظم عناصر الحكي وتوجهها. وعلى هذا النحو يظل الشريط السردي يسير بالمروي له على مدرج تصاعدي، فيتجه من التعميم إلى التخصيص، ومن محيط الحلقة إلى مركزها، ومن الأذن إلى العين، ومن وصف المكان نفسه إلى وصف محتواه، حيث الزحام يصببه ويحجب الرؤية، وبهذا يزيد شوق المتلقي إلى اختراقه، ويصعد من لهفته فإذا ما أوصله إلى هذه الحالة أخذ ينقل عياناً بدلاً من السماع، وإذا بسلسلة من الوقائع تترى لتعمق إحساس المروى له بتدافع هذه الحشود بعد أن عجزت الأذن عن اختراقها، وعندئذٍ تقع المفاجأة إذ يتعرف على البطل:" فإذا هو قراد يرقص قرده، ويضحك من عنده".
وحين يقتصر على هذه اللقطة الموجزة دون أن يستطرد في الوصف، فلأن الأهمية ليست في المشهد ذاته، ولكن في الانفعال الذي يثيره، ولذا يركز على صفة الشخص دون هويته، إنه فقط " قراد": فالراوي يندفع راقصاً مترنحاً يتمايل يمنة ويسرة، ثم يقفز فوق الرقاب، فتخطفه الأيدي، وما تزال تتداوله، حتى يستقر خجولاً منهكاً أمام " قراد" يفترش لحية رجلين جلسا خلفه".
فلما فرغ القراد من شغله، وانتفض المجلس عن أهله، قمت وقد كساني الدهش حلته، ووقفت لأرى صورته"، إلى هنا يصل الحكى ذروته، ثم يبدأ التعرف فتكون المفاجأة أن هذا القرد المجهول معروف لديه، وعندئذٍ يصيح من هول المفاجأة :" فإذا هو والله أبو الفتح الإسكندري" !!
وإزاء دهشته من تنكر من يعرفه وبراعته في التخفي والخداع والتمويه المستمر، يتوجه إليه بخطابه باخعاً نفسه، " موبخاً" مستنكراً:" فقلت: ما هذه الدناءة ويحك؟".
بدهي أن تدفعه خيبة أمله في " معرفة " هذا المتنكر إلى ادرائه واللجاجة في توبيخه، إذ كيف لفصيح مثله أن يتبذل ويتحامق ويتقوت من هذه الكدية، وهنا يأتيه " التبرير" أشد وطأ من التوبيخ، وأقوم قيلاً من اللوم:
الذنب للأيام لالى *** فاعتب على صرف الليالي
بالحمق أدركت المنى *** ورفلت في حلل الجمال
إذ لا تثريب عليه وإنما التثريب على دهر يغبن الأديب، ويرفع الحمقى والمغفلين، وعندئذٍ " يفترقان" فلا يلتقيان إلا في مقامة تالية.
الأنماط البنائية
في سياق هذه الدورة ذات العناصر الثمانية يمكن تصنيف المقامة إلى ثلاثة أنماط ترتبط بتمام هذه الدورة أو نقصانها، وهذه الأنماط هي المقامة كاملة الدورة، والمقامة الناقصة ثم الشاذة.
أولا:
فالمقامة الكاملة هي التي تطرد في دورتها هذه العناصر الثمانية، والنسق العاملي الذي ينتظمها وهو الرواية والبطل وهذه الدورة تبدأ بتجوال الراوي في المدن الإسلامية، ثم " وصوله" إلى موضع معين حيث " يلتقي" ببطله يتحاول متنكراً يخطب و" يكدى" ، وبعد لأي " يتعرف " عليه ثم " يوبخه" على سلوكه، وأبو الفتح" يبرره" ثم " يفترقان" ولا يزالان كذلك إلى أن يلتقيا في مدينة أخرى وداخل مقامة جديدة.
هذا النمط ينطوي إذن على الأفعال الثمانية ونسقها العاملي الذي يمثله عيسى راويا، وأبو الفتح بطلاً، وبهذا تختلف عن الأنماط الحكائية الأخرى، إذ أن الذي يثبت في هذه الأخيرة هو الوظائف أو البنى السردية دون الأشخاص، أو النسق العاملي كاملاً، فالبطل قد يتغيب في المقامة، وإن كان غيابه على المستوى الأسمى فقط، دون الفعل أي على المستوى الخطابي دون الحكائي.
فأفعاله قد يؤديها بدلاؤه مثل" عصمة بن بدر الفزاري" كما في المقامة السابعة، أو راويته عيسى كما في المقامة الثانية عشرة، أو " التاجر البغدادي" كما في المقامة الثانية والعشرين، أو " الرجل الحذقة" كما في المقامة الرابعة والثلاثين، أو أبي العنبس الصيمري كما في المقامة الثانية والأربعين، فهؤلاء جميعاً نابوا عن البطل الغائب في دوره المحوري الذي كان منوطاً به.
ثانيا:
أما المقامة الناقصة فهي التي لا تطرد فيه هذه العناصر الثمانمية المذكورة، ولم يرد هذا النمط إلا في المقامتين الحادية والثلاثين، والحادية والأربعين، فالأولى وهي المغزلية تتضمن فقط ثلاث عناصر وظيفية، هي الوصول، اللقاء، الحيلة، كما أنها تفتقد ثلاثة عناصر مقاماتية هي التعرف، والبطل والكدية، وقد انعكس ذلك على تراكيبها، فجاءت قصيرة على المستويين الوظيفي والخطابي.
أما المقامة الأخرى وهي" الوصية" فمحورها وصية أبي الفتح لابن له أراد احتراف التجارة، وبالرغم من اطراد نسقها العاملي – الراوي والبطل – إلا أنها تخلو من النسق السردي الذي يميز النمط الأول وليس بها ما يدرجها في سلك المقامات إلا ثلاثة عناصر، هي السجع والكدية ونسبة الخطاب إلى عيس راوياً وأبي الفتح بطلاً.
وعلى أساس هذه الثلاثة أرجع الحصري مقامات الهمذاني إلى الأربعين حديثاً لابن دريد، بخاصة أن الهمذاني نفسه يطلق كلمة " مقامة" لتشير إلى معنيين، الأول" خطابات وحيل الإسكندري" كما يبدو من مناظرته مع أبي بكر الخوارزمي، وأما الثاني فهو سياق المقامة كما يبدو من صفتها المحددة في العنوان الافتتاحي.
وتبعا للاستعمال الأول تندرج " مقامة الوصية" تحت مصطلح " مقامة" إذ ليست سوى خطاب ينطق به الموصى وهو أبو الفتح، وهي بهذا ترادف العرض أو الحيلة الأدبية التي يقوم بها البطل، لكن الأمر يختلف مع الاستعمال الثاني، لأن " الوصية" تخلو من السياق اللفظي الذي ورد فيه الخطاب، ولهذا تخرج من دائرة المقامة، كما يخرج كل ما عد مقامة عند الحصري كالوصية والمغزلية مع أنهما " يندرجان في المقامات الناقصة لأنهما فقط اللتان تخلوان من البنية السردية الثابتة في مجموع المقامات ذات الدورة الكاملة.
وإذا قيمنا مقامات الهمذاني بإزاء نظيرتها عند الحريري، ألفينا قول الشريشي :" مقامات الحريري أحفل، وأجزل، وأكمل من بعض مقامات الهمذاني" فالصيغة التفضيلية أكمل" قد تعني اكتمال البنية السردية، واتساقها، وهي الصفة الغالبة على مقامات الحريري ما عدا " الساسانية"، فهي تلتقي مع المقامة الحادية والأربعين للهمذاني، فكلتاهما وصية من بطل إلى ابنه، وذلك على عكس مقامات الهمذاني التي تفتقد هذا الاتساق البالغ.
ثالثا:
واما المقامة الشاذة، فهي التي تنطوي على بنية سردية ثابتة، ونسق عاملي كامل، ولكنها فقط تخلو من السجع، كما في المقامة" البشرية" فبشر بن عوانة العبدي" ينتحل شخصية الإسكندري، ويؤدي دور البطل في السرديات الشعبية مثل سيرة عنترة والشاهنامة.
فبشر هذا هو صعلوك نبذته قبيلته، يسبى في إحدى غاراته امرأة جميلة وبعد أن يتزوجها تعرض عليه ابنة عمه بدعوى أنها أجمل منها، وحين يخطبها من أبيها يرفضه وعندئذٍ يتحرش بالقبيلة إلى أن يرضخ عمه، مشترطاً عليه أن يمهرها ألف ناقة من نوق بني خزاعة، وحين يرتحل بشر في طلب النوق يعترضه أسد يفزع حصانه، فيقطع البطل قوائم الحصان، ثم يصرع الأسد، ويكتب بدمه على قميصه قصيدة، تصف شجاعته، وشغفه بابنة عمه، وعندئذٍ يفزع أبوها، ويسلمه ابنته، وفي أثناء عودتهم يعترضهم غلام أمرد، يمتطي حصاناً، ثم يتصدى لبشر ينازعه حبيبته طالباً أن يبارزه، فينبري له بشر ولكن" عشرين ضربة في كليته، وعشرين بعرض السيف" جعلتهت يستسلم، وكانت المفاجأة حين طلب من الغلام أن يكشف عن نفسه، أنه ابنه من المرأة التي سباها، وعندئذٍ يسلمه حبيبته، ويقسم ألا يركب بعدها حصاناً وألا يتزوج حصاناً.
هذه المقامة تنطوي فقط على ثلاث بنى وظيفية، هي اللقاء والحيلة والتعرف كما أنها شاذة على المستويين الخطابي والحكائي، فهي تغلق البنية السردية الكلية للمقامات كما أن البطل ، أو بالأحرى بديله، بعد أن يكشف عن نفسه يقسم ألا يعود سيرته الأولى، وعندئذٍ تغادر البنية إلى غير رجعة.
هذا النمط الشاذ ينحصر فقط في مقامة واحدة هي الحادية والخمسون، لأن هذه المقامات جميعا ما عدا المقامات 31، 41، 51 ذات بنية سردية ثابتة، ولكن بعضها استبدل بأبي الفتح، بديلاً يحمل صفاته ويؤدي دوره، كما أن بعضها أسقط الشراح بنيته السردية لاعتبارات خلقية.





































