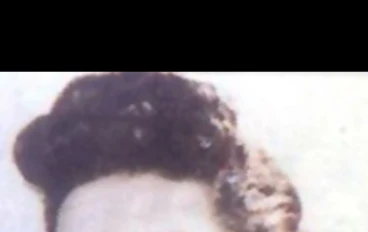الدين في العصر الرقمي العالمي
تعمل جميع الأديان في المجتمعات الغربية العلمانية والديمقراطية المعاصرة على مبدأ حرية المعتقد. إذ ان بعد انتصار التنوير، أصبح الإيمان مسألة خاصة تهم الفرد وحده دون غيره. كما تعني حرية المعتقد أن لكل فرد الحرية في تصديق ما يختار أن يؤمن به، بالإضافة إلى تمتعه بحرية تنظيم حياته الشخصية والخاصة وفقًا لمعتقداته التي يؤمن بها. في مقابل هذه الامتيازات التي يتمتع بها الفرد تحت راية حرية المعتقد فإنه يُحظر عليه فرض إيمانه ومعتقداته في المجال العام وعلى مؤسسات الدولة.
فالتغييرات التي أحدثها التنوير في المجتمعات الغربية لم تؤد إلى اختفاء الدين ولكن أدت إلى خصخصته وحصره في المجال الخاص. وفي ظل ظروف العالم العلماني المعاصر، أصبح الدين مسألة ذوق شخصي، مثله مثل الفن والتصميم. هذا لا يعني أنه لا يمكن أن يكون موضوع نقاش، لكن أصبح له نفس مكانة الفن كما وصفها كانط في نقد ملكة الحكم: حيث يمكن أن يكون الدين قد تمت مناقشته علنًا، لكن بشرط ألا يؤدي إلى أي نتيجة تكون ملزمة للمشاركين في هذا النقاش أو للمجتمع ككل. إذ لا شك أن الالتزام بعقيدة دينية أو بأخرى هو قرار شخصي وسيادي لا يمكن أن تمليه أي سلطة عامة، بما في ذلك السلطات الديمقراطية المنتخبة شرعياً. لكن قبل كل شيء، مثل هذا القرار - كما هو الحال مع الفن - لا يحتاج إلى الدفاع عنه في وجه العالم. وبدلاً من ذلك، من المفترض أن يتم قبوله اجتماعيًا دون الحاجة إلى أي تفسير. إذ لا تستند شرعية المعتقدات الشخصية إلى قوتها في الإقناع، بل هي تستند على الحق السيادي لكل فرد في قبول أو رفض تلك المعتقدات.
العلم، من ناحية أخرى، هو شأن عام أيضا. إذ تعد المعرفة التي تم الحصول عليها وصياغتها وتقديمها علميًا ضرورية لحكم الديمقراطيات الغربية الليبرالية المعاصرة الناتجة عن عصر التنوير. كما أشار إلى ذلك ميشيل فوكو مرارًا وتكرارًا، في زمن الحداثة، تسير المعرفة العلمية جنبًا إلى جنب مع القوة. وتعتمد التكنولوجيا الحديثة على علوم مثل الفيزياء والبيولوجيا، وتستند الممارسة الحديثة للحوكمة على العلوم الوضعية مثل القانون والعلوم السياسية والاقتصاد وعلم النفس وعلم الاجتماع. كل هذا يعني أنه لا يمكن أن تكون هناك حرية علمية بنفس معنى حرية المعتقد. في المناقشة العلمية، يمكن بل ويجب تبرير جميع الآراء أو دحضها على أساس حقائق معينة، باستخدام قواعد محددة .
من المؤكد أن الجميع أحرار - على الأقل من الناحية النظرية - في صياغة موقفهم والدفاع عنه. لكن صحة الرأي العلمي لا يمكن أن تستمر دون تفسير، وإذا كانت لا تخضع لمنطق الأدلة، أو كانت دون حجج معقولة ومقنعة.
لذلك يوجد اليوم نوعان من الحريات في المجال الثقافي العملي. الأول هو حرية الرأي العلمي الذي يعتمد القدرة على تبرير الرأي باللجوء إلى بعض القواعد المعمول بها علنًا وبالتالي تعتبر هذه الحرية حرية مشروطة.
والثانية، حرية المعتقد، وهي حرية غير مشروطة وذات سيادة لأنه من المستحيل إثبات أن إيمان الشخص خاطئ، أكثر مما يمكن إثبات أنه إيمان مؤسس. بعبارة أخرى، يشكل الدين كله تمثيلًا اجتماعيًا وسياسيًا لعدم المعرفة الفردية والخاصة. لذلك تميل أيديولوجية التنوير إلى اقتراح أنه في يوم من الأيام سيتم استبدال مجال اللا معرفة بمعرفة متكاملة أو بعبارة أخرى سيتمكن العلم من الإجابة على أي سؤال يمكن طرحه في المستقبل.
الدين يقدم منظورًا مختلفًا عن العلم، حيث يركز على القيم الروحية والأسئلة التي تتجاوز الإدراك العلمي المباشر . وهكذا فإن الله وإرادته يقعان خارج عالم المعرفة. إذ يفلت الله من كل عقلانية لأنه صاحب السيادة وليس مطالبًا بشرح أو تبرير أفعاله وقراراته. هذه الإرادة الإلهية الحرة ذات السيادة تتجاوز كل اليقينيات والأدلة وحتى كل قناعات العقل.
لذلك ، فإن المتدين وحده هو المتشكك حقًا: فهو لا يؤمن حتى بالأدلة المباشرة ، ولا يُخضع معتقداته لقوة حجة أفضل. بالنسبة له، العالم ليس كائن سطحي يجب استكشافه علميًا، ولكنه يشكل واجهة، خارجية تخفي وراءها الذاتية الإلهية. أما العلاقة بين الفاعل الديني والله هي نفسها العلاقة بين المتفرج والفنان. إذ أننا في الواقع نحب العمل الفني على وجه التحديد لأننا لا نفهمه. ويحدث الإيمان بنفس طريقة القرار الذي يمليه الذوق.
بهذه الطريقة يمكن إذن وصف الفرق بين العلم والدين بأنه الفرق بين إنتاج الحقيقة واستهلاكها. وهذا يفسر سبب انتشار الموقف الديني في المجتمع المعاصر، الذي يتميز في نهاية المطاف بكونه مجتمع استهلاكي في المقام الأول
يتعرض بصفة مستمرة للتحدي وتهاجمه جميع أنواع الحقائق من جميع الجوانب.
ويتعرض للهرسلة من قبل أناس عدوانيون، ومندفعون ، ويبذلون قصارى جهدهم للترويج لأنفسهم، وغالبًا ما يكونون مرعوبين. يخبروننا أن المناخ يزداد دفئًا وأننا سنموت جميعًا معًا في المستقبل القريب ، أو أن موتًا وحيدًا ينتظرنا بسبب التدخين أو الكوليسترول أو الإرهاب او الكورونا أو أي شيء آخر. هذه الحقائق وغيرها الكثير يتم إنتاجها ونشرها من قبل وكالات ومنظمات غير شخصية.
هذه الحقائق التي تتطلب منا قبولها يتم نقلها إلينا في الغالب من خلال وسائل الإعلام ، وخاصة الإنترنت. حتى أنه أصبح الفضاء الإلكتروني المصدر الأساسي للمعرفة في العالم المعاصر والوسيلة الرئيسية للاتصال به. علاوة على ذلك ، لا يتم تشغيل الإنترنت من قبل أي هيئة عامة. إنها مساحة عامة تشغلها المصالح الخاصة والسيادية. والمعلومات التي تأتي إلينا من الإنترنت ليست نتيجة مناقشة عقلانية عامة . فلكل مستخدم الحق المطلق في نشر أي رأي وأي معلومات لم يتم التحقق منها على الويب ، ودون الحاجة إلى تبرير ذلك. لقد أصبحت ، الإنترنت اليوم هي الوسيلة الرئيسية التي من خلالها يغزو المجال الخاص الفضاء العام. علاوة على ذلك، مثل جميع وسائل الإعلام المعاصرة ، لا يميز الإنترنت بين الحقائق الدينية والعلمية.
في الأيام الخوالي، كانت الحركات الدينية تستخدم عادةً النصوص المطبوعة والصور المرسومة والنحت لتوصيل رسالتها. أما في العقود الأخيرة ، أصبح الفيديو - الذي يتم بثه على التلفزيون والإنترنت ونوادي الفيديو وغير ذلك - وسيلة اختاروها لبث الدعاية. ينطبق هذا بشكل خاص على الحركات الدينية الأحدث والأكثر نشاطًا والأكثر عدوانية ، والتي تنشط في الغالب على الإنترنت باستخدام الاستنساخ الرقمي بدلاً من الاستنساخ الميكانيكي. تستخدم الحركات الإنجيلية ، على وجه الخصوص ، وسيلة الاتصال هذه. عندما نطلب منهم معلومات ، نحصل أولاً على مقطع فيديو. أما الإسلام فهو مثال بليغ في هذا الصدد. أصبحت مقاطع الفيديو التي تظهر اعترافات الانتحاريين وأنواع أخرى كثيرة من إنتاجات الفيديو التي تعكس عقلية الإسلام المتطرف مألوفة لدينا. ومن المعروف أن هذا الدين يحظر إنتاج صور لأشخاص أحياء ، لكنه لا يمنع استنساخهم ، أي استخدام الصور الموجودة بالفعل. لقد أصبح من المبتذل القول إن الإسلام ليس حديثًا ، ومع ذلك ، من الواضح أن هذا دين ما بعد الحداثة.
في هذا الصدد، أود أن أقول إن استخدام الفيديو كوسيلة رئيسية للتواصل من قبل الحركات الدينية المعاصرة هو أمر جوهري في الرسالة التي تنقلها. وأود أن أضيف أن هذا الأمر لا علاقة له بفهم المشاعر الدينية الكامنة وراء هذا الاستخدام. وهكذا تصبح الرسالة هنا وسيطا ، و رسالة دينية ذات بعد رمزي ورقمي.
تتميز الصور الرقمية بخصوصية إنشاءها ومضاعفتها وتوزيعها بشكل مجهول تقريبًا عبر الحقول المفتوحة التي تم إنشاؤها بواسطة وسائل الاتصال الحديثة. يصعب تحديد أصل هذه الرسائل إن لم يكن من المستحيل تحديدها ، كما هو الحال مع أصل الرسائل الإلهية والدينية.
علاوة على ذلك ، يبدو أن الرقمنة تضمن الاستنساخ الحرفي للنص أو الصورة بأمانة أكثر من أي تقنية أخرى معروفة. بالطبع ، ليست الصورة الرقمية نفسها مثل ملف صورة ، البيانات الرقمية ، التي تظل كما هي أثناء عمليات الاستنساخ والتوزيع. ومع ذلك ، فإن الملف ليس صورة ، لأنه غير مرئي. الصورة الرقمية هي تأثير لعرض الملف غير المرئي، والبيانات الرقمية غير المرئية. فقط أبطال الفيلم قادرون على رؤية ملفات الصور، والشفرة الرقمية على هذا النحو. من ناحية أخرى، لا يملك المشاهد العادي عصي سحرية تسمح له مثل الشخصية الرئيسية، بدخول الفضاء غير المرئي المخفي خلف الصورة الرقمية ويجد نفسه مباشرة في وجود البيانات الرقمية. ولا يتقن هذا المتفرج التقنية التي من شأنها أن تمنحه القدرة على نقل البيانات مباشرة إلى دماغه وإدراكها في وضع من المعاناة الخالصة التي يستحيل تصورها (في الواقع ، المعاناة الخالصة ، كما نعلم ، هي أقرب ما تكون إلى التجربة غير المرئية.) يجب تصور البيانات الرقمية ، لتصبح صورة يمكن رؤيتها. هنا ، يتم إعادة تفسير الانقسام الأبدي بين الروح والمادة على أنه انقسام بين الملف الرقمي وتصوره ، أو بين المعلومات "غير الملموسة" والصورة "المادية" ، والتي تتضمن نصًا مرئيًا. من الناحية اللاهوتية ، لنفترض أن الملف الرقمي يلعب دور ملاك ، دور الرسول غير المرئي الذي ينقل أمرًا إلهيًا. لكن الإنسان يبقى خارج هذه الرسالة وهذه الوصية ، وبالتالي يظل محكوم عليه بالتأمل في التأثيرات البصرية فقط. نحن هنا في حضور تغيير الانقسام بين الإلهي والإنسان من المجال الميتافيزيقي إلى المجال التقني ، وهو التحول الذي ، كما كان يؤكد مارتن هايدجر ، ممكن فقط بحكم حقيقة أن هذا الانقسام يعتبر تقنيًا ضمنيًا منذ البداية.
توسيعا لذلك ، لا يمكن ببساطة كشف الصورة الرقمية التي يمكن عرضها أو نسخها (كما في حالة الصورة التناظرية) بل يمكن فقط إنجازها أو تنفيذها. هنا، يمكن مقارنة الصورة بعمل موسيقي: لكن كما نعلم، فإن الصورة ليست "مطابقة" للقطعة الموسيقية ، إنها ليست موسيقى لأنها صامتة. من أجل سماع الموسيقى ، يجب تشغيل الصوت. يمكن للمرء أن يستنتج هنا أن الرقمنة تحول الفنون البصرية إلى فنون أداء. الآن ، لأداء أو تشغيل شيء ما يعني تفسيره ، وهو ما يؤدي إلى الخيانة ، أو التشويه. فأي أداء هو تفسير وأي تفسير هو تحويل. يصبح الوضع صعبًا بشكل خاص في حالة الأصل غير المرئي. عندما يكون الأصل مرئيًا ، يمكن مقارنته بنسخة ، ويمكن تصحيح هذه النسخة لتقليل تأثير التشويه. ولكن إذا كان الأصل غير مرئي ، فمن المستحيل إجراء مثل هذه المقارنة وأي تصور له علاقة غير مؤكدة بالأصل؛ نستطيع أن نقول حتى أن كل أداء أو تفسير يصبح هو نفسه أصليًا.
بالإضافة إلى ذلك ، تتغير تقنيات المعلومات اليوم باستمرار - الأجهزة والبرامج وما إلى ذلك. لهذا السبب وحده ، يتم تحويل الصورة في كل مرة تنظر إليها باستخدام تقنية جديدة أو مختلفة. نحن نفكر الآن في التكنولوجيا من منظور الأجيال: أجيال من أجهزة الكمبيوتر ، وأجيال من معدات التصوير الفوتوغرافي والفيديو. لكن من يقول الأجيال يقول صراعات الأجيال ، ومعارك أوديبية.
أي شخص يحاول نقل ملفات نصية أو صور قديمة إلى برامج جديدة يختبر قوة عقدة أوديب على التكنولوجيا الحالية: يتم تدمير البيانات ، وتبخرها إلى فراغ. الاستعارة البيولوجية تقول كل شيء: ليست الحياة فقط هي التي تبرز في هذه المسألة ، ولكن التكنولوجيا أيضًا ؛ أصبحت التكنولوجيا ، التي يُزعم أنها نقيض الطبيعة ، وسيلة استنساخ غير متطابقة. فرضية بنجامين المركزية التي صيغت في مقالته الشهيرة "العمل الفني في عصر التكاثر التقني" (1936) - وهي أن التكنولوجيا المتقدمة التي تضمن الهوية المادية بين الأصل والنسخة - غير موجودة. لم تتطابق مع ظهور التطورات التقنية اللاحقة. في الواقع سار التقدم التكنولوجي في الاتجاه المعاكس أي نحو تنويع الشروط التي يتم بموجبها إنتاج نسخة وتوزيعها ، وبالتالي تنويع الصور المرئية الناتجة. وحتى إن ضمنت التكنولوجيا ثبات التصورات المختلفة لنفس المعلومات فستظل تلك المعطيات غير متطابقة بسبب السياقات الاجتماعية المتغيرة التي نشأت فيها.
وبالتالي ، فإن فعل تصور البيانات الرقمية غير المرئية هو مماثل لظهور غير المرئي داخل تضاريس العالم المرئي (من الناحية الكتابية ، العلامات والمعجزات) التي تقوم عليها الطقوس الدينية. في هذا الصدد ، تعمل الصورة الرقمية كرمز بيزنطي ، كتمثيل مرئي للبيانات الرقمية غير المرئية. ويبدو أن الكود الرقمي يضمن هوية الصور المختلفة التي تمثلها. لا يتم تأسيس الهوية هنا في عالم الروح أو الجوهر أو المعنى ، ولكن في المجال المادي والتقني. هكذا يبدو أن الوعد بالتكرار الحرفي يكتسب أساسًا متينًا ؛ فالملف الرقمي ، بعد كل شيء ، من المفترض أن يكون شيئًا ماديًا وملموسًا أكثر من إله غير مرئي. ومع ذلك ، يظل الملف الرقمي غير مرئي ومخفي بشكل فعال. ما يعنيه هذا هو أن هويته تظل مسألة إيمان. في الواقع ، نحن قادرين على الاعتقاد بأن كل عمل من أعمال التصور لبيانات رقمية معينة يعادل الكشف عن نفس البيانات ، تمامًا كما نضطر إلى الاعتقاد بأن كل أداء لطقوس دينية معينة يتعلق بنفس الإله غير المرئي. وهذا يعني أن أي رأي حول ما هو متماثل وما هو مختلف ، أو ما هو أصلي وما هو نسخة ، هو فعل إيماني ، وتأثير قرار سيادي لا يمكن تبريره بالكامل من الناحية التجريبية. أو حتى منطقيا.
يستبدل الفيديو الرقمي الضمانات الروحية للخلود الذي من المفترض أنه ينتظرنا في الآخرة بالضمانات التقنية لتكرار أبدي محتمل في هذا العالم ، وهو التكرار الذي يصبح شكلاً من أشكال الخلود بسبب قدرته على قطع التدفق الزمني للتاريخ. هذا المنظور الجديد للخلود المادي والمضمون تقنيًا هو ما تقدمه الحركات الدينية الجديدة لأتباعها ، وهو منظور يتجاوز الشكوك الميتافيزيقية لماضيهم اللاهوتي. من خلال تكرار الأفعال البشرية ، تحقق العمليتان - الطقوس والفيديو - وعد نيتشه بخلود جديد: العودة الأبدية للذات عينها. في كل الأحوال ، يظل هذا الضمان التقني مسألة اعتقاد ودائمًا ما يكون قرارًا سياديًا. إن التعرف على صورتين متميزتين على أنهما نسخ من نفس الصورة أو تصورات لنفس الملف الرقمي يعود إلى تقدير الخلود على حساب الأصالة. إن التعرف عليها على أنها مختلفة يعود إلى تفضيل الأصالة في الوقت المناسب على إمكانية الخلود فالقراران لهما سيادة بالضرورة ، وهما أيضًا أفعال إيمانية.